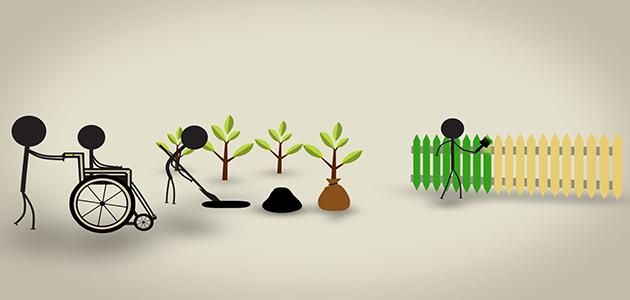إذا كان هذا موقف المشركين من كتاب الله تعالى في عهد النبوة، فلا عجب أن يسعى على طريقهم كل ضال، يتلمس طريقا يسلك من خلاله إلى إثارة الشبهات، وإشعال الفتن، ولا تظنن أن الله غافل عن صنيعه…
د. محمود مهدي محمود* (خاص لموقع الباحث عن الحقيقة)
خلق الله الإنسان، وجعله خليفة له، وأمره بعبادته وطاعته، وأرسل له الرسل مبشرين ومنذرين وهادين، وأظهر الله على أيديهم معجزات يدللون بها على صحة دعواهم وصدق ابتعاثهم، وكانت هذه المعجزات من لدن نوح إلى عيسى عليهما السلام معجزات حسية خارقة للعادة، كسفينة نوح، ونار إبراهيم، وعصا موسى، وإبراء المرضى وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليهم جميعا السلام.
خاتم الأنبياء
والعلة في تأييد هؤلاء الرسل بالمعجزات الحسية أن أزمنة وأمكنة دعوتهم محدودة، وأن كل نبي سيعقبه نبي آخر بدعوة أخرى يحتاج فيها إلى معجزة جديدة تؤكد دعوته، وكثيرا ما كانت المعجزات من جنس ما برع فيه القوم المتحدِّين بالمعجزة، حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان خاتما للأنبياء، فلا نبي بعده، وجعل الدين الذي دعا إليه خاتم الأديان، فشاءت إرادة الله أن تكون معجزته باقية خالدة صحيحة، لا يتطرق إليها شك، ولا يعتورها ريب، وتظل حاملة لروح التحدي للبشر حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
فكان القرآن الكريم المعجزة التي تحدى بها النبي أساطين البلاغة، وفحول الفصاحة أن يأتوا بمثله فعجزوا، قال تعالى:” قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا“(الإسراء:88)، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا: “أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ“(هود:13)، فلما لم يقدروا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، لم يحدد القرآن اسمها ولا عدد آياتها، والتنكير في قوله “بِسُورَةٍ” يفيد العموم، فالتحدي قائم بكل السور، طويلها وقصيرها، يقول جل جلاله: “وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ” (البقرة:23)[1].
ولما خاب سعيهم، وضل طريقهم، وعجزت عقولهم، تحولوا إلى طرق أخرى يحاولون من خلالها الطعن في هذه المعجزة، ولم يُجْدِ قولهم في القرآن الكريم إن محمدا افتراه، “إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ” (الفرقان:3)، وقولهم: “بل قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ” (الأنبياء:5)، وغير ذلك مما سرده القرآن الكريم، لذلك أُمر النبي عليه السلام أن يقارعهم الحجة بأعلى منها، وكانت كل دعاواهم الباطلة مردودا عليها بالحجة العقلي[2].
إحجام المشركين عن الطعن في بلاغة القرآن وصحة نظمه:
وعلى الرغم مما فكر فيه المشركون من طرق للنيل من كتاب الله المنزه، إلا أنهم لم يتطرقوا لبلاغته وفصاحته، وحسن نظمه، وروعة بيانه، ودقة ترتيبه، وجريان آياته على منهج العرب في استخدام اللغة، بل إن أحد كبرائهم وحكمائهم، وهو الوليد بن المغيرة لم يستطع بعدما سمع بعض آيات من النبي من سورة غافر أن يكبح جماح إعجابه فقال كلمته الشهيرة: “والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس، ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإنه عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه” فها هو بقوله هذا يحطم عدة حواجز صنعها المشركون، ليحولوا بها بين القرآن والمسلمين.
الطاعنون في كتاب الله تعالى لا يتوقفون:

لا عجب أن نجد بيننا من يتلمس طرقا يسلك من خلالها إلى إثارة الشبهات، وإشعال الفتن بالطعن في كتاب الله تعالى
وإذا كان هذا موقف المشركين من القرآن في عهد النبوة، فلا عجب أن يسعى على طريقهم كل ضال، يتلمس طريقا يسلك من خلاله إلى إثارة الشبهات، وإشعال الفتن، ولا تظنن أن الله غافل عن صنيعه، فقد أخبرنا ربنا عن مسلك من زاغت قلوبهم، وعميت بصائرهم، فأخذوا يتتبعون متشابهات القرآن بغية فتنة الناس وتشكيكهم، فقال سبحانه: “هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ” (آل عمران:7)[3].
من شبهاتهم حول القرآن:
لكننا اليوم ابتلينا بنفر منا يتكلمون بلسان القرآن ولا يفقهون مراميه، ويدعون دراسته وفهمه ولا يحسنون إدراك غاياته ومقاصده، فظنوا أنهم إن وجهوا طعونا نحو كتاب الله العظيم نالوا منه، وقد ينجحون مع غير متخصص ينبهر بسحر كلماتهم، أو متشكك غير مطلع ينتظر من يؤكد شكوكه، لكن ها هي الشمس تسفر عن وجه صبوح مشرق، فلا يمر وقت طويل حتى نسمع عن عن عالم فذ في مجال من مجالات العلوم وقد هداه الله للإسلام بسبب إعجاز علمي قرآني، أو باحث عن الحقيقة هدته آيات القرآن لاعتناق الدين.
وقد رد الدكتور عبد المجيد صبح على من زعم وجود تكرار في القرآن الكريم ردا رائعا أوجزه في ما يلي:
* إن القرآن حين يذكر قصة كقصة موسى لا يكررها، وإنما يذكر منها في كل موطن ما يناسب سياق الموضوع.
* القرآن كتاب هداية للناس، يرسم لهم طريقهم الصحيح في شتى مناحي الحياة، وهذا يتطلب التطرق للموضوع الواحد بطرق عدة تتراوح بين اللين والشدة، والترغيب والترهيب، والتلميح والتصريح، والبسط والإيجاز، وضرب الأمثال وتأييد المقال[4].
ويستغل المغرضون أو المتشككون عدم دراية القارئ أو المتلقي بقواعد اللغة، ويأتون بآيات في ظاهرها تعارض مع القواعد النحوية الشائعة[5]، وهنا أود أن أسأل سؤالا: من كان أولى بإثارة تلك الشبهات اللغوية؟ المشركون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم المشككون اليوم؟
وأجيب بإيجاز: أيهما أسبق وجودا القرآن الكريم أم كتب القواعد اللغوية؟ بالتأكيد القرآن أسبق، وعلى نهج أساليبه وضعت الكثير من القواعد العربية، فلو أن هناك خللا لكان في القواعد التابعة لا في القرآن المتبوع.
وهناك أمر آخر: لو كان في كتاب اللهخلل لغوي واحد ما سكت عنه المشركون، وهم أهل الفصاحة وأرباب اللغة، ولهاجموا به القرآن، وكذبوا به الرسول، فعدم فعلهم يؤكد صحة القرآن اللغوي وسلامته، وهذا يؤكد أن المغرضين من مثيري الشبهات يستغلون انفصام هذه الأجيال عن لغتها، واضمحلال ثقافتها، فيبثون فيهم الريب.
آفة مدعي العلم الشرعي:

من مصائب هذا الزمان تجرؤ بعض المنتسبين للإسلام، على تفسير كتاب الله بغير ما ليس من معانيه ولا من مقاصده، يشترون بذلك عرض الدنيا، ويفسحون المجال لأعداء الإسلام للطعن فيه
ولعل من مصائب هذا الزمان تجرؤ بعض المنتسبين للإسلام، المرتدين لزي علمائه، على تفسير كتاب الله بغير ما ليس من معانيه ولا من مقاصده، يشترون بذلك عرض الدنيا، ويفسحون المجال لأعداء الإسلام للطعن فيه، وهؤلاء تُنصب لهم الكاميرات، وتُفتح لهم الميكروفونات، وتفرد لهم الصفحات، ليشوهوا عمدا أو جهلا الصورة الناصعة لكتاب الله العزيز، وسأسوق نصا سمعته من رجل أقل ما يقال عنه أنه لا يفهم نصا، ولا يعي تفسيرا، ولا يذكر خبرا: جلس ذاك المعمم يداعب عمامته أمام الكاميرا، وفجر قنبلته فقال معجبا بنفسه، لقد كنا في كارثة حين كنا نظن أن القرآن يأمر بقطع يد السارق، وأنه لا قطع حقيقي لليد في كتاب الله، وقال بالنص: القرآن قال: “فاقطعوا أيديهما” ولم يقل يديهما، على الرغم من أنهما اثنان، وعرَّف القطع بأنه ليس المقصود به البتر، وأن المراد القطع المعنوي لا الحسي، وشرح ذلك بأن القطع في الآية يراد به الحيلولة بين الإنسان والسرقة بتوفير رزق له يكفيه فلا يسرق، فتكون يده قد قطعت عن السرقة.
وللرد على دعي التفسير هذا أقول له: ليتك قرأت الآية كاملة ففيها الرد الشافي، وإذا كنت لا تخشى قراءتها لأنها ستفضح عدم إلمامك بقواعد لغتك فسأقرؤها لك، يقول ربنا سبحانه وتعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” (المائدة:39،38).
القطع في الآية جاء على معناه الحقيقي وهو البتر. إذا كان مفهوم القطع معنويا كما بينه لجاءت بقية الآية تحث على الرحمة بهما والشفقة عليهما والمغفرة لهما، لكن الآية جاءت تحمل سيلا من التقريع والتعنيف والتحقير من شأن مرتكب هذه الفعلة، فأكدت على أن القطع جزاء حتمي لهما، وتنكيل بهما لاقترافهما هذه الجريمة، وكلمة “نَكَالًا” تدل على أن القطع عقوبة من الله على لصوصيتهما واستلابهما لأموال الناس بلا حق، وتختم الآية خاتمة شديدة تناسب العقاب “وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” أي والله عزيز في انتقامه من الخارجين على أحكامه، حكيم في حكمه فيهم وقضائه عليهم [6].
تفيهق الرجل وتساءل عن سر التعبير بقوله “أَيْدِيَهُمَا” ولم تقل الآية “يديهما“، ولو كان على دراية متواضعة باللغة، وبأساليب كتاب الله ما تساءل؛ فكل ما في بدن الإنسان منه عضو واحد تجيز اللغة في تثنيته وجهان تثنيته بلفظ المثنى، وتثنيته بلفظ الجمع[7].
وأيضا سُبق حد السرقة بحد الحرابة، وبين الحدين صلة، فالحرابة سرقة كبرى تتسم بالمجاهرة والاقتران بالترهيب والتخويف والإيذاء والقتل أحيانا، فكانت عقوبتها أشد، أما السرقة فهي جريمة صغرى، لأنها تعتمد على استلاب المال خفية، فكانت عقوبتها أقل من الحرابة.
الشروط الواجب توافرها في المفسر:

على من يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى أن يكون ملما بعلوم اللغة نحوا وصرفا واشتقاقا وبلاغة، مطلعا على أشعار العرب وخطبهم وأدبهم. وأن يكون عالما بالقراءات القرآنية، والفقه وأصوله، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وبالأحاديث النبوية الشريفة
إن هذا يدعونا لبيان الشروط الواجب توفرها فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله تعالى، وقد قال فيها قدامى العلماء كثيرا، وأضاف المحدثون لها شروطا أخرى، ومن هذه الشروط:
أن يكون ملما بعلوم اللغة نحوا وصرفا واشتقاقا وبلاغة، مطلعا على أشعار العرب وخطبهم وأدبهم. وأن يكون عالما بالقراءات القرآنية، والفقه وأصوله، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وبالأحاديث النبوية الشريفة، ودرجاتها، ودرجات رواتها، الصحيح منها والموضوع.
وقد أضاف المحدثون للمفسر شروطا تناسب ظروف ومقتضيات هذه العصر، وهي بإيجاز: أن يكون ملما بعلوم العصر، ذا معرفة بالأفكار السائدة، واعيا بمشكلات العصر وأزماته.
فهم الأساليب اللغوية ومساهمته في رفض دعاوى المشككين:
إن اللغة ليست مجرد كلمات منطوقة، ولا جملا مستعملة في التعبير عن الخواطر ومتطلبات الحياة، ولا وسيلة للتفاهم المجرد الخالي من التأثير، بل هي كالكائن الحي، تحتاج إلى فهم دلالات مفرداتها، ومعرفة حقيقي ألفاظها ومجازيه، وإدراك الفروق بين مترادفاتها، فكم من كلمات مترادفة لا يصلح وضعها موضع الأخرى، وإلا فسد المعنى، من ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- كلمتا “العلم والمعرفة” فهما وإن اشتركتا في بعض الدلالة، إلا أن كلا منهما تظل ذا ميزة خاصة لا توجد في مرادفتها[8].
إن هذه المسالك اللغوية الدقيقة جعلت كثيرا من علماء الأمة الفصحاء الفقهاء يتهيبون الإقدام على تفسير كتاب الله، خشية أن تزل قدمهم، فيحاسبهم ربهم، وقد كان الأصمعي وهو إمام في اللغة لا يفسر شيئا من غريب القرآن، وحكي أنه سئل عن قوله تعالى “قد شغفها حبا” فسكت وقال: هذا في القرآن.
تعليم العربية حصن أمان:

إن كثيرا من المؤسسات التربوية والتعليمية توصي بعدم تعليم الأطفال لغة أجنبية في مرحلة الروضة، وفي الصفوف الأولى من التعليم الأساسي، حتى لا يؤثر ذلك على اللغة الأم
ومن أفدح ما ابتلي به المسلمون هجرهم للغتهم، التي هي وسيلتهم لقراءة كتاب الله تعالى وحفظه، وتدبره وفهم معانيه ومراميه، والاطلاع بها على ثقافة دينهم، ونتاج علمائهم، وبها يتمكنون من التمييز بين الغث والثمين، والصواب والخطأ، والنافع والضار، فيتحصنون بهذه المعارف ضد هجمات المغرضين، لكننا طوعا آثرنا اللسان الأعجمي، واعتبرنا تعلمه شرفا ورفعة وحسبا، وقدمنا أولادنا لمدارس اللغات تحبب إليهم لغة غريبة عن لغة دينهم وثقافتهم وبيئتهم، فما ازدادوا بها إلا غربة في وطنهم، وعزلة بين أهلهم، وضعفا أمام عدوهم، فسهل اختراقهم، والعبث بعقولهم، وصعب عليهم التواصل مع من يمكنه تصويب أخطائهم، وعلاج آفاتهم، وهذا – لعمري– جناية يجنيها بعض الآباء على فلذات أكبادهم.
إن كثيرا من المؤسسات التربوية والتعليمية توصي بعدم تعليم الأطفال لغة أجنبية في مرحلة الروضة، وفي الصفوف الأولى من التعليم الأساسي، حتى لا يؤثر ذلك على اللغة الأم، ويصرف الطفل عنها إلى غيرها، خاصة وأن اللغة العربية تحتاج إلى تعلم العديد من مهارات النطق والكتابة التي لا تحتاج لمزاحمة مهارات لغة أخرى لها.
إن أبناءنا الذين تربوا على عدم العناية بلغتهم أكثرهم عرضة للشك، وهدفا للمغرضين، يبثون فيهم سمومهم منذ صغرهم فيشبون وهم إلى البعد عن الدين بل وإلى الإلحاد أقرب، فلننتبه ولنعن بأولادنا، ولنحافظ على لغتنا الكريمة.. لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم.
الهامش:
[1] – إعجاز القرآن للباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، مصر، دار المعارف، ط5، 1997، ص:6
[2] – ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، مصر، القاهرة، دار المعارف، ط3، 1976، ص:28.
[3] – أورد ابن كثير وجوها عديدة في تفسير هذه الآية الشريفة أختار منها رأي محمد بن إسحاق بن يسار-رحمه الله- حيث قال: “مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ” فيهن حجة الرب، وعصمة العباد، ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. “وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ” هن المتشابهات في الصدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد، كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل، ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى : “فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ” أي: خروج عن الحق إلى الباطل “فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ” أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم من أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال: “ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ” أي : الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم .
[4] – الرد الجميل على المشككين في الإسلام، عبد المجيد صبح، دار المنارة، مصر، المنصورة، 2003، ط3، ص: 180
[5] – مواضع بعض الشبهات اللغوية في القرآن:
* قالوا: جاء في القرآن في قصة يوسف قوله ” فأكله الذئب ” ولو قيل فافترسه لكان أبلغ. وهم لا يدركون الفرق اللغوي بين الافتراس والأكل، فالافتراس في فعل كل سبع القتل فقط، ولو أنهم قالوا: فافترسه الذئب لطولبوا بجثته، لكنهم قالوا: “فأكله الذئب” لأن الأكل هنا قصد به أنه التهمه وابتلعه ولم يبق منه شيئا حتى لا يطالبوا بما تبقى به منه.
* ومما يطعن به هؤلاء في نظم القرآن من الناحية اللغوية قولهم: أن القرآن نصب الفاعل الذي حقه الرفع في قوله تعالى : “وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين” فطعنهم موجه إلى قوله ” لا ينال عهدي الظالمين ” فهم يظنون أن كلمة ” الظالمين ” فاعل حقه الرفع بالواو؛ لأنه جمع مذكر سالم، وجاء به القرآن منصوبا.
والجواب: هناك قاعدة يعرفها علماء النحو تقول: الإعراب فرع المعنى، أي إذا فهمت المراد من الأسلوب الذي بين يديك سهل عليك إعرابه، والمعنى المراد من قوله “لا ينال عهدي الظالمين” لا ينفع عهدي الظالمين، وعليه نجد أن “ينال” فعل مضارع مرفوع، و”عهدي” فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، و”الظالمين” مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء.
وحين تحدث العلماء العالمين بالعربية عن خصائص الفعل “نال” قالوا: إن فاعل هذا الفعل يجوز أن يكون مفعولا، ومفعوله يجوز أن يكون فاعلا على التبادل بينهما؛ والسبب في ذلك أن ما نالك فقد نلته أنت.
وها هو الفعل قد وليه المفعول في قوله تعالى “لن ينال اللهَ لحومُها ولا دماؤها” (فلفظ الجلالة) مفعول، والفاعل (لحومها). والمعنى: لن يصل اللهَ لحومُها ولا دماؤُها.
* ومن شبههم في قوله تعالى: “هذان خصمان اختصموا في ربهم” حيث قالوا: كيف يخبر عن المثنى بجمع!، وكان مقتضي السياق – من وجهة نظرهم – أن يقال “هذا خصمان اختصما في ربهما” .
وجلي أن ما أثاروه ناجم عن جهلهم باللغة وطرقها الفصيحة في التعبير عن المعاني، وهذا مما يحسب للقرآن لا عليه، فهناك طريق تعبيري يراعي اللفظ على المعنى، وهناك طريق تعبيري يراعي المعنى على اللفظ، والمثنى نوعان: مثنى حقيقي، يجب تثنية خبره وصفته والضمير العائد عليه، مثل المحمدان كاتبان مجدان وهما كريمان . فالمثنى الواحد منه مفرد، ومنه في القرآن الكريم “قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ” فالضمير المتصل بحرف الجر والعائد على الرجلين جاء بألف الاثنين.
والنوع الثاني: هو المثنى اللفظي، مثل دخل الملعب فريقان وشجعهما جمهوران، فكلمة “فريقان” مثنى، مفردها “فريق” والفريق ليس فردا واحدا، وكذا “جمهوران” مفردها “جمهور” والجمهور ليس فردا واحدا، فهذا يطلق عليه المثنى لفظا والجمع معنى، وهذا النوع عند الحديث عنه بالوصف أو استئناف الكلام يجوز فيه أمران: مراعاة اللفظ فيثني، أو مراعان المعنى فيجمع، ومنه في القرآن الكريم ” هذان خصمان اختصموا في ربهم ” فخصمان مثنى مفرده “خصم”، و”خصم” اسم جنس، واسم الجنس يندرج تحته أفراد كثيرون، فتحدث القرآن عن الخصمين بأسلوب الجمع مراعاة للمعنى، ومثله ” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا “.
[6] – تفسير البحر المحيط : 4/417.
[7] – لما كان ليس للمرء إلا يمين واحدة فقد جاز تثنيتها بلفظ الجمع، ومثله في القرآن الكريم أيضا “إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما” فالحديث عن اثنتين من زوجات النبي، وليس لهما إلا قلبان، لكن جاز التعبير عن المثنى هنا أيضا بلفظ الجمع، لأنه من أعضاء البدن الواحدة .
ومن الناحية الإعرابية يرى الكوفيون أن جملة “فاقطعوا أيديهما” هي الخبر، وقد دخلت عليها الفاء، لأنه لم يُرِدْ سارقا بعينه، وإنما أريد: كل من سرق من الرجال والنساء فاقطعوا أيديهما، وهذا يتضمن معنى الشرط والجزاء فدخلت الفاء في خبر المبتدأ.
[8] – تقول: عرفت الشيء وعلمته، إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل، والفعل “عرفت” يقتضي مفعولا واحدا، كقولنا: عرفت خالدا، و”علمت” يقتضي مفعولين، كقولنا: علمت خالدا كريما، والمعرفة صارت تستعمل في توحيد الله وإثبات ذاته، تقول عرفت الله، ولا تقول : علمت الله، إلا إذا أضفت إليه صفة من صفاته، فتقول مثلا : علمت الله غفورا رحيما، ويمكن إدراك ذلك من الوقوف على مضاد الكلمتين، فالعلم ضده الجهل، والمعرفة ضدها النكرة .
_______________________________________
* كبير باحثين بالأزهر الشريف و عضو لجنة تحقيق التراث العلمي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وخبير تحقيق النصوص الصيدلانية.
[ica_orginalurl]