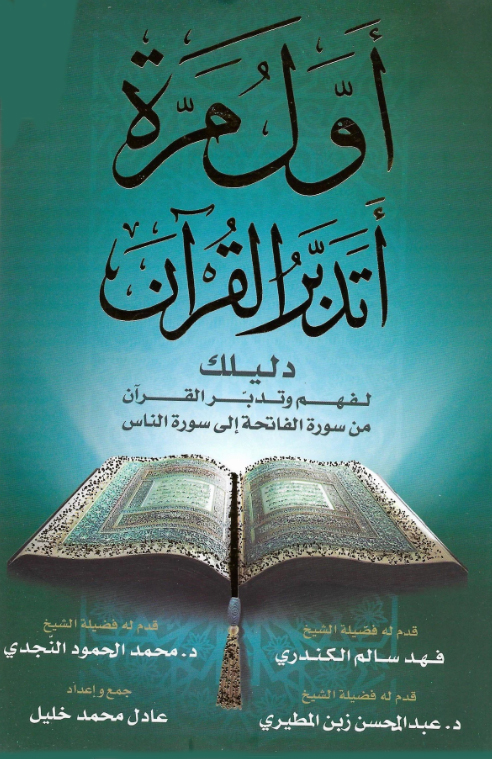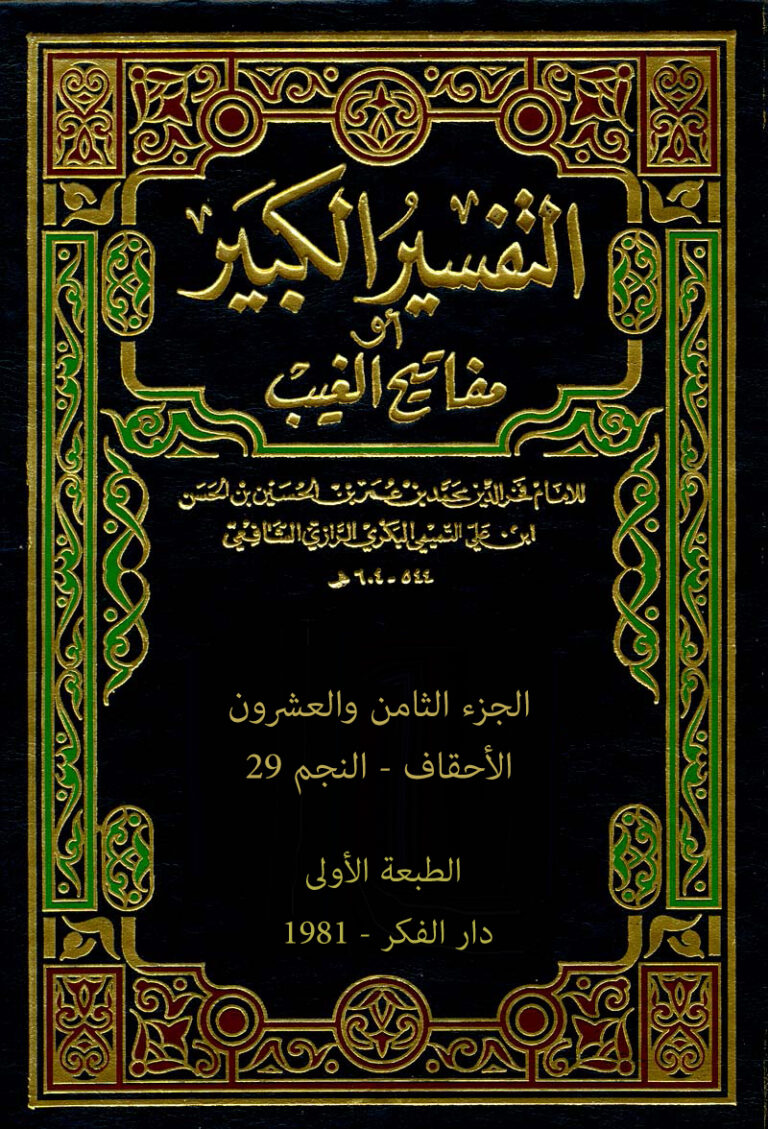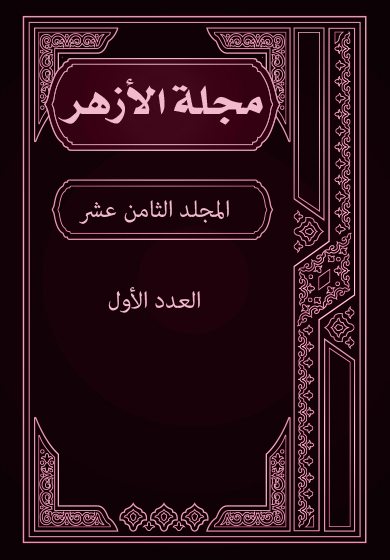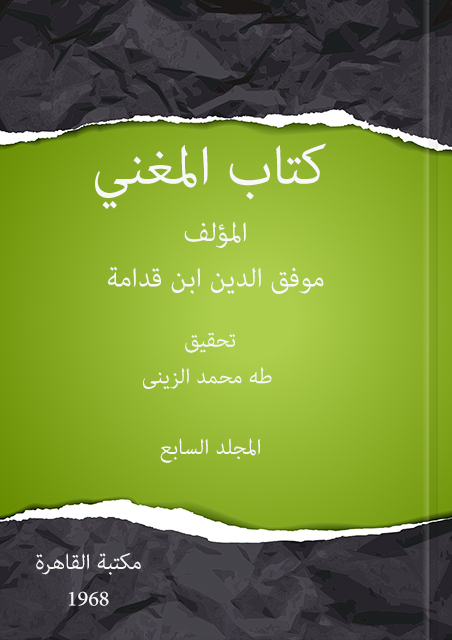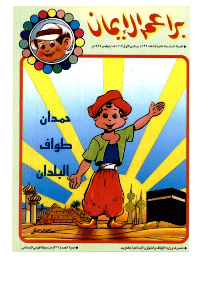القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق المبين، والطريق المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين، وإلا كان يكون قوله الحق: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60] مقصورًا على الضعفاء، وجميع الخطابات كذلك.
وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكليم: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ} [الشعراء: 63]، وقد كان قادرًا على فلق البحر دون ضرب عصا، وكذلك مريم عليها السلام: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25]، وقد كان قادرًا على سقوط الرطب دون هز ولا تعب، ومع هذا كله فلا ننكر أن يكون رجل يلطف به ويعان، أو تجاب دعوته، أو يكرم بكرامة في خاصة نفسه أو لأجل غيره، ولا تهد لذلك القواعد الكلية والأمور الجميلة؛ هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [الذاريات: 22]، فإنا نقول: صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم (1).
قوله: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} أن يكون إثمار الجذع اليابس رطبًا ببركة تحريكها إياه، وتلك كرامة أخرى لها، ولتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبًا، وفي ذلك كرامة لها بقوة يقينها بمرتبتها.
والباء في بجذع النخلة لتوكيد لصوق الفعل بمفعوله مثل: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] وقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
وضمن وهزي معنى قربي أو أدني، فعدي بـ (إلى)، أي حركي جذع النخلة وقربيه يدن إليك ويلن بعد اليبس ويسقط عليك رطبا (2).
هناك لمسات بيانية من هذه الآيات، ابتداءً من كلمة {تُسَاقِطَ}، إذ جاءت اللفظة تساقط بدل تسقط؛ لأن تساقط تفيد تتابع السقوط، وتسقط مرة واحدة، فربنا أراد أن يفهمها أن الثمر لا ينقطع بل يبقى مستمرًا، أما {فَكُلِي وَاشْرَبِي}، نلاحظ أن القرآن حينما يذكر الأكل والشرب يقدم الأكل على الشرب حتى في نعيم الجنة {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: 24]، والسبب أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب.
وسنة الأخذ بالأسباب مقررة في كون الله تعالى بصورةٍ واضحةٍ، فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته، وأودع فيه من القوانين، والسنن ما يضمن استقراره، واستمراره، وجعل المسببات مرتبطةً بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فجعل عرشه سبحانه محمولًا بالملائكة، وأرسى الأرض بالجبال، وأنبت الزرع بالماء… وغير ذلك.
تطابق العلم الحديث مع القرآن الكريم:
1- فالعلماء وجدوا أن الحزن يضر بالجنين، ولذلك أمر الله تعالى سيدتنا مريم ألا تحزن فقال لها: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24].
2- والعلماء يؤكدون في دراساتهم على أن الحركة الخفيفة والتمارين الرياضية مفيدة للأم وللجنين، وهذا ما أمر الله به سيدتنا مريم فقال لها: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ}، فلم يأمرها بالقعود أو عدم الحركة، بل أن تمارس بعض النشاطات البدنية.
3- والعلماء ينصحون الأم الحامل بتناول حبات من الرطب، وينصحونها بالتفاؤل والفرح، والله تعالى أمر سيدتنا مريم أن تأكل الرطب وأن تتفاءل وتفرح وتقرَّ عينها فقال: {تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا (26)} [مريم: 25-26].
ولو شاء الله لجعل كل هذه الأشياء وغيرها –بقدرته المطلقة– غير محتاجةٍ إلى سبب، ولكن هكذا اقتضت مشيئة الله تعالى، وحكمته؛ التي يريد أن يوجِّه خلقه إلى ضرورة مراعاة هذه السنة؛ ليستقيم سير الحياة على النَّحو الَّذي يريده سبحانه، وإذا كانت سنَّة الأخذ بالأسباب مبرزةً في كون الله تعالى بصورةٍ واضحة، فإنَّها كذلك مقررة في كتاب الله تعالى، ولقد وجَّه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السنة في كل شؤونهم، الدُّنيوية، والأخروية على السَّواء، قال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [التوبة: 105]، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15].
ولقد أخبرنا القرآن الكريم: أن الله تعالى طلب من السيدة مريم، أن تباشر الأسباب وهي في أشد حالات ضعفها، قال تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم: 25].
وهكذا يؤكد الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور، والأحوال، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان أوعى الناس بهذه السنة الربانية، فكان –وهو يؤسس لبناء الدولة الإسلامية– يأخذ بكل ما في وسعه من أسباب، ولا يترك شيئًا يسير جزافًا، ولقد لمسنا ذلك فيما مضى، وسنلمس ذلك فيما بقي بإذن الله تعالى.
وكان صلى الله عليه وسلم يوجِّه أصحابه دائمًا إلى مراعاة هذه السنة الربانية، في أمورهم الدنيوية، والأخروية على السواء، وقد كان في حسِّ الأمة الإسلامية، في صدرها الزَّاهر: أنَّ إيمانها بقدرة الله تعالى المطلقة، وقضائه، وقدره لا يتعارض مع اتِّخاذ الأسباب، فلقد كانوا يدركون: أنَّ لله تعالى سننًا في هذا الكون، وفي حياة البشر، غيرُ قابلةٍ للتَّغيير، ومع أنَّ لله تعالى سننًا خارقةً تملك أن تصنع كلَّ شيءٍ، ولا يعجزها شيءٌ إلا أنَّ الله تعالى –جلَّت قدرته– قد قضى بأن تكون سنَّته الجارية ثابتةً في الحياة الدُّنيا، وأن تكون سنَّته الخارقة استثناءً لها، وكلتاهما معلَّقةٌ بمشيئة الله، لذلك كان في حسِّهم أنَّه لا بدَّ لهم من مجاراة السُّنن الجارية؛ إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيَّنة في واقع حياتهم؛ أي: أنَّه لا بد من اتِّخاذ الأسباب المؤدِّية إلى النتائج، بحسب تلك السُّنن الجارية.
وإنَّ تخلُّف المسلمين اليوم عن رَكْبِ الزعامة العالمية لم يكن ظلمًا نزل بهم؛ بل كان العدل الإلهيُّ مع قومٍ نَسُوا رسالتهم، وحطُّوا من مكانتها، وشابوا معدنها بركامٍ هائلٍ من الأهواء، والأوهام في مجال العلم والعمل على السواء، وأهملوا السنن الربانية، وظنُّوا: أن التمكين قد يكون بالأماني، والأحلام، ولكن هيهات! {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} [آل عمران: 182] وربما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الذين عصوه، فما بال الكافرين الذين جحدوه سبحانه بالمرة، ومع ذلك فإنهم ممكنون في الأرض –من الناحية المادية– غاية التمكين؟!
إن هؤلاء الكفار، لم يبلغوا ما بلغوه لأنهم أقرب إلى الله، أو أرضى له، ولم يبلغوا ما بلغوا بسحرٍ أو بمعجزةٍ، أو لأنهم خلق آخر متميز، ولم يقيموا الصِّناعات، أو يجوبوا البحار، أو يخترقوا أجواء الفضاء؛ لأن عقيدتهم حق، أو لأن فكرهم سليم، إنهم بلغوا بذلك؛ لأن السبيل إلى هذا التقدم درب مفتوح لجميع خلق الله، مؤمنهم، وكافرهم، برِّهم، وفاجرهم، قال تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ} [هود: 15].
إنَّ الله سبحانه وتعالى جعل التمكين في الحياة يمضي بالجهد البشري، وبالطاقة البشرية، على سُننٍ ربانية ثابتة، وقوانين لا تتبدل، ولا تتحول؛ فمن يقدم الجهد الصادق، ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده، وبذله، وعلى قدر سعيه، وعطائه.
إنها السنة التي أرادها الله في هذه الحياة، إنها مشيئته، وسنته، وإرادته صحيح: أن هذا التقدم كله لا يفتح للكافرين أبواب الجنة، ولا يغني عنهم شيئًا، ولكن التقصير من جانب المسلم إثمٌ يحاسب عليه.
التَّوكُّل على الله والأخذ بالأسباب:
التَّوكُّل على الله تعالى لا يمنع من الأخذ بالأسباب، فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله، وطاعته فيما يأمر به من اتِّخاذها، ولكنَّه لا يجعل الأسباب هي الَّتي تنشئ النَّتائج، فيتوكَّل عليها.
إنَّ الذي ينشئ النَّتائج –كما ينشئ الأسباب– هو قدر الله، ولا علاقة بين السَّبب والنَّتيجة في شعور المؤمن.. اتخاذ السبب عبادة بالطاعة، وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السَّبب، لا يقدر عليه إلا الله، وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها، وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاعته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائها.
ولقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى، كما نبه عليه الصلاة والسلام على عدم تعارضهما.
يروي أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: أن رجلًا وقف بناقته على باب المسجد، وهم بالدخول، فقال: يا رسول الله! أرسلُ راحلتي، وأتوكل؟؛ وكأنه كان يفهم أن الأخذ بالأسباب ينافي التَّوكُّل على الله تعالى، فوجَّهه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمرٌ مطلوبٌ، ولا ينافي بحالٍ من الأحوال التَّوكُّل على الله تعالى، ما صدقت النِّيَّة في الأخذ بالأسباب، فقال له صلى الله عليه وسلم: «بل قيِّدها وتوكَّل» (3).
وهذا الحديث من الأحاديث التي تبين: أنه لا تعارض بين التوكل، والأخذ بالأسباب بشرط عدم الاعتقـاد في الأسباب، والاعتماد عليها، ونسيـان التوكل على الله، وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنكم توكَّلتم على الله حـقَّ توكُّلـه؛ لرزقكم كما يرزق الطَّير، تغدو خِماصًا، وتروح بِطانًا» (4).
وفي هذا الحديث الشريف حث على التوكل، مع الإشارة إلى أهمية الأخذ بالأسباب؛ حيث أثبت الغدو والرواح للطير مع ضمان الله تعالى الرزق لها.
ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضية، في النقاط التالية:
1- يقرر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب، ذلك؛ لأن تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيل للشرع، ولمصالح الدنيا.
2- الاعتماد على الأخذ بالأسباب وحدها، مع ترك التوكل على الله، شركٌ
3- يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتوحيد، مع الاعتقاد بأن أمر الأسباب كلها بيد الله.
4- المطلوب من المسلم إذًا، هو اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى.
ولا بد للأمة الإسلامية أن تدرك أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى التمكين أمر لا محيص عنه، وذلك بتقرير الله تعالى حسب سنته التي لا تتخلف، ومن رحمة الله تعالى: أنه لم يطلب من المسلمين فوق ما يستطيعونه من الأسباب، ولم يطلب منهم أن يُعِدُّوا العُدة التي تكافئ تجهيز الخصم، ولكنه سبحانه قال: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخرينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 60].
إن النداء اليوم موجهٌ لجماهير الأمة الإسلامية، بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن، والغثاء، إلى مرحلة القوة، والبناء، وأن يودعوا الأحلام، والأمنيات، وينهضوا للأخذ بكل الأسباب؛ التي تعينهم على إقامة دولة الإسلام، وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين (5).
لقد أمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة، وفترات عسيرة، وكانت تخرج منها بالتفكير المستنير، والنظرة الثاقبة، والتصور الصحيح، فتبحث في الأسباب والمسببات، وتنظر في العواقب والمقدمات، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب، وتلج البيوت من الأبواب، فتجتاز -بأمر الله- تلك الأزمات، وتخرج من تلك النكبات، فتعود لها عزتها، ويرجع لها سالف مجدها، هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها الزاهية.
أما في هذه العصور المتأخرة التي غشت فيها غواشي الجهل، وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتغريب، وشاعت فيها البدع والضلالات، فقد اختلط هذا الأمر على كثير من المسلمين، فجعلوا من الإيمان بالقضاء والقدر تكأة للإخلاد في الأرض، ومسوغًا لترك الحزم والجد والتفكير في معالي الأمور، وسبل العزة والفلاح، فآثروا ركوب السهل الوطيء الوبيء، على ركوب الصعب الأشق المريء.
فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر، وأن الله هو الفعال لما يريد، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، فلتمض إرادته، ولتكن مشيئته، وليجر قضاءه وقدره، فلا حول لنا ولا طول، ولا يد لنا في ذلك كله.
هكذا بكل يسر وسهولة، استسلام للأقدار دون منازعة لها في فعل الأسباب المشروعة والمباحة.
فلا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر، ولا جهاد لأعداء الله، ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل، ولا محاربة للأفكار الهدامة والمبادئ المضللة، كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك.
والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى، وضلالة عظمى، أدت بالأمة إلى هوة سحيقة من التخلف والانحطاط، وسببت لها تسلط الأعداء، وجرت عليها ويلات إثر ويلات.
وإلا فالأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، بل إنه من تمامه، فالله عز وجل أراد بنا أشياء، وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به، فقد أراد منا حمل الدعوة إلى الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا، وأراد منا قتالهم وإن كان يعلم أننا سُنهزم أمامهم، وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف، وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيننا وإن كان يعلم أن بأسنا سيكون بيننا شديدًا وهكذا.
فالخلط بين ما أُريد بنا وما أريد منا هو الذي يُلبس الأمر، ويوقع في المحذور.
صحيح أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد، الخالق لكل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السموات والأرض، ولكنه تبارك وتعلى جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها، وقوانين ينتظم بها، وإن كان هو عز وجل قادرًا على خرق هذه النواميس وتلك القوانين، وإن كان أيضًا لا يخرقها لكل أحد.
فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين – لا يعني أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب، لأن النصر بدون الأخذ بالأسباب مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل ولأنه منافٍ لحكمة الله، وقدرته عز وجل متعلقة بحكمته.
فكون الله قادرًا على الشيء لا يعني أن الفرد أو الجماعة أو الأمة قادرة عليه، فقدرة الله صفة خاصة به، وقدرة العبد صفة خاصة به، فالخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره الله به هو الذي يحمل على القعود، وهو الذي يخدر الأمم والشعوب (6).
وهذا ما لاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان فقال وهو يؤرخ لحال المسلمين في عصورهم المتأخرة: طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله، والرضا بقضائه وقدره، والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار.
وكان لهذه الطاعة أُثران مختلفان؛ ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دورًا كبيرًا في الحروب، وحققت نصرًا متواصلًا، لأنها دفعت في الجندي روح الفداء.
وفي العصور المتأخرة كانت سببًا في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي، فقذف به إلى الانحدار، وعزله وطواه عن تيار الأحداث العالمية (7).
معالم في اتخاذ الأسباب:
1- لا بد للغايات الشريفة من وسائل شريفة؛ فلا يمكن الوصول إلى غاية شريفة بوسيلة حقيرة، ولا يمكن في سبيل الوصول إلى غاية شرعية أن نصل إليها بما لا يحل.
2- لا يمكن في سبيل الحفاظ على الأوطان أن تذهب حياة المواطنين سدى، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدفه على أشلاء الآخرين وآلامهم ودموعهم.
3- ويبقى إذا استنفذ الإنسان وسائله المتاحة ثم لم يصل إلى هدفه أن يراجع وسائله؛ فلعل الوسيلة الناجعة لم يتوصل إليها بعد، ولعله لم يستخدم الوسيلة الناجعة الاستخدام الأمثل، ولعل الله تعالى حجب عنه من الشر ما لم يدركه، فليست كل الأماني تسبب سعادة الإنسان، فكم من أمنية سعى إليها الإنسان ولمّا تحققت تمنى أن تكون قد غيبت عنه.
4- أحيانًا يكون السبب منا لكننا نلقي باللوم ونعلق أخطاءنا على شماعة الآخرين، صورة الإسلام في الغرب صورة مشوهة هل هي بسببنا نحن كما قيل الإسلام محجوب بأهله، هل هي بسبب فهم الغرب لتعاليم الإسلام فهما يتوافق مع تجربتهم مع الدين المسيحي، أو فهما شوهه بعض التفاسير والأحكام التي تبنت خطا يتنافى مع سماحة الشريعة ويسر الملة
5- القرآن الكريم يرشدنا إلى بيان أهمية مراجعة أنفسنا {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: 30].
6- العاقل هو الذي لا ييأس إن لم تبلغه وسيلته إلى هدفه بل يطرق أبوابًا أخرى ويحتسب سعيه هذا وتجاربه عند الله ليؤجر عليها (8).
______________
(1) تفسير القرطبي (13/ 15).
(2) التحرير والتنوير (16/ 88).
(3) أخرجه الترمذي (2517).
(4) أخرجه الترمذي (2344).
(5) تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سنة الأخذ بالأسباب/ إسلام أون لاين.
(6) ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله/ الإسلام سؤال وجواب.
(7) العلمانية نقلًا عن باول شمتز في كتابه الإسلام قوة الغد العالمية (ص: 87).
(8) الأخذ بالأسباب بين الواقع والشرع/ إسلام أون لاين.
———
* المصدر: موقع تيار الإصلاح.
[opic_orginalurl]