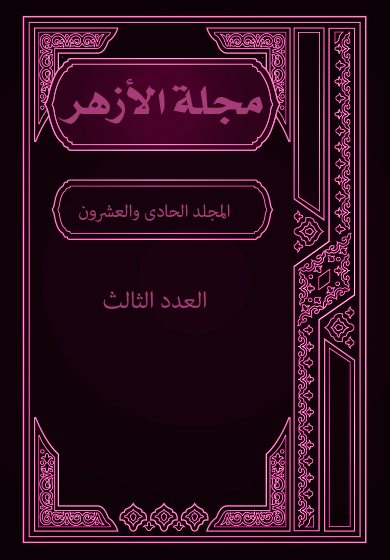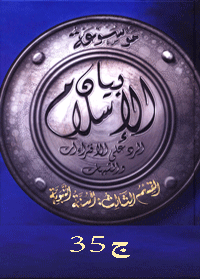الدكتور منير جمعة
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين:
الأول: أحكام ثابتة:

تجمع الشريعة الإسلامية بين الثبات والمرونة
وهذه لا سبيل إلى البحث فيها، ولا تقبل التجدد أو التطور، وهي المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية في ثبوتها وفي دلالتها، وبالتالي فهي لا مجال فيها للاجتهاد، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان فقد جاء عن أبي الدرداء- رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية ” وما كان ربك نسيا” (رواه الحاكم في مستدركه)، وهذا النوع يطلق عليه اسم، الثوابت في الإسلام .
الثاني: أحكام قابلة للاجتهاد والرأي والنظر، وتشمل جانبين:
الأول: ما استجد من الحوادث، ولا نص فيها، فالاجتهاد من خلال القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من المصادر جائز لاستنباط حكم مناسب فيها .
والجانب الثاني: الأحكام الظنية من حيث ثبوتها أو دلالتها، فهي قابلة للاجتهاد البشري، ويسمى هذا النوع باسم: المتغيرات، أو الأمور القابلة للتجديد والتطور.
ثانيا: الأصول التي ترتكز عليها فكرة الثبات:
1- ربانية المصدر، فالمجتمع ليس هو واضع المنهج الإلهي، كي يخضع ذلك المنهج له، وينحني لظروفه بل هو صادر عن الله – عز وجل – ووظيفة الإنسان فيه التلقي والاستجابة: ” إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم “فذلك يقتضي وجود إطار ثابت يتحرك المجتمع وفقا له .
2- ثبات الفطرة، فلما كانت الفطرة: {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (الروم: 30) لا تختلف في جوهرها بين عصر وآخر وأمة وأخرى، ومهما تطورت الجزئيات والفروع، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تنوعا في شق السبيل إلى الأمور الخمسة التي أناط الله بها سلامة الوضع الإنساني في الدنيا، وسعادة الأبد في الآخرة، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
3- ثبات اللغة، فثبات الإسلام في أصوله العامة يرتبط بثبات اللغة، حتى يمكن تثبيت المفاهيم والمعاني الأصلية، دون أن تحدث فجوة بين الأصل اللغوي المستعمل، وما انتهى إليه في صورته ومعناه؛ لأن الحكم يُبنى على تصور صحيح فالمعنى الشرعي للصلاة مثلا، لا يمكن أن يتغير، وكذلك الزكاة، والحج والصوم، فهذه العبادات لها مفهوم ثابت لا يتغير بمرور الزمن.
ثالثا: مبرر وجود المرونة والتطور في التشريع الإسلامي:
1- تطور الحياة وتجددها: فالإنسان في حالة بحث دائمة عن أسرار الحياة، وعن المجهول الذي يتكشف له رويدا، وقد قال رب العزة ” وما أوتيتم من العلم إلا قليلا” فعلى الإنسان ألا يقنع بما عَلِم، وأن يعتقد أن فوق علمه علما، وأن يطلب المزيد {وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (طه: 114)، وقد نص القرآن الكريم على طور الحياة وأسرار الكون: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} (فصلت: 53)، وأشار –على سبيل المثال– إلى تطور وسائل النقل بقوله سبحانه ” الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ”
2- عالمية الإسلام: فقد جاء الإسلام لكافة الأمم والشعوب، فكان لا بد أن يكون قادرا على مواكبة حاجات هذه الشعوب، ومسايرا للحضارات التي تعيش في ظلها، وتحقيق مصالحها المشروعة التي تتطور وتجدد في كل عصر، وفي كل مصر، وسن التشريعات المناسبة والملائمة لكل مجتمع بالاستعانة بذوي الخبرة العملية .
رابعا: مجالات الثبات في التشريع الإسلامي:
1- الأصول والقواعد والمبادئ العامة والسنن الثابتة، والنظريات الأساسية .
فالأصول تشمل العقائد، من مثل أركان الإيمان الستة، وحقيقة أن العقيدة الصحيحة بأركانها كلها شرط لصحة الأعمال وقبولها عند الله، وحقيقة أن الدين عند الله الإسلام، وحقيقة أن الرابطة المقبولة للتجمع البشري هي العقيدة لا الأرض أو الجنس أو اللون هذه بعض الأصول الثابتة التي لا تتغير، ولا تزداد مع الأيام إلا رسوخا تمكنا.
وأما القواعد العامة والمبادئ الكلية: فمنها على سبيل المثال قاعدة العدل، فهي قاعدة ثابتة تحكم العلاقات في البيت والدولة والقضاء وكذلك قادة الشورى، يجب العمل بها وكذلك قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون وفي تطبيق الأحكام …إلخ.
وأما السنن الإلهية الثابتة في الشريعة الإسلامية: فمنها على سبيل المثال: سنة التدافع بين الحق والباطل، كما قال ربُ العالمين: {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ} (البقرة: 251) فهي سنة ثابتة لا تتغير، ففي كل عصر نجد أن الحق له أهله، وأن الباطل له حزبه، والصراع بينهما مستعر، لكن الحق – بإذن الله – صائر إلى بقاء وظهور، والباطل إلى زوال وضمور.
وأما النظريات الأساسية فمنها مثلا أن نظام الأسرة يرتكن على الزواج الشرعي لا السفاح، وأن القوامة للرجل في البيت، وعلى المعاملة بين الزوجين بالمعروف، وعلى مشروعية الطلاق…إلخ.
وفي النظام الاقتصادي نجد من الثوابت في الشريعة الإسلامية: حرمة الربا وتحريم الكسب الخبيث وفرضية الزكاة…إلخ.
وفي نظام العقوبات هناك أمور لا تتطور، كقتل القاتل عمدا، وقطع يد السارق، فقد رفض النبي –صلى الله عليه وسلم– الشفاعة في الحدود، فقد قال: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها” (متفق عليه) .
وفي نظام الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم حرمان الأصول والفروع وأحد الزوجين من الميراث مطلقا.
في مجل الأمور التعبدية والقيم الأخلاقية: فالعبادات في الإسلام لا تتطور في شكلها، كهيئة السجود والركوع، وحقيقة الصوم وقته، وكيفية الإحرام والطواف، ومقدار الزكاة…إلخ.
والأخلاق الأساسية للمجتمع، من صدق ووفاء وعفة وحياء وإيثار، وكذلك الآداب الاجتماعية؛ كالتسمية على الطعام، وإفشاء السلام، ومنع الخلوة بالأجنبية، كلها فضائل لا يستغنى عنها مجتمع كريم .
وبهذا يتضح أن الثبات يمنح البشرية الميزان العدل المستقر الذي يرجع إليه الإنسان في كل ما يعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات، وبالتالي يبقى دائما في دائرة الأمان التي تقيه من التيه والضلال، وهذا الميزان للمجتمع الإسلامي مبادئ ثابتة يتحاكم عليها هو وحكامه على السواء ليفر من الضنك والشقاء الذي وقعت فيه المجتمعات التي انطلقت من عقال المعتقدات والتصورات الأساسية للكون والحياة، وراحت تغير تصوراتها ومرجعيتها، كما تغير أزياءها وفق أهواء بيوت الأزياء .
خامسا: مجالات المرونة والتطور في التشريع الإسلامي:
إن جانب المرونة في التشريع الإسلامي جعله قادرا على التكيف ومواجهة التطور والملاءمة مع كل وضع جديد بحيث لا يحدث جديد إلا وللإسلام فيه حكم، إما بالنص وإما بالاجتهاد، وبذا فهو لا يضيق بالوقائع المستجدة وحاجات الناس ومصالحهم .
كما أن إقرار المنهج الإسلامي بفكرة التطور والمرونة، وجمعه بينها وبين الثوابت أفضى إلى أن يقر التناقضات الاجتماعية الموجودة في الحياة، ويعدها كالسالب والموجب أداة للتعاون والتكامل لا للصراع والاقتتال، ويرى أن الحقيقة ذات شقين فهي تتكامل بالتقائهما: الفرد والجماعة، والمادة والروح، والعقل والقلب، فالإسلام يرى ضرورة وجود هذه المتقابلات التي توصف بأنها متناقضات ويوفق بينها .
أما الفكر الغربي فقد كان إلى ما قبل عصر النهضة يؤمن بالثبات الذي قال به أرسطو، ثم اتخذ من نظرية دارون التي تقول بالتطور البيولوجي منطلقا للتغير الاجتماعي الذي نادى به هربرت سبنسر ومدرسته، ثم انتقلت الفلسفة الغربية نقلة خطيرة حين أعلن هيجل نظريته في التغير المطلق إلى جوار فكرة التناقض والصراع، وهذه هي الفلسفة المادية التي أصبحت دين المدنية الغربية في العصر الحاضر.
أما المتغيرات في الشريعة الإسلامية فميدانها ما يلي:
1- الفروع والجزئيات التي تستند إلى دليل ظني، كالاختلاف في عدد الرضعات التي تثبت بها التحريم، فجعله بعضهم واحدة وبعضهم خمسا، والاختلاف في الطلقات الثلاث هل تقع بلفظ واحد أم لا؟ فإن نظر الفقيه نفسه يمكن يتغير لتغير اجتهاده من مكان لآخر، استمدادا من قاعدة “لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان “.
2- الأساليب والوسائل، فهدف الأرض يمكن تحقيقه بوسائل شتى، وهذه الوسائل تتطور من عصر إلى عصر حتى أصبحنا في عصر الأقمار الصناعية التي يمكن أن تكشف عن وجود الكنوز في الأرض، أو المجوهرات في البحر… إلخ.
وحصول الإنسان على الثواب والأجر في الشريعة الإسلامية له وسائل شتى فمنها: زيارة المريض وتفريج الكربات، وطلب العلم…إلخ . وكذلك تحقيق وتطبيق قاعدة الشورى فهو ليس مقيدا بصورة معينة، فلا بأس من التجديد بشرط الوصول للشورى فعلا.
[opic_orginalurl]