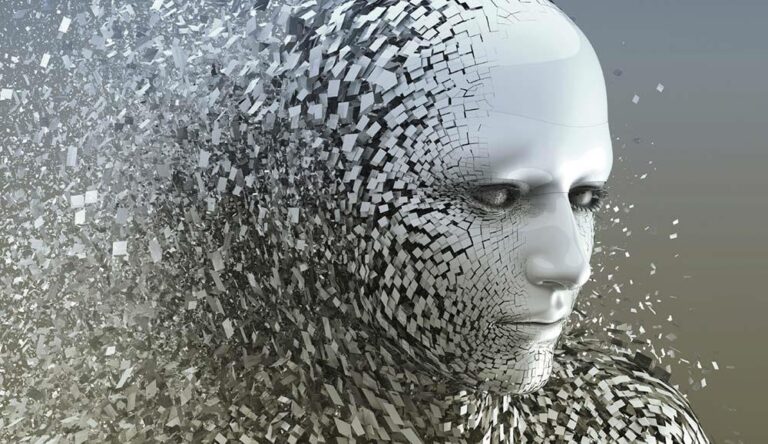“ظواهر الكون حوادث لا تتوقف؛ فغيث ينزل، وزهر يتفتح، وطفل يولد، وإنسان ينمو ويكبر، وآخر يمرض ثم يهلك، وأجسام تبنى وتتركب.. أشياء لا يمكن لعاقل أن يتصور كونها صدفة.. هي ظواهر تحدثنا بطبيعتها الخلابة عن خالقها”
جعفر شيخ إدريس

من الغازات الأولية تتكون مجرات تتكون منها نجوم، ومن المجرات مجموعات مجرات، ولكل من هذه الكائنات ساعة ميلاد، ويوم هلاك.
يزعم بعض الملحدين إنه ليس هناك من خالق لأنه لا دليل على ذلك من عقل ولا حس. ويقول بعض المؤمنين من المسلمين وغير المسلمين: بلى إن للكون خالقاً، لكنهم يوافقون الملحدين في أنه لا دليل عقلي على وجوده، وأن التصديق بوجوده أمر يعتمد على الإيمان القلبي فحسب، أو هو أمر يعتمد فحسب على تصديق الرسل فيما أتوا به.
أما كون الإقرار بوجود الخالق أمرا إيمانيا قلبيا؛ فلا شك في ذلك، و كونه أمر تعززه رسالات السماء؛ فلا شك في ذلك أيضاً. ولكن من قال إن الإيمان والعلم لا يجتمعان ؟! ومن قال إن القلب يطمئن إلى ما لا يدل عليه عقل؟!
إن الإيمان الصحيح المعتبر هو الإيمان القائم على العلم، وإلا لم يكن هنالك فرق بين مَن يؤمن بوجود خالق ومَن يؤمن بوجود خالقين، ومن لا يؤمن بوجود خالق؛ لأن كلاً منهم يمكن أن يقول إن اعتقاده أمر قلبي لا يخضع للمناقشة العقلية. ولم يعد من حق آحادهم أن يقول للآخر إنك مخطئ في اعتقادك.
ولو كان الأمر كذلك لكان من حق من شاء أن يؤمن بما شاء من غير تثريب عليه. وإذا كان بعض المتدينين من غير المسلمين يلجؤون إلى مثل هذه الأقوال المتهافتة ليستروا بها عيب اعتقاداتهم الفاسدة؛ فما هكذا ينبغي أن يكون موقف المؤمن المسلم وهو يقرأ في كتاب ربه:
“فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ” (محمد:19)،”وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ” (الحج:54).
فالعلم أولاً؛ ثم الإيمان المترتب على هذا العلم ترتيبا يفهم من التعبير عنه بفاء السببية “فَيُؤْمِنُوا بِهِ“، ثم الإخبات المترتب على الإيمان “فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ“.
ويقرأ في عشرات من آياته الحكيمة تشديد النكير على الذين يتبعون الظن وأهواء النفوس ويتكلمون بغير علم ويدعون في مجال أصول الدين دعاوى لا تساندها الأدلة والبراهين، ويعدهم من الجاهلين، بل من غير العاقلين، ويتوعدهم بأشد أنواع الوعيد:
“تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” (البقرة:111)، “أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ” (الأنبياء:24)، “إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى” (النجم:23)، “هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ” (آل عمران:66).
فإذا قلت هذا قال لك بعضهم: نحن لا ننكر أن يكون على وجود الصانع –تعالى– دليل، وإنما نقول إنه لا يوجد دليل من النوع الذي يسمَّى بالدليل العلمي (بالمصطلح الحديث) أو الدليل المنطقي البرهاني. لكن هذا ليس بالكلام الدقيق إلا إذا فُهم هذان الدليلان فهما ضيقاً يجعلهما خاصين ببعض العلوم. وإلا فما معنى الدليل العلمي؟ وما هي الأدلة التي يقبلها العلماء الطبيعيون من فيزيائيين وكيميائيين وأحيائيين وغيرهم؟
إنهم يقبلون الدليل الحسي المباشر؛ فكل ما شهد الحس بوجوده شهادة مباشرة فهو موجود لا شك في وجوده. وهذا دليل مقبول عند كافة العقلاء وله في الدين مكانة كبيرة، لكن الأدلة العلمية ليست محصورة في هذا الدليل، فما كل ما يصدق العلماء الطبيعيون، أو عامة العقلاء بوجوده هو مما شوهد مشاهدة مباشرة بالحواس المجردة أو الآلات المساعدة؛ بل إن الإصرار على عدم قبول دليل غير هذا الدليل الحسي المباشر هو نفسه من علامات عدم العقلانية. ولو أن العلماء الطبيعيين وسائر العقلاء لم يقبلوا دليلاً غير هذا الدليل لما تقدم علم من العلوم بل ولا قامت لعلم قائمة؛ ولهذا فإن القرآن الكريم حين استنكر حصر الأدلة في هذا الدليل ونعى على المطالبين به في غير موضعه؛ إنما قرر حقيقة يسلم بها كل العقلاء من بني البشر.
“يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ” (النساء:153)، “إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ.إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ.فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ” (الدخان:34-36)
والنوع الثاني من الأدلة التي يقبلها العلماء وسائر العقلاء على وجود الأشياء، هو الاستدلال على الغائب غير المشاهد بالواقع المشاهد. ولهذا الاستدلال أنواع ترجع كلها بصور المختلفة إلى الاستدلال المنطقي المعروف، ولكن نتائج الاستدلالات المختلفة تبقى قوة صدقها وكذبها وقوتها وضعفها متوقفة على مدى صدق المقدمات، ومدى الثقة بهذا الصدق.
والأدلة على وجود الخالق كثيرة، لكن المتعلق بدلالة الكون المشهود على خالقه ثلاثة، هي: البرهان الكوني، ودلالة الآيات، ودليل العناية. سنشرح هذه البراهين في هذا الفصل شرحا موجزا، ثم نجعلها أساسا في مناقشاتنا للفلاسفة الملحدين والفيزيائيين الغربيين. ولكن بما أن معظم الذين تعرضوا لمسألة وجود الخالق منهم لم يركزوا إلا على الدليل الكوني؛ فسيكون جل همنا مصروفا إليه.
ظواهر الكون وبراهينها:
إن في هذا الكون حوادث لا تتوقف، فغيث ينزل، وزهر يتفتح، وطفل يولد، وإنسان ينمو ويكبر، وآخر يمرض ثم يهلك، وأجسام تبنى وتتركب، وأخرى تتحلل. (كواركات) هي لبنات كُوِّنت منها الأوليات ثم الذرات، ومن الذرات تتكون الجزيئات، ومنها تتكون العناصر ثم المركبات ثم الأجسام المادية المشاهدة. ومن الغازات الأولية تتكون مجرات تتكون منها نجوم، ومن المجرات مجموعات مجرات، ولكل من هذه الكائنات ساعة ميلاد، ويوم هلاك.
فمن الذي أوجدها ومن الذي يفنيها؟
هل جاءت من العدم؟ كلا .. فإن هذا مستحيل عقلاً.
إذن لا بد لها من سبب أحدثها.
لكن هذا السبب لا يمكن أن يكون الشيء المحدث نفسه؛ إذ كيف يسوغ عقلاً أن يكون الحادث المعين سبباً في إحداث نفسه؟
لا بد إذن أن يكون سببه شيئا غيره.
لكن إذا كان ذلك السبب الخارجي هو نفسه حادثا كالأسباب الطبيعية التي نشاهدها؛ فإنه سيحتاج –كالحادث الأول– إلى سبب، وسيحتاج سببه إذا كان حادثا إلى سبب .. وهكذا.
لكن هذا التسلسل في العلل والمؤثرات مستحيل عقلاً.
لابد –إذن– من أن يكون السبب الحقيقي للحوادث سببًا غير حادث.
أي لا بد أن يكون شيئً أزليً ليس لوجوده ابتداء.
ولا يمكن أن يكون هذا السبب الأزلي شيئً غير الله.
______________________________
المصدر: كتاب “الفيزياء ووجود الخالق” للكاتبمع تصرف يسير
[ica_orginalurl]