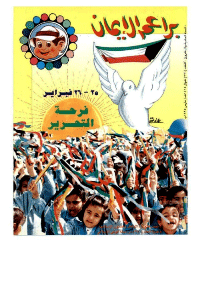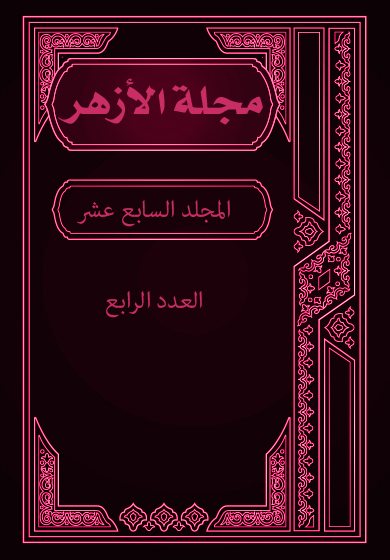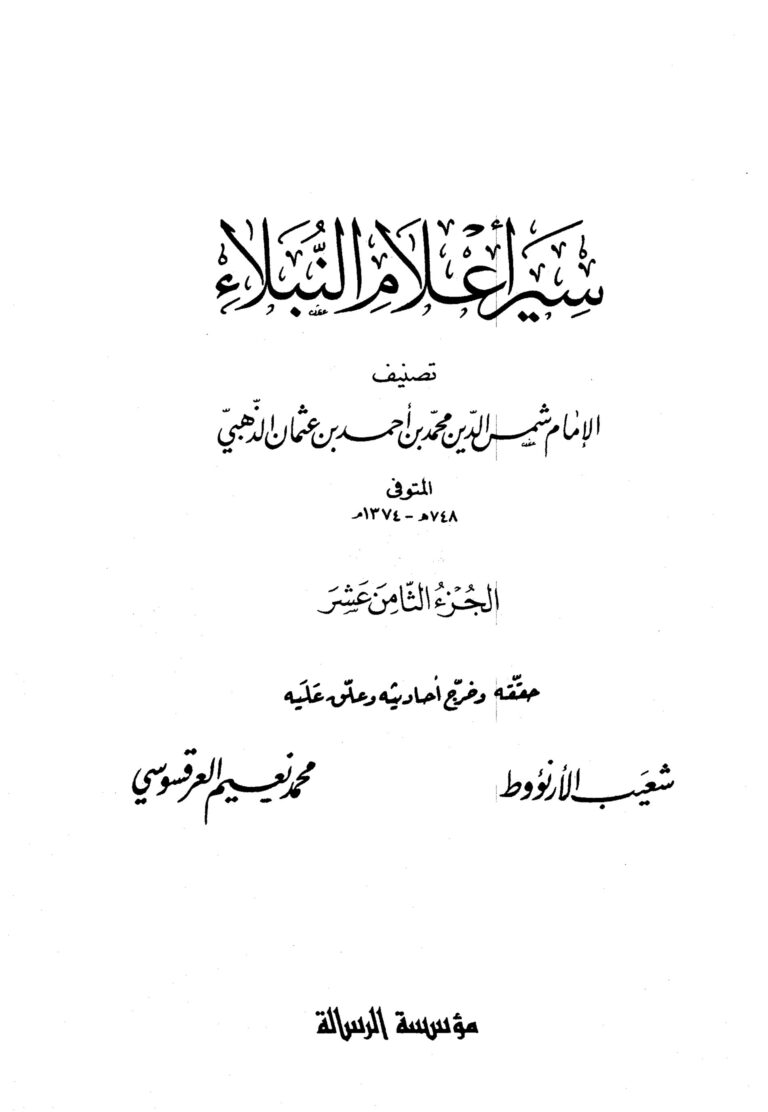الدكتور وجيه يعقوب السيد
الدعاء بهذا الاسم الجليل ” المجيب ” هو ملاذ كلِّ آيسٍ وطامع، وسبيل كل سالك أو ضائع، فحين تضيق بهم السبل، وتتقطع بهم الأسباب، ويصُمُّ الناس عنهم الآذان، ويُعرِض الأخ عن أخيه، والابن عن أبيه، كلٌّ مشغول بنفسه، أبوابهم مغلقة، والدروب نائية بعيدة – لا يجدون ملجأً ولا ملاذًا ولا بابًا مفتوحًا سوى باب المولى سبحانه وتعالى القريب المجيب، لا يُغْلِقُه في وجه طارق أبدًا، بل هو دائمًا مفتوح ينتظر من يُنيخ عنده الرِّحال؛ فالله تعالى هو الجواد الكريم، السميع البصير، القريب المجيب، الذي يجيب عباده دون سؤال، ويعطيهم فوق حاجتهم عطاءَ جواد كريم لا تنفد خزائنه أبدًا، فاللهم لا تغلق بابك دوننا، ولا تهتِكْ سترنا بذنوبنا ومعاصينا، أنت العفُوُّ الكريم المنان، ذو الطَوْلِ والإنعام.
ومعنى اسمه تعالى (المجيب) كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: “أنه الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ودعاء الداعين بالإجابة، وضرورة المضطرين بالكفاية، بل يُنعِم قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء، وليس ذلك إلا لله عز وعلا، فإنه يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، وقد علِمها في الأزل، فدبَّر أسباب كفاية الحاجات، بخلق الأطعمة والأقوات، وتيسير الأسباب والآلات، الموصلة إلى جميع المهمات”؛ [المقصد الأسنى]، لكن ينبغي أن يعلم العبد أن الله تعالى ضمِن له الإجابةَ فيما يختاره له، لا فيما يختار العبد لنفسه، وفي الوقت الذي يريد لا الوقت الذي يريده العبد؛ فهو الحكيم الذي لا يُسْأَل عما يفعل وهم يُسْأَلون؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة))؛ [رواه الترمذي]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئتَ، ولكن ليعْزِمِ المسألة وليُعظِّم الرغبة؛ فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه))؛ [رواه مسلم].
وللمجيب عز وجل إجابة عامة وإجابة خاصة؛ فهو يجيب المضطرين ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين، ومن تعلق به طمعًا ورجاءً وخوفًا رغم عصيانهم ومخالفتهم، وأما إجابته الخاصة فهي للمستجيبين له والمتوكلين عليه من عباده، وهو يستجيب في كل ذلك لمن يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته، ولا تختص إجابته بأهل الإخلاص وحدهم، بل قد يجيب الله دعاءَ مَنْ لا يدل حالُه على الصدق والإخلاص، ولا تعني إجابةُ دعوته حبَّ الله له وتفضيله إياه، بل ربما كان ذلك استدراجًا، وربما ابتلى الله عبده المؤمن بأنواع المحن والمصائب، لا بسبب بغضه وإبعاده، وإنما ليرفع منزلته ومكانته عنده وإدخاله في عِدادِ الصابرين.
أسباب وآداب
ولا شك أن هناك بعض الأسباب والآداب مَن راعاها وأخذ بها كان قريبا من الله، وأجاب الله دعوته بفضله وكرمه؛ ومن ذلك: التقوى والخوف من الله والإخلاص في القول والعمل؛ يقول تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: 27]، فكما يتقبل الله أعمالهم فهو يتقبل دعاءهم، ومن ذلك: المواظبة على الذكر والطاعة، والمداومة على تلاوة القرآن وتدبره، فإذا كان هذا هو غالب حال العبد، استجاب الله له وكشف ما به من ضُرٍّ؛ ففي الحديث الصحيح: “يقول الله تعالى: أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم، وإن تقرب إليَّ بشبرٍ تقربتُ إليه ذراعًا، وإن تقرب إليَّ ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيتُه هرولةً”.
إن الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم الجليل (المجيب) وفهمه فهمًا صحيحًا – عظيمةٌ وكثيرة جدًّا، ويكفي أن يكون على رأسها تصحيحُ علاقة المسلم بربه، وأن يلجأ إليه وحده في السراء والضراء دون وسيط أو شفيع؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله))، وقد خصص القرآن الكريم مساحة كبيرة لمعالجة هذا الخلل في التصور من خلال ما قصه الله علينا من قصص الأنبياء والصالحين؛ ليكون في هذا القصص تثبيت للقلوب، وترسيخ للإيمان بالله وحده، واللجوء إليه في الشدة والرخاء، فحتى أنبياء الله على قربهم ومكانتهم من الله لم يخلوا من الابتلاء بصنوف المحن، ولم يرفعوا أكفَّهم ويتضرعوا سوى لخالقهم ومولاهم، فكان نعم المولى ونعم المجيب.
قال تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: 75، 76]، فبعد صبره على دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا – كما قص علينا القرآن الكريم – وبعد أن ضاقت به السبل بسبب إصرار قومه على الكفر – توجه نوح عليه السلام بالنداء إلى ربه، فأجاب دعوته إجابة كاملة وافية، وحسبُك أن تصدر الإجابة من خير مجيب: الله سبحانه وتعالى؛ لذلك عَبَّرَ بقوله: ﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾، فجمع بين أسلوب المدح وصيغة الجمع التي تدل على قدرة الله المطلقة على كشف الضر وأخذ العصاة؛ حيث نجاه الله وأهله من الكرب العظيم، كرب الطوفان الذي لم ينجُ منه أحد إلا من أراد له الله النجاة وقدَّر له الحياة، ولا شك أن مواطن العبرة في قصة نوح عليه السلام كثيرة جدًّا؛ منها: صبر الإنسان عند الشدائد، وتحمل المشاق في سبيل تبليغ أمر الله، وضرورة الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله، والامتثال التام لأمر الله عز وجل، واللجوء إليه دومًا حتى يكشف عنا ما نحن فيه، مع ضرورة تحلي العبد باليقين وعدم التعجل؛ لأن لله تعالى حكمة وسننًا لا يغيرها الاستعجال وكثرة الشكوى، وكل شيء عنده بمقدار؛ ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُسْتَجَاب لأحدكم ما لم يُعَجِّلْ؛ يقول: قد دعوتُ ربي فلم يستجب لي))؛ [متفق عليه].
ويقول تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: 61]، فنجد نبيَّ الله صالحًا عليه السلام يتلطف في دعوة قومه ويتودد إليهم، فيذكرهم بأصل نشأتهم من الأرض وما كانوا عليه من ضعف وهوان قبل أن ينعم الله عليهم ويستخلفهم في الأرض، ويُغدِق عليهم من عظيم نعمه وسابغ فضله، لكنهم مع ذلك قابلوا النعمةَ بالنكران والجحود، ويطالبهم بالاستغفار والتوبة والإنابة؛ حتى يرفع الله مقته وغضبه عنهم فهو سبحانه قريب مجيب؛ يعني: قريب بالعلم والسمع، مجيبٌ دعاءَ المحتاجين بفضله ورحمته، وقد جاءت جملة ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ استئنافًا بيانيًّا، كأنهم استعظموا أن يكون جُرْمُهُم مما يُقبَل الاستغفارُ عنه، فأُجيبوا بأن الله قريب مجيب، وحرف (إنَّ) فيها للتأكيد تنزيلًا لهم في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قبول استغفاره. والقرب يكون للرأفة والإكرام، أما البعد يُستعار للجفاء والإعراض، والمجيب هنا: مجيب الدعاء، وهو الاستغفار، وإجابة الدعاء: إعطاء السائل مسؤوله؛ [وانظر: التحرير والتنوير لابن عاشور].
وتعد حياة نبي الله أيوب عليه السلام أشهر نموذج وأوضح مثال على تجسيد أعظم صور الصبر على مر العصور، وقد استلهم كثيرون قصته وعالجوها معالجات مختلفة، تتفق كلها في النهاية على أن أيوب عليه السلام كان نموذجًا فريدًا في الصبر، وتدعو إلى الاحتذاء به عليه السلام؛ حيث صبر صبرًا جميلًا وتحمل فوق ما يحتمله البشر، فكافأه الله بأن كشف ضره، وأَعْلَى مكانته، وأثنى على فعله، وجعله قدوة يتأسى بها البشر عندما يتعرضون لأنواع البلاء والمحن، وقد اكتفى القرآن الكريم بإيراد قصته مختصرة؛ لتلائم السياق الذي وُظِّفَتْ فيه، ولتتماشى مع أسلوب القرآن البليغ الذي يعتمد على الإيجاز، ويكتفي بالإشارة والومضة الدالة التي تغني عن الاستطراد؛ يقول تعالى عن هذا النبي الصابر الذي يُضرب به المثل في الصبر والرضا: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 83، 84]، ومما يُروى في هذا المعنى: “أن أبا القاسم بن حبيب حضر مجلسًا غاصًّا بالفقهاء والأدباء، فوجدهم مختلفين في قول أيوب عليه السلام: ﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾، وهل يعد ذلك شكاية وجزعًا أو لا؟ وإذا كان شكاية، فكيف وصفه الله سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾؟ فقال أبو القاسم: ليس هذا شكاية وإنما هو دعاء بيانُه قولُه سبحانه: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾، والإجابة تعقُب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسن الحاضرون كلامه وارتضَوه”؛ [انظر: تفسير الثعلبي].
- مأخوذ بتصرف من موقع “الألوكة”.
[opic_orginalurl]