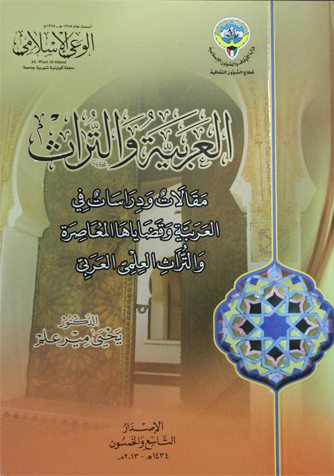د. محمد أبو الفتح البيانوني
لما كانت الدعوة الإسلامية دعوة إلى الله، وعملاً أساسياً من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا بد أن تكون منطلقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
ومنضبطة بأحكام الإسلام في مناهجها وأساليبها ووسائلها.
ذلك لأن الإسلام لا يعرف فصلاً في الحكم بين المناهج والأساليب والوسائل من جهة، ولا بين الوسائل والغايات من جهة أخرى، فالغاية لا تبرر الوسيلة، وإن للوسائل حكم الغايات. وإن أي تجاهل لحكم الشريعة في جانب المناهج أو الأساليب أو الوسائل، يعدُّ انحرافاً في الدعوة عن مسارها، وخروجاً بها عن مصادرها.
ونظراً لأخطاء بعض الناس في هذه القضية، وانقسامهم فيها إلى فريقين:
أ ـ فريق يتساهل في الأحكام في جانب الوسائل، وكأنه يرى أن الغاية تبرر الوسيلة.
ب ـ فريق يتوقف فيها على ما هو وارد، ويعامل الوسائل من حيث الثبات كما يعامل المبادئ والأهداف والغايات.. لهذا رأيت بعد أن ناقشت الشبهة (التوقيفية) في جانب الوسائل في البصيرة السابقة، أن أشير على وجه الإجمال إلى مختلف الضوابط الشرعية الأساسية في هذا الجانب.
ويمكنني تلخيص هذه الضوابط الشرعية في الوسائل الدعوية في ضوابط أساسية عدة هي:
ـ أن يُنصَّ على مشروعيتها صراحة في الكتاب أو السنة، أو يرد طلبها من الشارع بأي وجه من أوجه الطلب. فأي وسيلة نصَّ الشارع على مشروعيتها، أو أمر بها أو أذن باستخدامها صراحة، فهي وسيلة مشروعة وترتب حسب درجة مشروعيتها من وجوب أو ندب أو إباحة.
ـ أن يُنصَّ على عدم مشروعيتها صراحة في الكتاب أو السنة، أو يرد النهي عنها بأي وجه من أوجه النهي، فهي وسيلة ممنوعة شرعاً، سواء كان النهي عنها على سبيل التحريم أو الكراهة، فعلى الداعية الابتعاد عنها واجتنابها.
ـ أن تدخل في دائرة المباح الذي يستوي فيه جانب الفعل أو الترك. فكل وسيلة أذن بها الشارع صراحة، أو سكت عنها، هي وسيلة مباحة يجوز للداعية استخدامها، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ولأن النصوص الشرعية محدودة مهما كثرت، والوسائل متجددة ومتطورة، فلا يمكن للنصوص المحدودة استيعاب ما ليس بمحدود. فالأصل في هذا النوع من الوسائل الإباحة، ما لم يعرض لها عارض يخرجه عن هذا الأصل، ويمكن أن يُعدّ من هذه العوارض أمران:
أ- أن تكون الوسيلة مختلفاً في حكمها بين العلماء، فمنهم من يرى إباحتها، ومنهم من يرى تحريمها.
ب- أن تكون الوسيلة مشوبة، اختلط فيها الحلال والحرام مثل كثير من وسائل الإعلام اليوم.
ونظراً لاختلاف وجهات نظر الدعاة في هذه المسائل، وتفاوت مواقفهم من مثلها، أرى ضرورة الإشارة إلى شيء من ضوابطها لتكون محل نظر واهتمام من قبل الدعاة في مثلها، ونبتعد فيها عن مواقف الإفراط أو التفريط.
فأما بالنسبة للوسيلة التي يختلف العلماء في حكمها بين مبيح ومانع -كما جرى في حكم التصوير والتمثيل مثلاً- فأرى أن تلخص ضوابطها في أربعة أمور هي:
1 ـ الترخص والتوسع في استخدامها حيث تكون الضرورات والحاجات الملحَّة، وتتحقق بها المصالح الدعوية العامة، وذلك لأنه إذا كانت الضرورات والحاجات الملحة تبيح المحظورات القطعية التي لا خلاف في حكمها، فإن إباحتها للأمر المختلف فيه من باب أولى.
2 ـ التورُّع عن استخدامها حيث الأمور العادية، والمصالح الشخصية، التي لا يترتب على تركها ذهاب مصلحة عامة راجحة.. ذلك لأن التورع عن الشبهات مطلوب، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
3 ـ لطالب العلم المتمكن فقط أن يبحث في المسألة المختلف فيها، ويرجح أحد الأقوال بدليله؛ لأن ليس قول واحد من العلماء بحجة على الآخر.. ما دامت المسألة اجتهادية.
4 ـ ليس لمن ترجح له أحد الأقوال تحريماً أو إباحة، أن ينكر على من خالفه في الترجيح أو العمل؛ لأن المسلَّم به في قواعد الحسبة عدم الإنكار في المختلف فيه، وإنما يحق للمخالف أن يدعو الطرف الآخر بلطف إلى الخروج عن الخلاف، أو يحاول إقناعه بما ترجح لديه. وقديماً قال سفيان الثوري -يرحمه الله-: “إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه”.
فلو عمل المسلمون اليوم بمثل هذه الضوابط في المسائل المختلف فيها من وسائل دعوية أو غيرها.. لاندفعت سلبيات الخلاف عن حياتهم، وعاش المختلفون فيما بينهم متآلفين متحابين متعاونين كما كان أسلافهم.
هذا عن الوسيلة المختلف فيها، أما الوسيلة المشوبة التي اختلط فيها الحلال والحرام -كما في كثير من وسائل العصر- فإن من البصيرة الدعوية: أن يعمل الداعية على تجريدها عن الحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ثم يستخدمها خالصة نقية عنها. وإن لم يستطع تنقيتها مما شابها فلا بد أن يوحد العلماء والدعاة موقفهم منها، مشاركة أو معارضة، وذلك بموازنة شرعية دقيقة توازن بين إيجابيات استعمالها، وسلبيات تركها وموازنة دقيقة بين واجبهم تجاهها، وقدرتهم على تحقيق ذلك الواجب.
ولعل من أدق وأجمل ما يستدل به على هذا الضوابط في الوسيلة المشوبة موقفه -صلى الله عليه وسلم- من وسيلة مشوبة في عصره، ألا وهي: “وسيلة النذير العريان”.
فقد كانت عادة العرب في الجاهلية إذا أرادوا الدعوة إلى أمر مهم، والإنذار في أمر خطير، يفعلون أموراً عدة:
1 ـ يصعدون إلى مكان عال مثل الجبل أو نحوه.
2 ـ ينادون بأعلى أصواتهم: واصباحاه، وما إلى ذلك من ألفاظ مشابهة.
3 ـ يتعرون عن ثيابهم، ليشعروا النظار إليهم بخطر الأمر الذي ينادون الناس من أجله، ولسان حالهم يقول: كأن العدو قد عراهم من ثيابهم، فيسرع الناس إليهم.
فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه بأخطر أمر، وأعظم خير -ألا وهو البشارة والنذارة بهذا الدين- لم يترك هذه الوسيلة الدعوية المتاحة المعتادة لأنها مشوبة (بالعُري)، وإنما عمل على تعريتها مما شابها، واستخدمها بعد ذلك في دعوته، فقد صعد على الصفا، ونادى بأعلى صوته “واصباحاه”، ولكنه لم يتعرَّ لذلك.. فأقبل الناس عليه فأنذرهم بما أراد. بل أجاز أن يقول عن نفسه: “أنا النذير العريان” كما جاء في الحديث المتفق عليه، مع أنه الكامل المستور صلى الله عليه وسلم. وكفى بمثل هذا الموقف قدوة ودليلاً، ويا له من حكمة بالغة، وبصيرة عظيمة..
فلو تعاون الدعاة في كل عصر على تجريد الوسائل المشوبة المنتشرة في عصرهم من الشوائب، وبذلوا في ذلك جهودهم قدر استطاعتهم، لوصلوا إلى كثير مما يريدون، واستطاعوا أن يستخدموا من الوسائل المعاصرة المكافئة ما يستخدمه أعداؤهم من دون ضوابط، فسلموا من السلبيات، وحققوا كثيراً من الإيجابيات.
أما المواقف السلبية وحدها، فلا تقدم ولا تؤخر في إصلاح وسيلة مشوبة، بل قد تؤخر من حيث الاضطرار إلى الابتعاد عنها وتجنبها.
ـ أما الضابط الأخير من ضوابط الوسائل: فلا تكون الوسيلة شعاراً من شعارات الكافرين الذين أُمرنا بمخالفتهم، وعدم التشبه بهم. ومن هنا: امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من استخدام وسيلة ناقوس النصارى، وقرن اليهود في دعوة الناس إلى الصلاة، وبحث عن غيرها حتى هداه الله إلى وسيلة الأذان، كما روى مسلم وغيره.
نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يبصرنا في ضوابط وسائلنا، وأن يعيننا على حل مشكلات عصرنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه..
——
المصدر: موقع إسلاميات.
[ica_orginalurl]