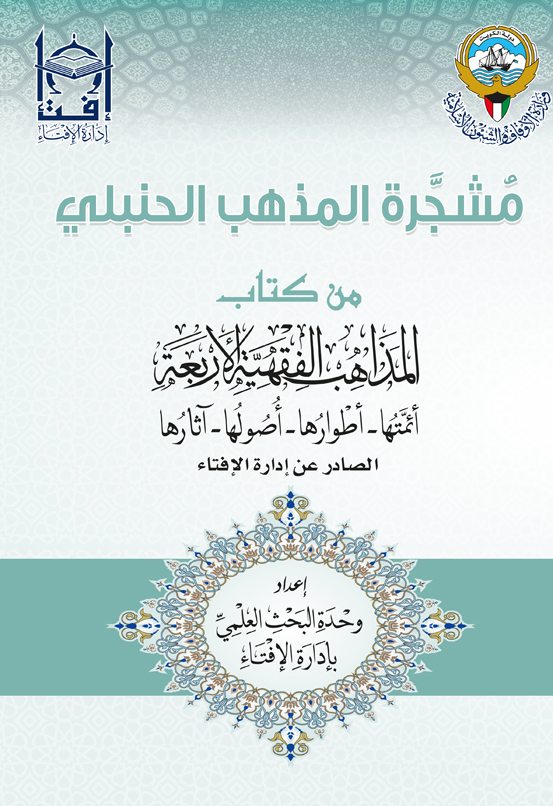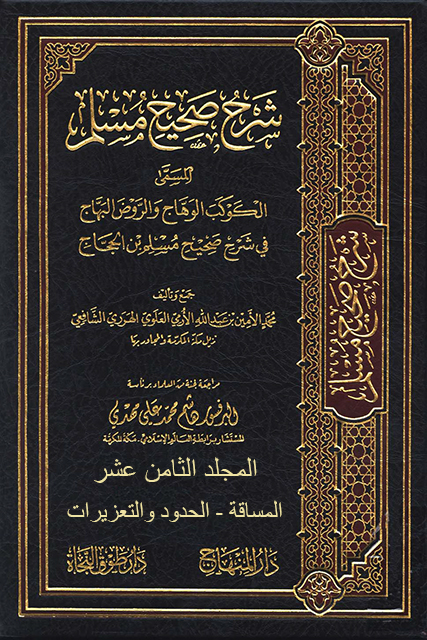الاستشارة:
أنا شاب عمري 26 سنة، عشت في أسرة محافظة، ودرست معظم المراحل المدرسية في السعودية، ابتدأت الصلاة في سن مبكرة والحمد لله، وما زلت مواظبا عليها. تعلمت في المدرسة والجامع أصول العقيدة والعبادات، وكنت مقبلا على ديني إقبال الظمآن على الماء محبا له معتزا به؛ حتى داهمتي الوساوس التي أثرت على حياتي.

كيف أتخلص من الوساوس ؟
سافرت بعد إنهاء المرحلة الثانوية إلى فرنسا حيث كان أخي الأكبر يدرس هناك، وكنت متفوقا جدا في دراستي كما كان ذلك سابق عهدي في المدرسة.
وكنت أجد في ذلك التفوق ما يثبت للغرب أن المسلمين هم أناس منتجون ومميزون، وأنظر إلى أنني داعية لديني من خلال سلوكي وممارستي، وخلال كامل إقامتي هناك لم أرتكب فاحشة ولم أصادق فتيات كما كان ذلك حال كثير من الشباب المسلمين هناك والحمد لله.
في السنة الرابعة من الدراسة أصبحت تأتيني خواطر عن الله وعن الدين لا تليق بي كمسلم بأي بشكل من الأشكال، كانت هذه الأفكار بالنسبة لي كالصاعقة؛ فلم يخطر ببالي في يوم من الأيام أن أفكر في مثل هذه الأمور؛ فقد تقبلت ديني بالفطرة، والله أحب إلي من كل شيء وأعظم عندي من كل شيء. لم أشك يوما في وجود الله، ولكن الأفكار كانت تستجرني لأعرف الحكمة من كل شيء وأسباب تقدير الله لما يحدث في الكون من الحروب والكوارث، وما هي الحكمة من الوضوء قبل الصلاة مثلا، وأشعر كأني (معاذ الله) أحاسب الله على تقديره للأمور، أو أنه (معاذ الله) لا يستحق مني كل ذلك التعظيم، وعندما كنت أسأل والدي عن بعض ما يراودني من أفكار أو عن بعض أمور الدين كان ينفك من الإجابة ويغير الموضوع. فصار ينتابني شك أن هناك أمورا في الدين لا يعرفها إلا الكبار، أو يجب أن يعرفها الإنسان عند سن معينة بالتفكر.
لقد تلقيت ديني وأنا صغير بكل بساطة ووعيته وأحببته، والآن أشعر وكأن كل ما عرفته سابقا عن الدين ليس صحيحا وأنه ليس بهذا اليسر والبساطة والمثالية، و يخيل إليّ دائما أن والدي ينعتني بالكافر لأنني لم أكتشف إلى الآن حقائق الدين، وكأن للدين ظاهرا وباطنا. وفي الحقيقة مجرد التفكير بتكفير أهلي لي والشعور بأنني سأسقط من أعينهم يقتلني. وأحيانا أتساءل: هل الدين كما عرفته وأحببته؟ وهل كل الناس مثلي يؤمنون بما أؤمن، أم أنني أعتبر نفسي مسلما، ولكنني في الحقيقة جاهل بالإسلام ولست من أهله؟.
وحتى أزيل كل هذه الشبهات من رأسي عكفت على قراءة كتب الدين، وقصرت في تحصيلي الدراسي، وكلما حسبت نفسي قد تمكنت من درء إحدى الشبهات كان يعترضني غيرها، وخاصة عندما أقرأ القران، حتى انبريت في قراءة تفسير القرآن من أكثر من كتاب.
وخلال إقامتي في فرنسا كان الطلاب الفرنسيون ينظرون إلى المسلمين على أنهم يقاتلون ويستشهدون حتى يفوزوا بالنساء والحور في الجنة، ولهذا هم يفجرون أنفسهم.
إنني والله أشعر بالخوف والحياء الشديد من الله لجرأتي في الإفصاح عما يراودني من أفكار، ولكنني أريد أن أعرض لكم مشكلتي كما هي؛ لعلي أجد عندكم الحل، وأسال الله أن يغفر لي؛ حيث إنني لم أراسلكم إلا بعدما استنفدت جميع الطرق لكبح هذه الأفكار والاعتقادات التي تراودني، وكلما حاولت الذهاب إلى أحد المشايخ والتحدث إليه، أتراجع في اللحظة الأخيرة لأنني لا أملك الشجاعة الكافية، ولا أجد نفسي قادرا على البوح بما يخالجني؛ لأنه مما يتعاظم علي الحديث به.
أتأسف على الإطالة، ولكنني والله تعبت وفقدت حافزي ومتعتي في الحياة مما أصابني، وكرهت ضعفي، وأتمنى لو كنت ميتا قبل أن يحصل معي هذا.
بعدما سردت لكم قصتي أريد أن أسأل: ما هذا الذي يحصل معي؟ وكيف أتخلص منه؟ وهل يجب أن أفكر في كل ما آمنت به أم أتقبل أمور الدين بالفطرة وبدون تفكير؟
ما هي الأمور التي يجوز للمسلم أن يفكر بها، والأمور التي لا يجوز أن يفكر بها في الدين؟
هل يكفي ما تعلمته وأوقن به منذ صغري من أصول العقيدة والعبادات لأستمر عليه وأكون بذلك مسلما إسلاما صحيحا؟
وكيف أتصرف مع ما يلح على خاطري من أسئلة؟
هل أعتبر بعد هذا كله مسلما، أم ما يحصل معي قد ردني عن ديني؟
إنني لا أريد أن أفقد ديني فهو أغلى ما لدي، ساعدوني وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
يقول الدكتور رمضان فوزي بديني:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
بداية: هون عليك أخي الحبيب؛ فلست بدعا فيما ذهبت إليه من أفكار وشكوك، ولا تترك للشيطان فرصة يتحكم فيك ويزيد من شكوكك، وأبشرك بأن ما أنت فيه هو صريح الإيمان، وإليك هذه البشرى من الهدي النبوي الشريف؛ فقد ورد أنه جاء ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه: “إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به”، قال: “وقد وجدتموه؟”، قالوا: “نعم”، قال: “ذاك صريح الإيمان”. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: “استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان؛ فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا، وانتفت عنه الريبة والشكوك”. وأنت أخي قد حاولت دفع هذه الشكوك والتخلص منها ولم تتحدث بها مع أحد؛ لأنها -على حد قولك- “مما يتعاظم عليّ الحديث به”.
وثق أن الإيمان الذي يأتي بعد مرحلة من الشك والدراسة يكون أثبت من الجبال الرواسي، وإليك قول الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه “المنقذ من الضلال” حيث يقول: “الشك أول مراتب اليقين”، ويقول أيضا: “من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر يبقى في العمى والضلال”. وقد مر -رحمه الله- بتجربة مثل التي تمر بها؛ فقد عاش في عصر من التوتر العلمي والفكري تمثل في الفلسفة ومنهجها في البحث عن الحقيقة، والصوفية ومنهجهم في الذوق والكشف والإلهام، وعلماء الكلام وسفسطتهم، والباطنية وضلالاتهم، ولكنه اتبع منهج الشك المنطقي حتى أسس للمعرفة على أساس عقلي ويقيني بإعمال عقله وحسن صلته بربه؛ حتى عبر عن تجربته بعد أن عبر مرحلة الإيمان إلى مرحلة اليقين قائلا: “فلما خطرت لي هذه الخواطر، وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر؛ إذ لم يكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب الدليل؛ فأعضل هذا الداء، ودام قريبا من شهرين، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم المنطق والمقال. حتى شفى الله تعالى، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين. ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام؛ بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر. وذلك النور هو أكثر المعارف؛ فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة”.
فمن الواضح أخي أن هناك بعض العوامل والأسباب هي التي أوصلتك إلى ما أنت فيه؛ من نشأة تربوية تشوبها بعض الملاحظات، ونشأتك في مجتمع منغلق، ثم هجرتك المباشرة إلى مجتمع على النقيض منه تماما في الانفتاح وتقديس العقل. فأنت ضحية بعض الأساليب التربوية الخاطئة مثل أسلوب التلقي والتلقين في فترات التعليم الأولى، وهروب الوالد من الإجابة عن بعض الأسئلة الدينية التي كانت تراودك؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه للشكوك لتتسرب لنفسك منذ الصغر وتتراكم حتى كونت جبلا عجز عقلك عن الصمود أمامه ومقاومة شبهاته.
وبعد نشأتك في هذه البيئة المنغلقة التي تعتمد التلقين دون فهم أو إدراك أو إعمال للعقل تأتي النقلة المفاجئة إلى بيئة مناقضة تماما، بيئة تقدس العقل أيما تقديس وترفض كل ما تعارض معه حتى ولو كان نصا مقدسا.
إن الجنين إذا تمت ولادته قبل اكتمال نموه في بطن أمه فإنه يتم وضعه في “حضَّانة” توفر له بيئة مشابهة للبيئة التي كان يعيش فيها؛ حتى إذا اكتملت وظائفه واشتد عوده أُخرج من الحضانة ليمارس وظائفه الطبيعية في الحياة بعد أن يكون قد استعد لها، ولو أنه أخرج من بطن أمه ناقصا وترك هكذا لمات على الفور، ولما استطاع الصمود أمام هذه البيئة الجديدة، وأنت تم نقلك من بيئتك المنغلقة إلى بيئة أخرى على النقيض منها انفتاحا وتقديسا للعقل، فأحدث هذا ارتباكا تفكيريا لديك، جعلك تشك في كل الثوابت والبديهيات التي آمنت بها.
وهناك عبارة استوقفتني في رسالتك وهي: “و يخيل لي دائما أن والدي ينعتني بالكافر؛ لأنني لم أكتشف إلى الآن حقائق الدين، وكأن للدين ظاهرا وباطنا، وفي الحقيقة أن مجرد التفكير بتكفير أهلي لي والشعور بأنني سأسقط من أعينهم يقتلني”، ولا أدري ما الداعي لهذا التخيل لديك؟ وهل هناك تصرفات من والدك ولدت هذا التخيل لديك، أم هي تهيؤات فقط منك؟
واسمح لي أخي أن نتحدث معا في ضوء المحاور التالية:
العقل دليل للإيمان
لقد خلق الله تعالى الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات بالعقل الذي جعله الله دليلا للإنسان في طريقه لله رب العالمين، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لهذا العقل حدا ينتهي عنده؛ فكما أن للبصر حدا يقف عنده فللعقل أيضا حد يقف عنده، وإن حاول تجاوز هذا الحد فإنه يكلف عقله وتفكيره ما لا يطيق. وتختلف قوة التفكير من عقل لآخر؛ فما يدركه هذا ربما لا يدركه ذاك.
أخي الكريم، لم يعرف عن دين من الأديان احتفاؤه وتكريمه للعقل الإنساني كما فعل الإسلام؛ فالناظر في الآيات القرآنية لا يخفى عليه دعوات القرآن المتكررة لإعمال العقل والفكر؛ للتدبر في خلق الله تعالى من خلال كون الله المنظور، وما فيه من إنسان وحيوان وسماء وأرض وجبال وبحار ونبات وأشجار مما يدل على بديع صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه؛ وهو ما يزيد في القلب حب الله ويعمق الإيمان به تعالى؛ فيسير الإنسان إلى ربه خاضع القلب منضبط الجوارح مطمئن النفس.
وتتجلى أهم مظاهر عناية الإسلام بالعقل في تلك الحرية التي وهبها للإنسان لاستخدام عقله في معرفة الحق؛ فلم يُكره الإسلام أحدا على الدخول فيه ولكنه وضح له طريق الحق وطريق الضلال، ثم جاء القرآن معبرا عن هذا الموقف الرائع للقرآن من العقل؛ حيث قال تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}، وقال عز من قائل: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}. وقد عاب القرآن على الذين عطلوا عقولهم فرفضوا الدين تأثرا منهم بما وجدوا عليه آباءهم؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ}.
التسليم بالغيب
أخي الحبيب، إن الإيمان بالله يعني أن يعتقد القلب في الله ورسوله، وكل ما جاء به الشرع اعتقادا جازما، لا يرد عليه شك ولا ريبة، ثم يُتبع هذا الاعتقاد بعمل الجوارح حتى يطابق الظاهر الباطن، ومصداق هذا قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.
وهذا الاعتقاد الجازم يقتضي أن يكون هناك أمر ما مغيب عن عموم الناس، وتتفاوت درجة تصديقهم واعتقادهم فيه حسب درجة إيمانهم؛ فمن أول صفات المؤمنين {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.
إذن فلا بد من وجود بعض الأمور التي لا تدركها عقول الناس، ويكون التصديق بها ركيزة من ركائز الإيمان ودعائمه، وهذا في كل الشرائع السماوية؛ فقد جاءت جميعها بكثير من الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي الإلهي الثابت في الكتب المنزلة على الرسل.
والإيمان بالغيب من الأمور التي يتميز فيها الإنسان عن الحيوان؛ ذلك أن الإنسان والحيوان يشتركان في إدراك الأمور الحسية، ولكن الإنسان بعقله يدرك أن هناك أمورا غيبية، لا يستوعبها عقله فيقبل بها كما وردت عن الله ورسله.
الإيمان بالله = التصديق بالغيب + الشهادة
إذن يا أخي فمعادلة الإيمان بالله لها طرفان أساسيان لا غنى لأحدهما عن الآخر: الطرف الأول هو التصديق بالغيب كما ورد عن الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم تصديقا لا يزعزعه شك ولا ريبة، والطرف الآخر هو استخدام العقل في تعميق هذا الإيمان في القلب وترسيخه من خلال التدبر في آيات الله المحسوسة من أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، مع اعتقادنا قصور العقل ومحدوديته.
وانظر معي إلى ما ورد عن المصطفى- صلى الله عليه وسلم- أنه خرج على أناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله، فقال لهم: “فيم كنتم تتفكرون؟”، قالوا: “نتفكر في خلق الله”، فقال: “لا تتفكروا في الله، وتفكروا في خلق الله؛ فإن ربنا خلق مَلَكا قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاور السماء العليا، من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عام، وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام، والخالق أعظم” (رواه أحمد مرفوعا، والطبراني، وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام).
فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- نهى أصحابه عن التفكر في الله تعالى لاستحالة إحاطة عقولهم به، وأمرهم بالتفكر في خلقه، وضرب لهم مثلا بهذا الملك الذي يعجز العقل عن تصوره، ثم عقب -صلى الله عليه وسلم- بقوله: “والخالق أعظم”.
فالخالق -جل وعلا- أعظم من أن ندركه بعقولنا القاصرة؛ فمهما بلغت قوتها فهي عاجزة عن إدراك قطرة من بحر علمه وحِكَمه في خلقه؛ فهو القائل –عز من قائل-: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}؛ فهو يفعل ما يشاء كما يشاء وقتما يشاء، وهو سبحانه {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}.
والعجيب أخي أن بعض الناس خالفوا هذا الهدي النبوي، وبدءوا يقحمون عقولهم في أمور ما أنزل الله بها من سلطان وما فعلها رسوله العظيم ولا صحابته الكرام من أمور نسبوها إلى العقيدة وهي ألصق ما تكون بعلم الكلام، ومثل هذه الأمور أدت إلى مزالق ومتاهات زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام؛ فما أحرى أن نعود إلى عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ تلك العقيدة الواضحة السهلة البسيطة التي جاء بها القرآن وسار عليها الرسول وصحابته الغر الميامين، والتي عبر عنها البدوي ببساطته الرائعة مستمدا مقومات إيمانه من بيئته المحيطة المحسوسة فقال: “البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج ألا تدلان على العليم الخبير”، وما أروع ما عبر عنه العلامة الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه الله- في مقاله الرائع “الإيمان.. من المظهر إلى الجوهر”.
وقفات مع استفساراتك
أخي، بعد هذه التطوافة مع عالم الغيب والشهادة هيا بنا نقف بعض الوقفات مع استفساراتك فنقول:
أولا- {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}:
هذه الآية الكريمة تدلنا على أن رب العزة جل وعلا لا يسأل عما يفعل ويقدر في خلقه؛ فالأمر أمره والخلق خلقه، وهو المتصرف فيهم كيفما شاء؛ ذلك أن حِكمه وتقديراته أكبر من أن تدركها عقولنا القاصرة؛ فالأصل يا أخي أن نتلقى الأمر الإلهي بكل تسليم دون سؤال عن الحكمة من ورائه؛ فإذا تجلت لبعض الناس الحكمة من بعض العبادات والأوامر الإلهية فيها ونعمت، وإن لم تظهر فلسنا مطالبين بمعرفتها؛ فلعل لله حكما لا نعيها. وأضرب لك مثالا على ذلك ولله المثل الأعلى: تخيل مثلا طفلا صغيرا لم يبلغ سن الإدراك بعدُ، أصابته حمى وكتب له الطبيب دواء مرا، وأراد أبوه أن يسقيه الدواء؛ فإن هذا الطفل يبكي ويهرب من أبيه وربما يكرهه لأنه يراه يجبره على أن يشرب دواء مرا يتعذب منه، ولكنه لا يدرك أن أباه يريد شفاءه من هذا الدواء؛ لعجز عقله عن إدراك هذا، ولله المثل الأعلى؛ فإن الكثير من الأمور التي نرى فيها شرا ربما يكون فيها الخير، والعكس، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}.
ولنأخذ هذين المثالين مما ذكرته في رسالتك:
- تقول إنك تريد معرفة أسباب تقدير الله لما يحدث في الكون من كوارث وحروب، ونقول لك: إن الله عز وجل خلق الكون وخلق الإنسان ليستخلفه فيه، وأمره بإعمار الأرض والسعي فيها، ولم يأمره بالخراب ولا الحروب إلا دفاعا عن النفس، ولكنه -سبحانه وتعالى- شاءت حكمته أن يجعل في هذا الإنسان صفات عدوانية ليبتليه هل يتحكم فيها فيؤجر عليها، أم تتحكم فيه عدوانيته فيؤزر وتكون حجة عليه؟ فهذه الحروب لم تحدث بأمر من الله وإن كانت قد حدثت بعلمه ومشيئته، وكذلك الكوارث تحدث في الطبيعة بمشيئة الله تعالى؛ ربما ليهلك بها قوما طاغين أو ليمتحن بها قوما مؤمنين، وهو سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد؛ فمن مات من المؤمنين في هذه الكوارث والحروب فهو عند الله من الشهداء وله أجره، ويبعث على نيته.
- تسأل أيضا عن الحكمة من الوضوء قبل الصلاة؛ فنقول: الأصل في العبادات أن نفكر في الطريق الصحيحة لتأديتها كما أراد ربنا، دون سؤال عن الحكمة منها؛ لأننا لو فتحنا الباب لهذا التفكير لما توقفنا عن التساؤلات؛ مثل الحكمة من الصلاة بالهيئة التي هي عليها الآن مثلا، ولماذا الركوع قبل السجود؟ ولماذا نركع مرة واحدة ونسجد سجدتين؟ ولماذا نصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاثا والصبح اثنتين؟ وهكذا من أسئلة؛ ربما وجدنا إجابات لبعضها وربما لم نجد للكثير منها؛ فعلينا أن نأخذها كما أراد ربنا تعالى؛ فمثلا ربما يقول بعض الناس: “الحكمة من الوضوء طهارة البدن ونظافته”، وهذا سبب منطقي ومقنع عقلا، ولكن نجد في الوضوء بعض الأمور التي يخالفها ظاهرها العقل والمنطق مثل:
o إذا فقد المتوضئ الماء فإنه يتيمم، وهذا التيمم يكون بالصعيد الطاهر أي التراب الذي نتوضأ بالماء لنخلص الجسم منه!!
o إذا أراد المتوضئ أن يمسح على الخف فإنه يمسح أعلاه مع أن باطنه هو المعرض للأرض، وهذا ما دفع سيدنا علي -رضي الله عنه- أن يقول: “لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه”.
o إذا انتقض الوضوء بخروج ريح فإن المتوضئ يكفيه أن يتوضأ دون استنجاء، مع أن الأولى الاستنجاء لغسل المكان الذي خرج منه الريح.
- وهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدرك هذا المعنى حينما ينظر للحجر الأسود ويقول: “والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك”. فهؤلاء هم صحابة رسول الله أخذوا هذه الأمور كما أرادها الله تعالى ولم يهنوا أنفسهم بالبحث عن الحكم منها، ولم يرد أن أحدهم سأل رسول الله عن مثل هذه الأمور؛ فليسعنا ما وسعهم.
ثانيا- تذكر نظرة الفرنسيين للمسلمين وأنهم يفجرون أنفهسم ليفوزوا بالنساء والحور في الجنة:
وهذا الأمر يحتاج إلى وقفات لتصحيحه، وهذا دورك أنت ومن تهيأت لهم الفرصة للاحتكاك بهؤلاء القوم؛ فالإسلام دين أمن وسلام، ولم يكن قط دين حرب وإرهاب، وقد فرض فيه الجهاد للدفاع عن النفس. أما الذين يفجرون أنفسهم نت المسلمين؛ موقفهم واحد من اثنين؛ إما أنهم يدافعون عن أرضهم المغتصبة ولا يجدون وسيلة لرد العدوان والظلم إلا هذه الوسيلة، وهذا ما يفعله إخواننا الفلسطينيون مثلا؛ فهؤلاء القوم احتلت أراضيهم وسلبت أموالهم واغتصبت نساؤهم، والعالم كله يقف مكتوف الأيدي ولا يتحرك لنصرتهم، فتحركوا هم وبذلوا النفس والنفيس للدفاع عن أوطانهم ومقدسات المسلمين وخاصة المسجد الأقصى المبارك؛ فالتفجير هنا ليس هدفا في حد ذاته ولكنه وسيلة، ولو وجدوا غيرها لما لجئوا إليها. أما الموقف الآخر فهم الذي أساءوا الفهم عن الإسلام ففجروا أنفسهم في الآمنين ظنا منهم أن هذا جهاد، وهؤلاء إن وُجدوا فالإسلام براء من أفعالهم، وهم لا يمثلون إلا القلة النادرة من المسلمين.
ثالثا- ثم تتساءل: “لماذا يغرينا الله بالنساء والحور بالجنة؟”
وهنا أجدك ما زلت متأثرا بالتجربة السيئة التي مرت بك مع أبويك، ومتأثرا أيضا ببعض الأفكار التي تصف المسلمين بأنهم شهوانيون وبهيميون، وهذه من الشبهات المردودة؛ فالحديث عن الجنة ونعيمها من الأمور الغيبية التي لا تستوعبها عقولنا ولذلك أتى الله بتشبيهات دنيوية لهذا النعيم، ومصداق ذلك قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}؛ فهؤلاء الزوجات في الجنة نوع من الثواب المستحق للمؤمن، وليس هو الثواب الوحيد؛ فهناك أنواع الطيبات من الطعام والشراب والسرر، والأعلى من كل هذا هو النظر لوجه الله تعالى؛ فهو منتهى المتعة واللذة للمؤمنين.
نصائح علاجية
وهذه أخي بعد النصائح التي أسأل الله أن تكون معينا لك للوصول لمرحلة الحق واليقين:
- توقف فورا عن التفكير في هذه الأمور، ولا تعط لنفسك الفرصة للاستمرار فيه.
- ثق أن عقلك قاصر، وأنه لا يحيط بمثقال ذرة من علم الله، والدليل على ذلك ما يعتري العقل من نسيان وتهيؤات ورؤى وأحلام منامية.
- اصرف تفكيرك فيما أُمرت بالتفكير فيه من أمور المعاش والتفكر في خلق الله.
- استعن على هذه الأمور بتحسين علاقتك بربك والإخلاص في عبادتك وخاصة الصلاة؛ فلها سر ونور يضيء الله به العقول والقلوب. وأكثر من دعاء الله تعالى والإلحاح عليه أن ينير بصيرتك ويهديك لطريق الحق.
- اعلم أن للشيطان دورا كبيرا فيما أنت فيه؛ فهو قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم بالوسوسة لهم والتشكيك في دينهم؛ فاستعن عليه بكثرة الاستعاذة بالله منه.
- أكثر من قراءة القرآن الكريم؛ فهو المنهاج الواضح والموصل للتعرف على الله رب العالمين ومعرفة أسمائه وصفاته العلا.
- تفكر في نعم الله وفضله عليك وآلائه التي لا تعد ولا تحصى حتى تعظمه سبحانه وتعالى في قلبك؛ فتعظيمه طريق للخضوع له واليقين فيه.
- أكثر من القراءة في كتب السلف الصالح وخاصة الذين مروا بمثل تجربتك؛ مثل الإمام الغزالي وابن رشد.
- الزم صحبة صالحة تعينك على طريق الحق والوصول لليقين. وإذا تغلبت عليك هذه الشكوك ولم تستطع دفعها فلا مانع من الاستعانة بطبيب نفسي؛ فالعلاج النفسي مكمل للعلاج الإيماني في الوصول إلى الاستقرار واليقين.
وفي النهاية أخي الكريم أسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان برد اليقين.
[opic_orginalurl]