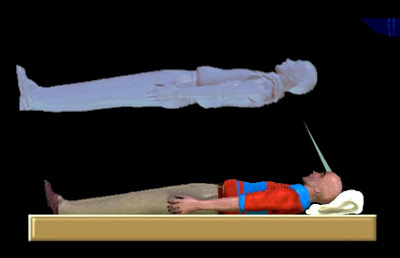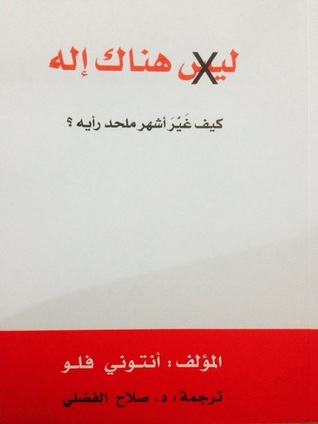لا يتوقف الحديث عن العلاقة بين العلم والدين في جلسات الكتاب والمفكرين والمنظرين، ولا تهدأ المقالات التي تتناول تلك القضية التي لا يكف الملحدون عن إثارتها من وقت لآخر محاولين إثبات أن ثمة تعارض وصدام بين المكتسبات العلمية والتعاليم الدينية… نظرة فلسفية أعمق لا تخلو من إسقاطات علمية يتناولها الكاتب في المقال التالي في محاولة جديدة لفك اشتباك تلك العلاقة… إن ثبت وجود اشتباك من الأساس!*
أ.د. عبد الباسط هيكل**

أفسح الدين مجال العلم أمام الإنسان بالبحث في الكون بأكثر من مائة وثلاثين أمرا قرآنيا بالنظر والتفكر والتأمل، والتعقل.
روّج البعض لافتراض اكتسب بطول التداول قوة الحقيقة، مفاده أن الدين مادام ينطلق من غيب غير مشاهد، والعلم مادام لا ينطلق إلا من محسوس، فلا مجال لالتقاء العلم بالدين، وأنه لا علاقة بينهما، وهذا افتراض غير صحيح لأن الدين وسيلتنا لمعرفة الغيب في حدود إدراكنا العقلي، وقدراتنا التصورية، ووفق مفردات يمكن للبشر أن يفهموا دلالتها، ثم أفسح الدين مجال العلم أمام الإنسان بالبحث في الكون بأكثر من مائة وثلاثين أمرا قرآنيا بالنظر والتفكر والتأمل، والتعقل، فعلاقة الإنسان بالكون تقوم على العلم الذي سيحقّق مراد الله في قوله تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ” (فصلت: 53) .
بدأت المادية العلمية منكرة لعالم الغيب مؤمنة بعالم المادة المشاهد فكل ما لا يقع تحت الحس في النظرة العلمية غير موجود، فارتبطت المادية في تلك المرحلة بالمحسوس؛ فطبيعة المادة أول الأمر كانت مادة صلبة محسوسة ملموسة، ثم كشف العلم أن المادة الصلبة في حقيقتها سائلة، وأنها تتبخر إلى ذرات دقيقة كل ذرة هي مجموعة إلكترونات تدور حول نواة من البروتينات، وأن الإلكترونات والبروتونات هي شحنات كهربائية أي طاقة تتحرك في الفضاء المطلق، فانتقلت المادة علميا من كونها حقيقة محدودة إلى كونها حقيقة غير محدودة؛ لأن وحدة بناء الكون عدد غير متناهي من الذرات، والكون لا متناهي في حدوده، فالكَون الّذي نَدرُسُهُ فِي الوَقتِ الحالي خاضِع ضِمنَ عُمر أربعة عشر مليار سَنَة ضَوئِيّة.
وبعد رحلة علمية طويلة من جمع الشواهد وطرح النظريات واستخراج القوانين، انهارت نظرية الحقائق الثابتة بنظرية “أينشتين” التي قامت فكرتها على خطأ الاعتقاد بأن المعرفة الموضوعية عملية تراكم مستمرة للحقائق؛ ليفتح بذلك الباب على مصراعيه لتطوير رحلة الشك وصولا لاستحالة المعرفة الموضوعية النهائية؛ وتحولت كل الحقائق حول الكون من مطلقة ثابتة إلى نسبية متغيرة، فالحقيقة تتخذ ألف شكل لأعيننا إذا كان لنا ألف موقع مختلف من تلك الحقيقة كل يرى الصورة من زاويته، وتطورت النظرة العلمية من يقينية النتائج العلمية إلى احتماليتها.
بين العلم والدين

هناك فجوة تحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية من العلم ليستكمل الإنسان معرفته بحقائق الكون فكيف يظن أنه بمقدوره أن يحيط إدراكا بإله الكون!
انتهى العلم من مؤمن بمادة حقيقية ثابتة محدودة إلى مادة نسبية متغيرة غير محدودة، وأمسى الكون عالما ممتدا إلى ما لا نهاية.. وانتهت مئات الأعوام من العمل العلمي إلى أننا رغم كل ما وصلنا إليه مازلنا في أول طريق معرفتنا بأنفسنا ومجرتنا، وهنا يقفز إلى ذهنك قوله تعالى: “وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا” التي جاءت تعقيبا على سؤال حول حقيقة أمر غيبي وهو الروح “وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي” (الإسراء:33) وكأن لسان الحال تقول ما دمت عاجزا أمام الكون المشاهد كيف تدرك الغيب الذى لما يهيأ تكوينك الخلقي للتعامل مع حقيقته إلا بقدر ما حمل لك الوحي سماعا لا مشاهدة وإخبارا لا تجريبا؟!!
فهناك فجوة تحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية من العلم ليستكمل الإنسان معرفته بحقائق الكون فكيف يظن أنه بمقدوره أن يحيط إدراكا بإله الكون، مازال نفوذ الإنسان لمعرفة الكون محدودة وهذا الكون المخلوق المقيد، فكيف بالإنسان أن يصل إلى الخالق المطلق!!
حقائق الكون اللامتناهية -باعتراف العلم- تجعل العجز عن الوصول إلى جوهر الأشياء ليس دليلا على عدميتها بل دليلا على قصور الأدوات الباحثة عنها، فنفي الشيء لأننا لما نُدركه بحواسنا وإثباته لأننا أدركناه بحواسنا طرح باطل علميا، فتصبح دعوى إنكار وجود الله؛ لأنه لا يخضع للحواس، دعوى ساذجة في ظل البحث العلمي الذي يكشف كل يوم كما هائلا من حقائق الكون كانت أدوات الإنسان قاصرة عن الوصول إليها، ثم لا يدع ثبوتها، فالمعرفة باتت في حالة متحركة، وبات الغائب عن علم الإنسان بنفسه وكونه أكثر من الحاضر، “يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ” (الرحمن:33).
ويتدخل العلم؛ ليجيب على الملحدين في قضية قديمة حديثة، يتكرر دوما سؤال: كيف خلق الله الشرّ، ويعاقبنا عليه؟!
وللقدامى والمعاصرين ردود كثيرة في ذلك منها قول ابن رشد “أن خلق الله للأفعال الخيرة والشريرة لا يتعارض مع الإيمان بأنه عادل. إن الله يخلق الشرّ؛ لأنه في النهاية وفي التحليل الأخير “خير” لقد خلق “النار” وهي خير في ذاتها، وإن كان “الضرر” الناتج عن إحراقها لجسم الإنسان، فتقضي عليه، هو عارض من عوارضها.”
وإذا تناولنا تلك القضية في ضوء معالجة العلم لعلاقة البرودة بالحرارة، وعلاقة الضوء بالظلام، يتضح لنا حقائق جديدة في علاقة الشر بالخير، العلم يُعرف الحرارة بأنها: “صورة من صور الطاقة المتولدة من التـفـاعـل الكيميائي أو النووي أو بـذل الشغــل الميكانيكي” أما البرودة فهي صورة لانعدام تلك الطاقة المعروفة بالحرارة، ويُعرّف العلم الضوء بأنه “طاقة مشعة يشار إليها بأنها إشعاع كهرومغناطيسي مرئي للعين البشرية، ومسؤول عن حاسة الإبصار.” أما الظلام فهو انعدام لتلك الطاقة المشعة، يُفهم من ذلك أن البرودة والظلام لا وجود لهما إلا بانعدام الحرارة والضوء، فمفهوم البرودة والظلام علميا يطلق على انتفاء صورة الطاقة الحرارية، والطاقة المشعة، فهو مفهوم لشيء عدمي، كذلك الشر هو مفهوم عدمي متى انعدم الخير تحرّك الشرّ، فالله خلق الخير وأمر الناس به، فمتى ضعف الخير توّلد الشرّ الذي لم يُخلق ابتداء كنقيض مساوي للخير، بل هو حالة نقيضة للخير تتكون لانعدام الخير، ويتفاوت وجودها بتفاوت وجود الخير قوة وضعفا، فالشر مثل البرودة والظلام ليس حقيقة مستقلة في نفسها بقدر ما هو ناتج عن غياب الخير مثل غياب الحرارة والضوء.

تستوقفنا نظريتان حول بداية تشكل الكون: الأولى نظرية الحالة الثابتة أو المستقرة، نظرية الكون اللامتناهي، والثانية.. نظرية الانفجار العظيم.
وننتقل إلى قضية أخرى وهي النشأة الأولى للكون، وتستوقفنا نظريتان حول بداية تشكل الكون: الأولى نظرية الحالة الثابتة أو المستقرة، نظرية الكون اللامتناهي أو الخلق المستمر وترى تلك النظرية أن هناك مادة جديدة تتشكل وتخلق باستمرار مع توسع وتمدد الكون، والنظرية الثانية: نظرية الانفجار العظيم وهي أن الكون كان يومًا كتلة واحد في حالة حارة شديدة الكثافة ثم تشكل بفعل انفجار هائل، وبعض التقديرات الحديثة تُقدّر حدوث تلك اللحظة قبل 13.8 مليار سنة، وهذه النظرية الأكثر شيوعا لما تقدِّمه من تفسير لكثير من الظواهر الكونية.
وكلا النظريتين لا تصطدم بالإيمان، وليست سببا للإلحاد؛ لأنها تناقش لحظة التشكل الأولى، وتسكت عن فاعل تلك النشأة، فليس هناك مجال للصدام بين الملحد والمؤمن حول تلك النظريات التي لا تعدو كونها افتراضا لمحاولة التعرف على الشكل الأول لبداية الكون، وإن حاول بعض الباحثين في الإعجاز العلمي للقرآن في تبنى النظرية الثانية، وإثبات أن القرآن الكريم أشار إليها وإلى مادة تكوين الكائن الحي في قوله تعالى: “أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ” (الأنبياء 31-32).
ولم يتوقف المنكر لله عند حدود الإيمان بالافتراض العلمي “النظرية”، وإنكار فكرة الغيب (ما وراء الطبيعة) واتصالها بالبشر وحيا، بل قال إن الطبيعة (الكون) تشكّلت صدفة، وليس هذا الطرح مرتبط بالعصر الحديث، فقد قيل مرارا وتعددت الردود عليه بأنه لا نقبل بفكرة الصدفة في أبسط الأمور في حياتنا مثل أن يقول أحد إن سفينة تكونت صدفة ثم وصلته صدفة لتحمله صدفة أو نقول بأن حروف كتاب ما تجمّعت صدفة لتخرج لنا كتابا.
وأقول لا يستقيم أن يكون مرادف النظام الدقيق وصفا للكون هو الصدفة العابرة وصفا لنشأته، وكأننا نفسر الشيء بنقيضه، العلم في رحلته التي لا تتوقف يكشف من أسرار الكون (الطبيعة) ما يؤكد انتفاء المصادفة، ويحكي لنا الدكتور مصطفى محمود في رحلته من الشك إلى الإيمان كيف أن “المادية العلمية قدمت لنا الكون في بناء هندسي دقيق من الذرة المتناهية إلى أكبر جرم سماوي، دقة في أقل الأشياء حجما من ورقة الشجر وجناح الفراشة إلى ذرة الرمل، وضخامة تجعل المجرة بها أكثر من ألف مليون شمس.”
فلو كانت الكرة الأرضية أصغر حجما مما هي عليه لضعفت الجاذبية وأفلت الهواء من جوها وتبعثر في الفضاء ولتبخر الماء وأصبحت الأرض مثل القمر بلا ماء ولا هواء فتستحيل عليها الحياة، ولو كانت الأرض أكبر حجما لازدادت قوة جاذبيتها وصعبت الحركة على سطحها فتستحيل الحياة عليها إذ يصبح الجسد عبئا ثقيلا لا يمكن حمله، ولو أن الأرض دارت حول نفسها ببطيء مثل القمر لاستطال النهار في اليوم الواحد إلى أربعة عشر ضعفا، والليل الواحد إلى أربعة عشر ضعفا، ولو أن الأرض اقتربت في فلكها من الشمس لاستحالت الحياة لشدة الحرارة مثل الزهرة، ولو ابتعدت لاستحالت الحياة لشدة البرودة مثل المشترى، ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا لامتصت الأكسجين واستحالت الحياة لعدم التنفس، ولو كانت البحار أعمق لامتصت المياه الزائدة ثاني أكسيد الكربون واستحالت حياة النبات بدونه، ولولا أن الثلج أقل كثافة من الماء لما طفا على السطح، وحفظ أعماق البحار دافئة صالحة لحياة الأسماك والأحياء البحرية، ولو كان الغلاف الهوائي للأرض أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشهب لكنها تتفتت في أثناء اختراقها للغلاف الهوائي الكثيف، ولو زادت نسبة الأكسجين في الهواء لازدادت معدلات الاشتعال وتحولت الحرائق إلى انفجارات، ولولا مظلة الأوزون التي تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى الأرض بنسب ضئيلة لأهلكتنا أشعة الشمس القاتلة.
هذه الحسابات الدقيقة لتكوُّن الحياة على الأرض نراها في جسم الإنسان الذى يحتوى دمه على عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والسكر والكولستيرول والبولينا كل عنصر بنسب محددة محسوبة بدقة، فأي اختلال ضئيل في مقدار هذه النسب يكون المرض، فإذا زاد كان العجز والموت، نظام دقيق يحفظ الحياة داخل الجسد من درجة حرارة لا تتجاوز37 مئوية من ورائها عمليات فسيولوجية وكيميائية تحافظ على درجة الجسم مكيفة، ونبض القلب، ونظام الامتصاص والإخراج، وضغط الدم.
الهامش:
* إضافة المحررة
_____________________________________________
** أستاذ اللغة العربية وآدابها المشارك بجامعة الأزهر الشريف – جمهورية مصر العربية
[ica_orginalurl]