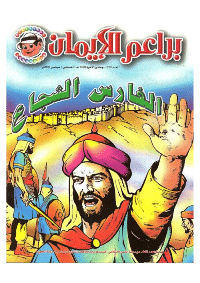الشمولية الإسلامية تعني أن الشريعة الإسلامية أو الدين الاسلامي شامل لكل نواحي الحياة وأنه صالح لكل زمان ومكان بخلاف الأوضاع البشرية فغالبًا ما يكون لها وقت معين على ما فيها من خلل وغالبًا ما تكون محصورة في مكان معين وزمان معين قال تعالى: “وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم…” (الأنعام:38) ويقول عزوجل: “وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ” (الأنبياء:19).
والشمول هي الخاصية الثالثة من خصائص التصور الإسلامي وهي كذلك ناشئة من طبيعة الخاصية الأولى: خاصية أنه رباني.. من صنع الله لا من صنع الإنسان.. والشمول طابع الصنعة الإلهية الأصيل.
 فالإنسان لأنه أولا محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان… إذ هو حادث في زمن يبدأ بعد عدم وينتهى بعد حدوث ومتحيز في مكان سواء كان فردًا أو كان جيلاً أو كان جنسًا لا يوجد إلا في مكان ولا ينطلق وراء المكان كما أنه لا يوجد إلا في زمان ولا ينطلق وراء الزمان ولأنه محدود الكينونة من ناحية العلم والتجربة والإدراك يبدأ علمه بعد حدوثه ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزمان والمكان وحدود وظيفته كذلك كما أسلفنا ولأنه فوق أنه محدود الكينونة بهذه الاعتبارات كلها محكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله. الإنسان وهذه ظروفه حينما يفكر في إنشاء تصور اعتقادي من ذات نفسه أو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك يجيء تفكيره جزئيا.. يصلح لزمان ولا يصلح لآخر ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر ويصلح لمستوى ولا يصلح لآخر.. فوق أنه لا يتناول الامر الواحد من جميع زواياه وأطرافه وجميع ملابساته وأطواره وجميع مقوماته وأسبابه.. لأن هذه كلها معتدة في الزمان والمكان وممتدة في الأسباب والعلل وراء كينونة الإنسان ذاته.. ومجال إدراكه.. وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامل الضعف والهوى وهما سمتان إنسانيتان أصليتان.
فالإنسان لأنه أولا محدود الكينونة من ناحية الزمان والمكان… إذ هو حادث في زمن يبدأ بعد عدم وينتهى بعد حدوث ومتحيز في مكان سواء كان فردًا أو كان جيلاً أو كان جنسًا لا يوجد إلا في مكان ولا ينطلق وراء المكان كما أنه لا يوجد إلا في زمان ولا ينطلق وراء الزمان ولأنه محدود الكينونة من ناحية العلم والتجربة والإدراك يبدأ علمه بعد حدوثه ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدود كينونته في الزمان والمكان وحدود وظيفته كذلك كما أسلفنا ولأنه فوق أنه محدود الكينونة بهذه الاعتبارات كلها محكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته فوق ما هو محكوم بقصوره وجهله. الإنسان وهذه ظروفه حينما يفكر في إنشاء تصور اعتقادي من ذات نفسه أو في إنشاء منهج للحياة الواقعية من ذات نفسه كذلك يجيء تفكيره جزئيا.. يصلح لزمان ولا يصلح لآخر ويصلح لمكان ولا يصلح لآخر ويصلح لمستوى ولا يصلح لآخر.. فوق أنه لا يتناول الامر الواحد من جميع زواياه وأطرافه وجميع ملابساته وأطواره وجميع مقوماته وأسبابه.. لأن هذه كلها معتدة في الزمان والمكان وممتدة في الأسباب والعلل وراء كينونة الإنسان ذاته.. ومجال إدراكه.. وذلك كله فوق ما يعتور هذا التفكير من عوامل الضعف والهوى وهما سمتان إنسانيتان أصليتان.
ولأن ختم الرسالات بهذه الرسالة ونسخ رسالات الأنبياء من قبلها بها؛ يستلزم أن تكون هذه الشريعة وافية بمتطلبات الحياة كلها. ومن لم يؤمن بهذه الحقيقة فإنه يلزم من كلامه أن هذا الدين جاء بالضيق والحرج والجور وهو ما لا يقول به مسلم، ومضاد لقول الله تعالى: “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ” (الحج:78).
وكما جاءت الشريعة الإسلامية عامة لكل البشر على اختلاف أجناسهم، لا فضل فيها لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فإنها كذلك رسالة شاملة لكل جوانب الحياة ومناحي الاجتماع لم تترك شاردة ولا واردة إلا ذكرت فيها خبرا أو شملتها حكما أو كانت مندرجة تحت أصل أو قاعدة.
فقد تناولت تحديد الغاية من خلق الإنسان ووظيفته في الحياة ومركزه في هذا الكون، ونظمت علاقته بربه وصلته بإخوانه والمجتمع الذي يعيش فيه، وحددت الحقوق والواجبات، ووضعت أصولا لفض المنازعات وإيصال كل ذي حق حقه، وإقامة العدل بين الناس في كل جانب من جوانب نشاطاتهم وأعمالهم.
فهي منهج حياة كامل جمع بين الدنيا والدين، وبين العمل والعبادة وبين الظاهر والباطن… فضمن بذلك للإنسان خيري الدنيا والآخرة.
وقد قسم علماء الشريعة الدين في جملته إلى أربعة أقسام هي:
1- أصول الدين.
2- ما علم من الدين بالضرورة.
3- الأحكام المتعلقة بالأخلاق وقواعد السلوك.
4- الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية.
وهو ما يعرف في اصطلاح المتأخرين (بالفقه) وهو باب واسع يتناول معظم نشاطات البشر وهو ينقسم إلى:
1- العبادات التي تنظم العلاقة مع الله وتوثق به الصلة سبحانه.
1- المعاملات: وهذا الأخير يندرج تحته كثير من الأحكام والمعاملات مثل:
أ – الأحكام المتعلقة بتنظيم الأسرة بما يشمله من نكاح وطلاق وحقوق.
ب – أحكام المعاملات كالبيع والشراء والبيوع الجائزة والمحرمة والأمور التجارية عامة من شركات ومبادلات.
جـ- أحكام المرافعات والقضاء وفض المنازعات بين الناس وإقامة العدل في ظل الدولة الإسلامية.
د- تنظيم علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في أيام السلم والحرب… إلخ
هـ- الحدود والعقوبات كحد الردة والزنا وشرب الخمر والقذف وغيرها من الحدود الشرعية.
فهذه الشمولية التي اتصفت بها الشريعة الإسلامية حتى تجاوزت الأمور الظاهرة إلى النيات المضمرة والمقاصد الخفية وإصلاح الإنسان من داخله وكبح جماح الغرائز البهيمية فيه ومحاسبة الإنسان على عمله الظاهر ونيته المضمرة وإقامة وازع من النفس عليها، قال – صلى الله عليه وسلم – (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) صحيح البخاري بدء الوحي وقال العلماء: إن هذا الحديث نصف العلم؛ لأنه يعالج الجانب الخفي في النفس المستكن في الضمير، وبقية الأحكام تعالج الأعمال الظاهرة.
صلاحية الشريعة للناس في كل زمان ومكان:-
مصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما يتفرع عنهما من مصادر وأصول مرتبطة بهما، وهي محددة في كتب الأصول والكتاب والسنة بما تضمناه من نصوص وأحكام، جاءت على قدر كبير من الدقة والأحكام الموروثة والمبادئ العامة والقواعد المقررة، مما يجعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، تتسع لكل تطور وتتطور الحياة في ظلها بلا أي توقف أو وقوع حرج أو ضيق، بل إنها تحفظ للإنسان توازنه في بنائه وتكوينه وتلبية مطالب حياته في شكل متكامل واضح ومرن.
وأمور الناس في الحياة: إما ثابتة مستقرة لا يتطرق إليها التحول أو التغيير باختلاف الزمان أو المكان، وإما أمور قابلة للتغير والتبدل والانعطاف، وتختلف النظرة إليها من وقت لآخر، وتختلف فيها الأفهام، وهذا يحتاج إلى ضبط وتقييد يتسع لكل المتغيرات والظروف، ويحفظ فيها الحق وحسن الأداء تحت كل الظروف والمتغيرات.
وتبعا لهذه الأمور الموجودة في الحياة جاءت نصوص الشريعة على ضربين متمايزين ينتهيان إلى مصب واحد وهو جلب المصالح للعباد ودفع الضرر عنهم في كل زمان ومكان.
أما الضرب الأول من النصوص
فإنها جاءت أحكامها نصية لا مجال للاجتهاد فيها، وقد شملت أقساما من أحكام الدين وأصول التعامل لأن هذه الأحكام لا تتغير ولا تتبدل مع اختلاف الزمان أو المكان، وهذا واضح في مجال العقيدة في الله وتوحيده وإخلاص العمل له، لأن الإنسان يحتاج إلى هذه العقيدة كحاجته إلى الطعام والشراب والنكاح وقد فطر على ذلك، والألوهية ومقتضياتها لا تتغير ولا تتبدل لا باختلاف الزمان ولا المكان.
وكذلك جاءت أحكام الشريعة في قواعد الأخلاق ومحاسن العادات والآداب على اختلافها إذ هي أمور تظل مطلوبة ومحمودة في كل الظروف والأحوال.
كما أن لبعض المعاملات التي تتصل بعلاقات الأفراد في محيط الأسرة وأحكام النكاح والطلاق والحضانة وغيرها صيغة استقرار، كلها جاءت أحكامها تفصيلية لأنها لا يختلف الحكم فيها باختلاف الزمان أو المكان.
والميراث هو الآخر قد تولى الله بيانه بنفسه سبحانه، فأعطى كل ذي حق حقه بلا وكس ولا شطط، ولم يترك فيه مجالا لمجتهد إلا في مسائل فرعية بسيطة نادرة الوجود، بل جاءت النصوص في هذه الأحكام كلها نصية من كتاب الله.
وكذا تحريم بعض المعاملات كالربا وبيع ما لا يجوز بيعه ومنع الضرر والجهالة في المعاملات.
كما شملت العقوبات كلها مثل:
1- عقوبة الردة عن الإسلام.
2- عقوبة الزنا.
3- عقوبة السرقة.
4- عقوبة القصاص في النفس وما دونها.
5- عقوبة القذف.
6- عقوبة قطع الطريق.
7- عقوبة شرب الخمر.
أما الضرب الثاني من الأحكام الشرعية
فقد جاءت على شكل قواعد وأصول ومبادئ عامة فيها مجال لاجتهاد المجتهدين، وفي ذلك غاية التكريم للعقل الذي ميز الله به الإنسان ودعا إلى استخدامه في إطار العقيدة السليمة والقيم الإسلامية الأصيلة التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان.
ولكي يكون الاجتهاد أصيلا، لا تعبث به الأهواء والغايات، فإنه ينبغي ألا يتعرض له ويمارسه إلا القادرون عليه، وهم أولئك الذين توفرت فيهم شروط الأهلية لمثل هذا العمل، وهي أحكام تتعلق بقضايا تختلف تطبيقاتها من وقت لآخر ومن جيل إلى جيل، ويحتاج البشر إلى التفكير في الوصول إلى ما يلائم حياتهم في كل زمان ومكان وهذه المبادئ العامة مثل:
أ – الشورى في الحكم:
فقد قال تعالى: “وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ” (الشورى:38)، وقوله تعالى: “وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ” (آل عمران:159) وفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – في منزله في غزوة بدر وسؤاله لأصحابه وقول الحباب بن المنذر لما نزل الرسول – صلى الله عليه وسلم – ببدر: أهذا منزل أنزلك الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بل هي المشورة والحرب والمكيدة، فأشار الحباب بن المنذر على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالمنزل، فرحل ونزل على رأي أصحابه في بدر وكذا الحال في أسرى بدر فإنه – صلى الله عليه وسلم – استشار أصحابه فيهم كما استشار أصحابه في كثير من أمور الحرب والسلم مثل غزوة الأحزاب وغيرها فكان مبدأ الشورى إسلاميا يلزم الأخذ به للنصوص الشرعية فيه وعمل الرسول – صلى الله عليه وسلم – به مع أصحابه ولكن الناس يجتهدون في الطريقة التي تتحقق بها طريقة الشورى وصيغتها وأساليبها وتنظيماتها.
ب – العدالة:
التي قررها الإسلام في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مثل قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا” (النساء:135).
وقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ” (المائدة:8).
فهذا المبدأ مبدأ شرعي عظيم به تتحقق مصالح الخلق وتنتظم الحياة، وتنفيذ هذا المبدأ واجب ولكن طرائق تنظيمات الجهات التي تقوم على تحقيق العدل قد تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى غيره وفي ذلك متسع، وعلى المجتهدين أن يبذلوا ما في وسعهم للوصول إلى تحقيق العدل بين الناس وفق شريعة الله وعلى هديه.
جـ- المساواة:
وهي مبدأ من المبادئ الإسلامية التي قررها الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وكانت حياة الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه أصدق تطبيق لهذا المبدأ العظيم، فإن الحاكم هو الله في كل شأن من شئون الحياة، والخلق كله أمام حكم الله سواء، لا فرق بين كبير وصغير ولا بين رئيس ومرءوس، ولا بين قريب أو بعيد، فالكل أمام الشريعة سواء، الحكم في كل شأن من شئونهم لله وحده، والعلماء ورثة الأنبياء وهم أولى الناس بالخشية من الله وإنفاذ حكمه على الوجه الذي يرضيه ومجالات هذه المساواة وطريقة تحقيقها، وإن اختلف الناس فيها فإنه مبدأ صالح لكل زمان ومكان ويتسع لكل تطور وتقدم ويواجه به كل الظروف وتحقيقه هدف من أهداف الشريعة.
وقد قال تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” (الحجرات:13).
وقال – صلى الله عليه وسلم (كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) مسند أحمد بن حنبل.
د- منع الضرر:
في جميع أشكاله وصوره عن الناس، وهذا الضرر يتصور وجوده في كل باب من أبواب المعاملات والتعامل بين الناس، وهي قاعدة عظيمة النفع وكبيرة الفائدة، فلا يجوز للإنسان أن يلحق الضرر بنفسه ولا بغيره، كما لا يجوز أن يقابل الضرر بفعل ما يضر بغيره، وقد جاء منع الضرر في أبواب متعددة من الدين ؛ فجاء في باب الرضاعة كقوله تعالى: “لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ” (البقرة:233) وجاء قوله تعالى بعد ذكر الأنصباء في المواريث “غَيْرَ مُضَارٍّ” (النساء:12).
وقال – صلى الله عليه وسلم – (لا ضرر ولا ضرار) سنن ابن ماجه. وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة مسائل متعددة وأحكاما كثيرة.
وهذه الأحكام الأربعة الآنفة الذكر إن هي إلا أمثلة موجزة للأحكام الشرعية التي جاءت على شكل قواعد ومبادئ عامة، أوردناها للدلالة على نوع الأحكام العامة كما أوردنا مثلها من الأحكام الخاصة، ولا أعتقد أن منصفا يعرف الشريعة الإسلامية ومراميها وأحكامها ثم يبيح لنفسه أن يقول بعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان، أو أن يصيخ لسماع أقوال المستشرقين الحاقدين الذين يريدون عزل هذا الدين عن الحياة وفصل هذه الأمة عن تاريخها وعقيدتها ومعقد عزها ومصدر أمنها وسعادتها.
وما آلت إلى ما آلت في الأجيال المتأخرة إلا بسبب تساهلهم في حمل أعباء هذه الرسالة وتقاعسهم عن القيام بالواجب تجاهها، ولذا فقد حل بها من الضعف والهوان ما ندعو الله أن يرفعه.
ولا شك أن المستقبل لهذا الدين، ولكن متى عمل أتباعه على نصرة دين الله وعملوا على إحياء هذا الميراث وتجلية هذه العقيدة، وقدموا لها كل جهد ونفس وطاقة.
وصدق الله إذ يقول: “وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا” (النور:55).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعداد فريق التحرير بلجنة الدعوة الإلكترونية.
[opic_orginalurl]