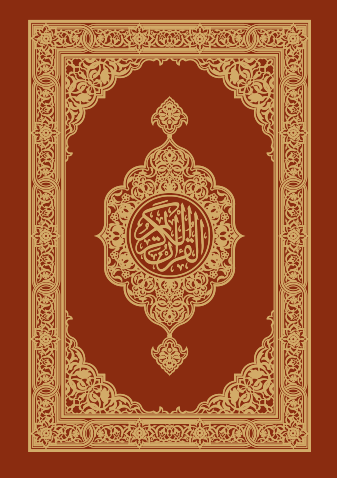عبد العزيز العمري
كانت محاولات الرسول _صلى الله عليه وسلم_ لتغيير مجتمع مكة من الداخل قوية وجادة، وذلك بمحاولته نشر الإسلام وما يرتبط به من شريعة وبناء أدبي وأخلاقي وترابط إنساني، وعلاقات حميمة بين أفراد المجتمع عمومًا؛ بداية بذوي القربى والآباء وأبنائهم، في تلاحم بين الدين والمجتمع والأخلاق. وقد تعنتت قريش ومنعت الدعوة ووقفت في وجهها، وحاربت رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وآذته وأصحابَه، مما دفعه للبحث عن مكان آخر لإقامة المجتمع المسلم المميز بأدبه وأخلاقه وتلاحمه. فكانت الهجرة إلى المدينة المنورة بداية بناء المجتمع الإنساني المسلم الآمن، حيث توافد المهاجرون، وتآلفوا وتحالفوا وتآخوا مع الأنصار، ووجد بينهم ما عرف بنظام الموآخاة الذي أظهر معادن المجتمع الصافي المتآخي.
لقد كانت تزكية النفس وبناء الأخلاق من صميم دعوة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ، جاء في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} (الجمعة: 2). وقد جاءت تشريعات الإسلام المختلفة لتقيم العلاقة الحسنة بين أفراد المجتمع، وبين العائلة الواحدة، فقال _صلى الله عليه وسلم_ : “البِرّ حسْن الخلُق” (رواه الإمام أحمد). وركز الإسلام على تحسين علاقة الأبناء بآبائهم والآباء بأبنائهم، حيث كان الأمر الإلهي ببر الوالدين يعني إصلاح العلاقة بين جيل وآخر، وإشاعة التراحم والتواصل. وقد كان بر الوالدين مقرونًا بطاعة الله تعالى كما قال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (الإسراء:23).
“إن هذه التشريعات والتطبيقات الأخلاقية في عصر الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ومن خلال سيرته، ساهمت في ترابط المجتمع وتلاحمه، ومحبته للرسول _صلى الله عليه وسلم_ ولما شرعه الله عز وجل. ولم يقف تأثيرها عند ذلك العصر، بل امتدت بركتها في الأمة والإنسانية حتى يومنا الحاضر”.
كما أكد القرآن على ذوي القربى وحُسْن العلاقة بهم في قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} (الإسراء: 26). وكان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ على أعلى درجات الخلق كما وصفه الله تعالى في قوله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4)، لذا أمر الله سبحانه الناس بالتأسي به حيث قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب: 21)، وقد قال _صلى الله عليه وسلم_ : “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق” (رواه الإمام أحمد).
كان _صلى الله عليه وسلم_ متواضعًا؛ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب الدعوة، ويكره أن يقوم له الناس، يتواضع مع الكبار والصغار، حتى إن الغريب إذا جاء وجده بين أصحابه غير متميز بجلسة. كان جوادًا يأمر بالجود، كريمًا يأمر بالكرم، عفيفًا يأمر بالعفة والاستغناء عن الناس، شجاعًا حليمًا يأمر بالحلم، رفيقًا يأمر بالرفق، طيب الرائحة نظيفًا يأمر بذلك… ويأتي على رأس ذلك كله حُسْن الأدب مع الله ، ابتداء بالتوحيد والرضا بعبوديته، وحسن الظن به والتوكل عليه، والخوف منه والرضا بما قسم، ورجاء ما عنده، وتقواه وخشيته في الغيب والشهادة، والأنس بذكره وشكره وحسن عبادته… وقد قال _صلى الله عليه وسلم_ مذكرًا بحسن الأدب مع الله: “فالله أحق أن يستحيا منه من الناس” (رواه البخاري). ومن حسن الأدب مع الله الإنابة والاستغفار والرجوع والفرار إليه سبحانه، ومن الآداب التي تربت عليها الأمة الإسلامية، حُسْن الأدب مع رسوله _صلى الله عليه وسلم_ في حياته وبعد مماته.
وقد أمر القرآن أصحاب النبي _صلى الله عليه وسلم_ باتباع أمره وعدم معصيته فقال: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (النور: 63).
كان _صلى الله عليه وسلم_ زاهدًا في الدنيا ويأمر بذلك، اتصف بأعلى الصفات التي تحث على النظافة واحترام شعور الآخرين في مأكله ومشربه وملبسه وشعره ومظهره… وكان يأمر بإشاعة المحبة والسلام بين الناس، قال _صلى الله عليه وسلم_ : “ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم منّي مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقًا الموطأون أكنافًا الذين يألفون ويُؤلفون” (رواه البخاري).
كما كان _صلى الله عليه وسلم_ يأمر بالرفق وهو من أسباب الألفة في الأسرة والمجتمع فيقول: “إن الله يحب الرفق في الأمر كله” (رواه البخاري)، وقد طبّق الرسول _صلى الله عليه وسلم_ الرفق واللين مع الصحابة كما قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (آل عمران: 159)، ومع الرفق واللين كانت محبة النبي _صلى الله عليه وسلم_ للأمة وحرصه عليهم: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (التوبة: 128).
كان _صلى الله عليه وسلم_ مثال الرحمة والعطاء وحسن الخلق، خبرته خديجة رضي الله عنها وهدأت من روعه بعد نزول الوحي عليه، مذكرة بأخلاقه العالية: “كلا والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرَّحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقرئ الضيف، وتعين على نوائب الدهر” (رواه البخاري)، وفي ذلك تأكيد للأمة جمعاء: إن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء. ولما دخل _صلى الله عليه وسلم_ مكة فاتحًا، كان متواضعًا مطأطأً رأسه بلا فخر ولا خيلاء. وكان يقف مع المرأة الضعيفة والصبي، يسمع إليهم ويحدثهم ويقضي حوائجهم؛ ولعل حديث أنس رضي الله عنه يشرح ذلك في قوله: كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، قال: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه أكاف من ليف. وكان لا يأنف أن يُردف معه رجلاً آخر أو صبيًا، فكان كثيرًا ما يردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، ويردف بعض نسائه أحيانًا، وقد قال _صلى الله عليه وسلم_ : “إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد” (رواه ابن ماجه).
ويعمل _صلى الله عليه وسلم_ مع أصحابه في السفر فيحتطب ويقوم بجزء من العمل كغيره من الناس. وقد شارك في بناء مسجده، كما شارك أهله في أعمالهم المنزلية، ويكون في مهنة أهله.
وكان _صلى الله عليه وسلم_ يدعو إلى الاعتدال في التوفيق بين الدنيا والآخرة، وأن لا تكون الدنيا وزينتها همّ الإنسان الأول. ولقد كان _صلى الله عليه وسلم_ حريصًا على معرفة الصحابة لحبه لهم، ولذلك حدّث معاذ بن جبل رضي الله عنه يومًا فقال: “يا معاذ والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك” (رواه البخاري)، كما كان _صلى الله عليه وسلم_ يحث على كل ما يشيع المحبة بين الناس، كالزيارة والهدية، والابتسامة التي قال عنها: “وتبسمك في وجه أخيك صدقة” (رواه الترمذي)، وعلّمهم أن يحيي بعضهم بعضًا بالأفضل.
كما منع القرآن الكريم تميّز الناس بعضهم على بعض، وذكرهم بأصلهم الواحد، وحرّم أن يسخر بعضهم من بعض في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ} (الحجرات: 11)، وأكد على أخوة المؤمنين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات: 10)، وأوجب الإصلاح بينهم في حال النزاع والوقوف ضد الباغي والاستمرار في الإصلاح في قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا} (الحجرات: 9).
كما نهى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عن الغيبة، وعن احتقار بعضهم بعضًا: “بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم” (رواه الترمذي)، وأمر الله بالعفو والصفح عن الناس في قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (الشورى: 40). كل هذه المساواة وتقدير الآخرين، والإصلاح بين المتنازعين، من أجل بناء مجتمع إسلامي أخلاقي متحد ومترابط.
وقد أمر الله رسوله _صلى الله عليه وسلم_ بالرحمة وأوصى بها، وأمر الناس بالتواصي بها، وقد قال تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ} (البلد: 17)، كما قال _صلى الله عليه وسلم_ : “إنما يرحم الله من عباده الرحماء” (رواه البخاري)، وأكد _صلى الله عليه وسلم_ على التراحم العام بين المسلمين وأن يسود المجتمع: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى” (رواه مسلم).
تعد الصلاة من أهمّ العبادات عند رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ، ومع ذلك فقد كان يتجوز فيها رحمة بالأطفال؛ فقد روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: “إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه” (رواه البخاري).
وكان _صلى الله عليه وسلم_ رحيمًا بالرقيق والموالي، حيث جعل عتقهم من أعظم القربات ومن أبواب الكفارات المختلفة، كما ضيّق الإسلام أبواب الرق بعد أن كانت مفتوحة في كل الشرائع والنظم زمن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، إذ أوصى بهم _صلى الله عليه وسلم_ خيرًا بقوله: “إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي” (رواه الإمام أحمد).
إن هذا التراحم والآداب الإنسانية لم تقف عند المسلم والإنسان فقط، بل تعدتها تشريعات الإسلام إلى الحيوان ورحمته وإطعامه وعدم تعذيبه وقتله بلا رحمة وبلا فائدة، قال _صلى الله عليه وسلم_ : “دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض” (رواه البخاري).
كل هذه التعليمات في حقوق الحيوان سبق الإسلام بها العالم الحديث بقرون متعددة، وهي من رحمة الله التي شرعها لعباده المؤمنين به، المقتدين بهديه، ليكونوا رحمة لكل كائن حي، فما بالك بالإنسان.
وقد أكد الإسلام على مساعدة الناس والوقوف مع المحتاجين منهم، ومنع الأذى عن بقية الناس رجالاً ونساءً، وأكد القرآن على حسن التعامل مع الجار والإحسان إليه، كما قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (النساء: 36)، كما قال _صلى الله عليه وسلم_ : “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره” (رواه البخاري)، ولم يتوقف الأمر على المسلمين، بل تعداه إلى غيرهم في أمر واضح وصريح في حسن التعامل معهم إن كانوا مسالمين في قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} (الممتحنة: 8). وقد أمر _صلى الله عليه وسلم_ بالإحسان إلى أسرى بدر وغيرهم من المشركين، فكان المسلمون يطعمونهم مما يأكلون، ويحسنون التعامل معهم، مما أثر فيهم ودفعهم إلى الإسلام بعد ذلك.
كما كان الوفاء بالعهد من أهم أخلاق النبي _صلى الله عليه وسلم_ والمسلمون عمومًا، طبقها الرسول في حياته مع أصدقائه ومع أعدائه. كما كان أداء الأمانة من أساسيات الأخلاق التي بني عليها الإسلام، وكان _صلى الله عليه وسلم_ مضرب المثل في قريش قبل البعثة وبعدها، حتى إنهم كانوا يسمّونه “الصادق الأمين”، وكان الصدْق سلوكه وخلقه، وصفه الله به في قوله: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (الزمر: 33).
أما في مجال الأخلاق الاجتماعية الأسرية، فقد اعتنى الإسلام ببنائها آخذًا في الاعتبار احتمالات الخلاف وتشابك العلاقات، ولذلك جاءت الشريعة وتطبيقاتها في مجال الأحوال الشخصية والشرائع الأسرية، بما في ذلك علاقات الزواج والطلاق وما يصحبها من مُشاحة ونفقة ومتاع وحضانة وتربية ورعاية ومسؤولية… وجعل هناك حقوقًا واضحة وحدودًا مرعية من كل جانب، لا يظلم أحد أحدًا، ولا يعتدي أحد على حق أحد.
ومن الواضح لكل ذي لب عاقل، أن هذه التشريعات والتطبيقات الأخلاقية في عصر الرسول _صلى الله عليه وسلم_ ومن خلال سيرته، ساهمت في ترابط المجتمع وتلاحمه، ومحبته للرسول _صلى الله عليه وسلم_ ولما شرعه الله عز وجل. ولم يقف تأثيرها عند ذلك العصر، بل امتدت بركتها في الأمة والإنسانية حتى يومنا الحاضر.
_____________________
* المصدر: مجلة حراء.
[ica_orginalurl]