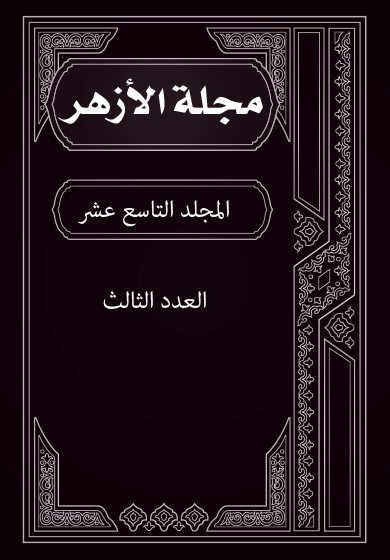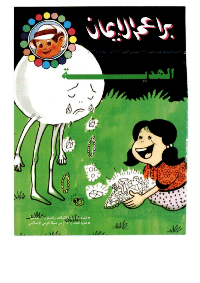د. محمد أبو ليلة
مضمون الشبهة
يزعم بعض المدعين أن تشريع الإسلام ينتهج نظام العنف والغلظة في معاملة غير المسلمين، ويصادر حقوقهم، ويستدلون على ذلك بما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»[1]. ويمنع غير المسلمين من ممارسة حقوقهم الدينية والسياسية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. ويتساءلون: ألا يدل ذلك على إهدار حقوق غير المسلمين والعنف والغلظة في التعامل معهم؟!
وجوه إبطال الشبهة
1) الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس – على اختلاف معتقداتهم – وقد أسس القرآن لهذه السماحة بمبادئ متعددة.
2) دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم – قديما وحديثا – يؤكدان على سماحة الإسلام وإنسانيته، والواقع الفعلي للصحابة والتابعين وقادة المسلمين خير شاهد على هذه السماحة.
3) رد التحية لغير المسلمين بـ “عليكم السلام” ممنوعة إذا تحقق أنه قال “السام عليكم” أو شك فيما قال، وأما إذا تحقق من قوله: “السلام عليكم” فمن باب العدل والإحسان التحية بمثلها، أو بأحسن منها، وعدم إلقاء السلام عليهم من قبيل أنها تحية من خصائص أهل الإسلام؛ فلا تقال لغيرهم.
4) بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وأوضاع المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، يتبين لنا الفروق الشاسعة بين سماحة الإسلام والسماحة الوهمية التي يدعيها أنصار الحضارات الحديثة.
التفصيل:
أولا. الإسلام دين عالمي يدعو إلى التسامح:
يهدف الإسلام إلى التعايش الإيجابي بين البشر جميعا، في جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس، بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم؛ فالجميع ينحدرون من نفس واحدة.
وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى؛ نظرا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوما بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب، حتى أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة.
والإسلام دين يسعى من خلال مبادئه وتعاليمه إلى تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات، فقد جعل الله الناس جميعا خلفاء في الأرض التي نعيش فوقها، وجعلهم شركاء في المسئولية عنها، ومسئولين عن عمارتها ماديا ومعنويا كما يقول القرآن الكريم: )هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها( (هود: 61)، أي: طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها، ومن أجل ذلك ميز الله الإنسان بالعقل وسلحه بالعلم؛ حتى يكون قادرا على أداء مهمته وتحمل مسئولياته في هذه الحياة.
ولهذا يوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنساني الذي يعد أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان.
ومن هنا فإن على الإنسان أن يستخدم عقله الاستخدام الأمثل، وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من الإنسان أن يمارس حريته التي منحها الله له، والتي هي شرط ضروري لتحمل المسئولية، فالله – عز وجل – لا يرضى لعباده الطاعة الآلية التي تجعل الإنسان عاجزا عن العمل الحر المسئول، فعلى الإنسان إذن أن يحرص على حريته، وألا يبددها فيما يعود عليه وعلى الآخرين بالضرر.
ومن شأن الممارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء على وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لممارسة حريتهم أيضا؛ لأن لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان لنفسه، وهذا يعني أن العلاقة الإنسانية بين أفراد البشر هي علاقة موجودات حرة يتنازل كل منهم عن قدر من حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع، وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا المجتمع الإنساني المنشود لن يتحقق على النحو الصحيح إلا إذا ساد التسامح بين أفراده، بمعنى أن يحب كل فرد للآخرين ما يحب لنفسه[2].
التأسيس القرآني للسماحة الإسلامية
والسماحة الإسلامية عطاء بلا حدود، فليست مجرد كلمة تقال أو شعار يرفع أو صياغة نظرية مجردة، كما أنها ليست مجرد فضيلة إنسانية يتحكم حاكم بمنحها لمن يشاء، أو منعها عمن يشاء، وإنما هي دين مقدس، ووحي سماوي، وبيان نبوي عن هذا الوحي، ومن ثم فالسماحة ثمرة الدين الخالد، والشريعة الخاتمة، وهي منهاج المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا غرابة في أن يعلي الإسلام قيمة التسامح، ويؤسس القرآن لهذه القيمة، وعن ذلك يذكر المفكر الإسلامي د. محمد عمارة أن القرآن بدأ فأسس السماحة الإسلامية على قاعدة الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود، ففي هذا الوجود هناك “حق” هو الله عز وجل، و”خلق” يشمل جميع عوالم المخلوقات وهناك “واجب الوجود” وهناك “الوجود المخلوق” لـ “واجب الوجود”.
وفي هذا التصور الفلسفي الإسلامي تكون “الواحدية والأحدية” فقط للحق، لله – عز وجل – واجب الوجود؛ بينما تقوم كل عوالم الخلق المادية والنباتية والحيوانية والإنسانية والفكرية، أي: كل ما عدا الذات الإلهية، على التعدد، والتنوع والتمايز والاختلاف باعتبار هذا التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف قانونا إلهيا تكوينيا، وسنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل، الأمر الذي يستلزم – لبقاء هذه السنة الكونية قائمة ومطردة – تعايش كل الفرقاء المختلفين، وتعارف جميع عوالم الخلق، أي: سيادة خلق السماحة في العلاقات بين الأمم والشعوب، والثقافات والحضارات، والمذاهب والفلسفات، والشرائع والملل والديانات، والأجناس والألوان، واللغات، والقوميات، فبدون السماحة يحل “الصراع” الذي ينهي ويلغي ويفني التعددية محل التعايش والتعارف، الأمر الذي يصادم سنة الله – عز وجل – في الاختلاف والتنوع بكل عوالم المخلوقات.
على هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود أقام الإسلام مذهبه في السماحة، باعتبارها فريضة دينية، وضرورة حياتية، لتكون جميع عوالم الخلق على هذا النحو الذي أراده الله.
وفي التأسيس القرآني لهذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود نقرأ في آيات الذكر الحكيم: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)( (الحجرات)، فالإنسانية تتنوع إلى شعوب وقبائل، والسماحة هي السبيل إلى تعايشها وتعارفها في الإطار الإنساني العام.
وهذه الأمم والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها وألوانها وألسنتها ولغاتها ومن ثم قومياتها كآية من آيات الله، والسماحة هي السبيل لتعايش الأجناس والقوميات في إطار الحضارات الجامعة لشعوب هذه القوميات.
وهذه الأمم والشعوب تتنوع دياناتها وتختلف مللها وشرائعها، وتتعدد مناهجها وثقافاتها وحضاراتها، باعتبار ذلك سنة من سنن الابتلاء والاختبار الإلهي لهذه الأمم والشعوب، وحتى يكون هناك تدافع وتسابق بينها جميعا على طريق الحق وفي ميادين الخيرات، قال عز وجل: )لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (48)( (المائدة)، وقال عز وجل: )ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (118) إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين (119)( (هود).
والمفسرون لهذه الآيات يقولون عن هذا الاختلاف: إنه علة الخلق، وأن المعنى: وللاختلاف خلقهم، وبدون السماحة يستحيل تعايش هذه التعددية، التي هي علة الوجود، وسر التسابق في عمران هذا الوجود.
وانطلاقا من هذا الموقف القرآني الذي جعل هذا التنوع سنة إلهية وقانونا كونيا، كان العدل الذي هو معيار النظرة القرآنية وروح الحضارة الإسلامية، وهو أساس السماحة الإسلامية في التعامل مع كل الفرقاء المختلفين، ففي التأسيس لهذه السماحة العادلة يطلب القرآن الكريم منا العدل مع النفس والذات.. وذلك في قول الله عز وجل: )إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (97)( (النساء).
ويطلب منا العدل مع الآخر في قوله عز وجل: )فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم( (الشورى: 15)، وقوله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا( (النساء: 135)، وقوله عز وجل: )وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون (152)( (الأنعام)، بل ويوجب الله – عز وجل – علينا العدل حتى مع من نكره فقال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (8)( (المائدة)، وقال عز وجل: )ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا( (المائدة: 2)، بل ويوجب القرآن علينا العدل حتى مع من يعتدي علينا ويقاتلنا، قال عز وجل: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( (البقرة: 194).
إن الإسلام دين ودولة، وأمة وجماعة، ونظام واجتماع، ليس الدين الذي يخلو من السلطة التي تعاقب المعتدين وتدين الجناة، ومع ذلك فإن سماحته تدعو إلى العدل في رد العدوان، وإنزال العقاب والجزاء، بل وتفضل الصبر الجميل على رد العقاب، قال عز وجل: )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (125) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين (126) واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون (127) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (128)( (النحل).
كذلك يوجب الإسلام علينا العدل في النظر إلى المخالفين لنا في الاعتقاد الذي هو سنة إلهية، ونحن مدعوون وفق منهاج القرآن ألا نضع كل المخالفين لنا في سلة واحدة، وألا نسلك طريق التعميم الذي يظلم عندما يغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء المخالفين ومواقفهم، وإقامة لهذا المنهاج رأينا القرآن الكريم لا يعمم أبدا في حديثه عن أهل الكتاب وأصحاب العقائد والديانات، وإنما يميز بين مذاهبهم وطوائفهم، فيقول عز وجل: )من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون (113)( (آل عمران)، وقال عز وجل: )وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب (199)( (آل عمران)، وقال عز وجل: )ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (75)( (آل عمران).
فالقاعدة القرآنية الحاكمة في التمييز العادل بين الفرقاء المخالفين لنا هي أنهم: )ليسوا سواء(، صنع القرآن ذلك عندما ميز فرقاء اليهود فلم يعمم في الحكم على مجموعهم، وصنع ذلك أيضا في الحديث عن النصارى عندما ميز بين من هم أقرب مودة للمسلمين، قال عز وجل: )ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون (82)( (المائدة).
لقد صنعوا ذلك وهم نصارى ولصنيعهم هذا لم يحبط الإسلام عملهم، ولم يضعهم في سلة الأخرين – من النصارى – الذين أشركوا المسيح مع الله في الألوهية، والربوبية والخلق، فكفروا بالوحدانية التي جاء بها السيد المسيح – عليه السلام – عندما قالوا: “إن المسيح هو خالق كل الأشياء، وإن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء عما كان فهو الأول والآخر”: )لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار (72)( (المائدة)، فلم يسو القرآن الكريم بين هؤلاء الفرقاء من النصارى.
والمنطق الإسلامي لهذا التمييز المؤسس للعدل والسماحة هو العدل الإلهي الذي هو فريضة إسلامية جامعة؛ فالله – عز وجل – رب العالمين جميعا: )الحمد لله رب العالمين (2)( (الفاتحة)، وليس رب شعب بعينه دون سائر الشعوب، والتكريم الإلهي شامل لكل بني آدم: )ولقد كرمنا بني آدم( (الإسراء: 70)، ومعيار التفاضل بين البشر المكرمين هو التقوى: )إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (13)( (الحجرات)، )ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا (123)( (النساء).
وليس معيار التفاضل لونا أو جنسا أو سلالة أو أية صفة من الصفات اللصيقة التي تستعصي على الاختيار والكسب والتغيير. ولذلك قال الله عز وجل: )إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا (30)( (الكهف)، )إن الله لا يضيع أجر المحسنين (120)( (التوبة)، )إنا لا نضيع أجر المصلحين (170)( (الأعراف)، )فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)( (الزلزلة)، )إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62)( (البقرة).
وتأسيسا على هذا العدل الإلهي، أسس القرآن الكريم سماحة الإسلام في النظر إلى مواريث النبوات والرسالات التي سبقت رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؛ فالقرآن الكريم لم يأت نافيا لما سبقه من كتب، وإنما جاء مصدقا لها ومهيمنا عليها، أي مشتملا على ثوابتها ومستوعبا لأركان العقائد فيها، ومضيفا إليها، ومصححا لما طرأ عليها؛ فعلى حين كانت اليهودية تنكر النصرانية، وكانت النصرانية تنكر اليهودية، قال عز وجل: )وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم( (البقرة: 113)، جاء القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية السابقة: )وهو الحق مصدقا لما معهم( (البقرة: 91)، ومؤكدا على أن ما أصاب بعض مواضع هذه الكتب لم يمح ما أودعه الله فيها من هدى ونور: )الله لا إله إلا هو الحي القيوم (2) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل (3) من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان( (آل عمران)، فالتوراة: )فيها هدى ونور( (المائدة: 44)، وكذلك الإنجيل: )وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور( (المائدة: 46)، وطلب الإسلام من أهل الكتاب تحكيم كتبهم، ولم يطلب منهم نبذها: )وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه( (المائدة: 47)، )وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله( (المائدة: 43).
ذلك هو التأسيس القرآني للسماحة الإسلامية على الرؤية الفلسفية للكون والوجود، المحكومة بسنة التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف كقانون تكويني أزلي أبدي؛ الأمر الذي يجعل السماحة ضرورة لازمة، وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع والاختلاف عاملا في عوالم المخلوقات والفلسفات والشرائع والديانات والثقافات والقوميات والحضارات[3].
مبادئ التسامح في الإسلام
وعن مبادئ هذا التسامح يعرض لنا د. شكور الله باشا زاده أهم هذه المبادئ محتكما في عرضه واستقاء معلوماته إلى النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، ومعضدا ببعض مؤلفات المستشرقين المشهورين مع عقد مقارنات مع الديانات الأخرى فيقول: إن الإسلام هو دين التسامح وإذا احتكمنا بالنصوص القرآنية، فيمكننا صياغة المبادئ الآتية للتسامح في الإسلام.
1. اختلاف الناس في عقائدهم حكمة إلهية: قال عز وجل: )ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (118)( (هود)، وقال عز وجل: )ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا( (يونس: 99). ومعنى الآيتين المباركتين أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان حريصا على إيمان قومه، شديد الاهتمام به، فنزلت الآيتان لبيان أن إيمان الملجأ[4] غير نافع، وبين – عز وجل – أن ذلك لو كان ينفع لأكره أهل الأرض عليه.
2. الاقتناع هو أساس الإيمان: قال عز وجل: )لا إكراه في الدين( (البقرة: 256). ويفسر العلامة الراغب الأصفهاني الإكراه بمعنى حمل الإنسان على ما يكرهه ويكتب في تفسير الآية: فقد قيل في ذلك أقوال:
الأول: كان ذلك في ابتداء الإسلام، فإنه كان يعرض على الإنسان الإسلام، فإن أجاب وإلا ترك.
والثاني: أن ذلك في أهل الكتاب فإنهم إن أدوا الجزية والتزموا الشرائط تركوا.
والثالث: أنه لا حكم لمن أكره على دين باطل فاعترف به ودخل فيه. والرابع: لا اعتداد في الآخرة، بما يفعل الإنسان في الدنيا من الطاعة كرها. والخامس: لا يحمل الإنسان على أمر مكروه في الحقيقة مما يكلفهم الله، بل يحملون على نعيم الأبد. والسادس: أن الدين الجزاء. معناه: أن الله ليس بمكره على الجزاء، بل يفعل ما يشاء بمن يشاء كما يشاء[5].
ويقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: أي لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر، ولكن على التمكين والاختيار، أي: لو شاء لقسرهم على الإيمان لكنه لم يفعل وبني الأمر على الاختيار.
أما ابن كثير فيفسر هذه الآية بمعنى: “أيها المسلمون، لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحدا على الدخول فيه.
وفي القرآن الكريم آيات كثيرة ناهية عن حمل الإنسان على الاعتقاد بإكراه، قال عز وجل: )أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (99)( (يونس)، وقال – عز وجل – أيضا: )وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( (الكهف: 29).
- ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة: قال سبحانه وتعالى: )ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن )( (النحل:125)، وقال عز وجل: )( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن( (العنكبوت:46). والمقصود في تلك الآيات أن الحوار ينبغي أن يكون على أساس الحكمة لإبراز كلمة سواء بين المسلمين وبين أهل الكتاب؛ إذ قال سبحانه وتعالى: )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله( (آل عمران: 64).
هذا وقد دل الإسلام على الملتقى أو النقطة المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب وهي الحنيفية الإبراهيمية – تلك الحركة الدينية التوحيدية القوية الواسعة الانتشار – التي سبقت الديانات السماوية الثلاث، ومهدت الطريق لها وبقيت جذورها راسخة في العقلية التوحيدية العربية إلى أن جاء الرسول – صلى الله عليه وسلم – فسار على ذات النهج التوحيدي المستقيم لإبراهيم عليه السلام: )واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا (125)( (النساء).
وإذا لم يتمكن المسلمون وأهل الكتاب من إبراز كلمة سواء بينهم فهناك مبدأ أخير من مبادئ التسامح التي يقدمها الإسلام وهو:
4. لكل فرد حق في أن يبقى على اعتقاده: قال عز وجل: )لكم دينكم ولي دين (6)( (الكافرون)، وبيان موقف القرآن الكريم من اليهودية والنصرانية، دليل آخر على سماحة الإسلام.
مبدئيا يعلن الإسلام أنه دين الله الحق، لكنه مع ذلك لا يحدد حدود الاعتقاد بحد ذاته فقط، بل يعترف بالتعددية، ولا يوجد في القرآن الكريم آية اتهام لنبي أو لكتاب، ولا تعصب ضد الصابئة واليهود والنصرانيين.
ونرى أن الإسلام قد اعترف بسماوية اليهودية والنصرانية، وأن موسى وعيسى – عليهما السلام – نبيان مرسلان، وأكد القرآن الكريم أن التوراة والإنجيل وحيان من الله، ويتجلى ذلك في قوله عز وجل: )إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور( (المائدة: 44)، وقوله عز وجل: )وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور( (المائدة: 46)، وقوله عز وجل: )قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (136)( (البقرة).
وكما حفل القرآن الكريم بدعوة المسلمين إلى التسامح والتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى، حفلت سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بحض المسلمين كذلك على السماحة والرفق بأهل الملل الأخرى؛ فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كتب إلى معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قائلا: «من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ومن أقام على يهودية أو نصرانية فلا يفتن عنها…»[6]. وقد أقر النبي – صلى الله عليه وسلم – الحرية الدينية في ميثاق المدينة، حيث أكد – صلى الله عليه وسلم – أن لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم. وعندما صالح النبي – صلى الله عليه وسلم – نصارى نجران أباح لقبيلة تغلب المسيحية أن يبقوا في مسيحيتهم.
هذا، وتربت أجيال من المسلمين على أوامر القرآن الكريم ونواهيه، وتوجيهات نبيهم – صلى الله عليه وسلم – فيما يخص التسامح، ولو ألقينا النظر إلى صفحات التاريخ يمكننا أن نلمس كثيرا من المؤشرات عن التسامح الإسلامي.
لما بدأت الفتوحات الإسلامية وتم فتح كثير من الأقاليم في عهد الخلافة الراشدة مثل العراق، والشام، ومصر، رحبت جماعات كثيرة من اليهود والنصارى من سكان هذه الأقاليم بالفتح الإسلامي؛ لأنه حررهم من ظلم الساسانيين والرومانيين ومتعهم بالحرية الدينية.
وإذا قرنا هذه المؤشرات بالمؤشرات من تاريخ أوربا في القرون الوسطى رأينا نماذج كثيرة من قلة التسامح عند الأوربيين حينذاك، ولقد قام أنصار الكنيسة الأرثوذكسية بالتضييق والتشديد على بعض المذاهب غير النصرانية، وخاصة على مذهب أرسطو الفلسفي، وأغلقت مدرسة أصحاب أرسطو بأمر من الإمبراطور زينون سنة 489م. وأغلق بعده الإمبراطور البيزنطي جتنيان سنة 529م، في أثينا المدرسة الفلسفية الأخيرة وهي مدرسة الأفلاطونية الجديدة.
واضطر الفلاسفة من أتباع الأفلاطونية الجديدة، وأصحاب أرسطو المنتمون إلى الدوائر النسطورية إلى اللجوء إلى إيران الساسانية، وتأسست هناك مدرستان فلسفيتان في نيسيبين وهندشابور.
وعندما كانت أوربا النصرانية تواصل معاقبتها لأصحاب الآراء الأخرى، والكنيسة تعاقب مدرسة أرسطو نرى في العالم الإسلامي مشهدا آخر: تترجم مؤلفات أفلاطون وأرسطو من السريانية إلى العربية في “دار الحكمة” التي أسسها الخليفة المأمون في القرن التاسع في بغداد. وحاول المأمون إعلان حرية الاعتقاد التامة لأهل الذمة عام 200 هـ/ 810م؛ إذ كان يقول: كل جماعة تعتقد دينا وتتألف من عشرة أنفار لها حق أن تختار لها زعيما روحانيا يعترف به الخليفة.
صحيح أنه إلى جانب صفحات التسامح والمودة، كانت هناك صفحات التعصب أيضا في تاريخ المجتمعات الإسلامية، ويمكننا أن نقف على سبيل المثال عند طلب تمييز أهل الذمة بملابس خاصة بغرض تمييزهم عن المسلمين، أو منعهم من الركوب على السرج، وقصرهم أن يركبوا البرذعة بغرض إذلالهم، لكنه كما يكتب د. محمد عمارة كان الدين بريئا من كل ذلك، فمسئولية الطائفية والشقاق الديني لم تكن أبدا مسئولية الإسلام، ولا مسئولية أي دين من الأديان، إنما كانت مسئولية الدولة، التي ابتعدت عن روح الإسلام، ومسئولية رؤساء الأديان، الذين جعلوا مهمتهم التبرير والتنظير لتجاوزات الدولة لروح الإسلام[7].
إن الإسلام هو دين التسامح، وأن مبادئه كلها داعية إلى ذلك ودافعة له.
ثانيا. دستور الإسلام يؤكد سماحة الإسلام وإنسانيته مع أهل الديانات الأخرى:
إن الإسلام هو دين التسامح، وإن مبادئه كلها داعية إلى ذلك التسامح ودافعة إليه، وإن اتهام الإسلام بعدم التسامح، اتهام لا علاقة له بالإسلام.
ويؤكد على هذا المعنى د. عمر عبد العزيز قريشي إذ يقول: “إن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة وفكرة “أيديولوجية” خاصة، منها تنبثق نظمه و أحكامه وآدابه وأخلاقه، وهذه العقيدة أو الفكرة “الأيديولوجية” هي الإسلام، وهذا هو معنى تسميته “المجتمع الإسلامي” فهو مجتمع اتخذ الإسلام منهاجا لحياته ودستورا لحكمه، ومصدرا لتشريعه وتوجيهه في كل شئون الحياة وعلاقاتها، فردية واجتماعية، مادية ومعنوية، محلية ودولية.
ولكن ليس معنى هذا أن المجتمع المسلم يحكم بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في داخله وهي تدين بدين آخر غير الإسلام.
كلا، إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين مواطنيهم من غير المسلمين على أسس وطيدة من التسامح والعدالة والبر والرحمة، وهي أسس لم تعرفها البشرية قبل الإسلام، وقد عاشت قرونا بعد الإسلام، وهي تقاسي الويل من فقدانها، ولا تزال إلى اليوم، تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة، فلا تكاد تصل إليها في مجتمع ما، وفي وقت ما، إلا غلب عليها الهوى والعصبية، وضيق الأفق والأنانية، وجرتها إلى صراع دام مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو اللون.
دستور العلاقة مع غير المسلمين
أساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله عز وجل: )لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون (9)( (الممتحنة)، فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا، ولو كانوا كفارا بدينه، ما لم يقفوا في وجهه ويحاربوا دعاته، ويضطهدوا أهله.
ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع، والمراد بأهل الكتاب: من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوي، وإن حرف وبدل بعد، كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة والإنجيل.
فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى، حتى لا يوغر المراء الصدور، ويوقد الجدل نار العصبية والبغضاء في القلوب، قال عز وجل: )ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون (46)( (العنكبوت).
ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب، والأكل من ذبائحهم، كما أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات، مع ما قرره القرآن من قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة في قوله عز وجل: )ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة( (الروم: 21)، وهذا في الواقع تسامح كبير من الإسلام، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته، وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة، وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين، قال عز وجل: )اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان( (المائدة: 5).
وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم منزلة ومعاملة خاصة، وهؤلاء هم “أهل الذمة”. فما حقيقتهم؟
أهل الذمة: كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول، وعهد جماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام، وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين، فهم في أمان المسلمين وضمانهم، بناء على “عقد الذمة” فهذه الذمة تعطي أهلها – من غير المسلمين – ما يشبه في عصرنا “الجنسية” السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها، فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.
فالذمي على هذا الأساس من “أهل دار الإسلام” – كما يعبر الفقهاء – أو من حاملي “الجنسية الإسلامية” – كما يعبر المعاصرون – وعقد الذمة عقد مؤبد، يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتها، بشرط بذلهم “الجزية” والتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية، وبهذا يصيرون من أهل “دار الإسلام”.
فهذا العقد ينشئ حقوقا متبادلة لكل من الطرفين: المسلمين وأهل ذمتهم، بإزاء ما عليهم من واجبات.
فما الحقوق التي كفلها الشرع لأهل الذمة، وما واجباتهم؟
القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في “دار الإسلام” أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين، إلا في أمور محددة مستثناة، كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات إلا ما استثني؛ فأول هذه الحقوق هو:
-
حق الحماية:
حق تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي، وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجي، ومن كل ظلم داخلي، حتى ينعموا بالأمان والاستقرار على سبيل التفصيل التالي:
الحماية من الاعتداء الخارجي:
أما الحماية من الاعتداء الخارجي، فيجب لهم ما يجب للمسلمين، وعلى الإمام أو ولي الأمر في المسلمين، بما له من سلطة شرعية، وما لديه من قوة عسكرية، أن يوفر لهم هذه الحماية، ورد في “مطالب أولي النهى” – من كتب الحنابلة -: “يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع من يؤذيهم، وفك أسرهم، ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب، بل كانوا بدارنا، ولو كانوا منفردين ببلد”.
وعلل ذلك بأنهم: “جرت عليهم أحكام الإسلام وتأبد عقدهم، فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين”.
ويؤكد هذا ما نقله الإمام القرافي المالكي في كتابه “الفروق” من قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه “مراتب الإجماع”: “أن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع[8] والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا لمن هو في ذمة الله – عز وجل – وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة”. وحكى في ذلك إجماع الأمة.
وعلق على ذلك القرافي بقوله: “فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال – صونا لمقتضاه عن الضياع – إنه لعظيم”.
ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي، موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما تغلب التتار على الشام، وذهب الشيخ ليكلم “قطلوشاه” في إطلاق الأسرى، فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى، فهم أهل ذمتنا، ولا ندع أسيرا من أهل الذمة، ولا من أهل الملة، فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له.
الحماية من الظلم الداخلي:
وأما الحماية من الظلم الداخلي، فهو أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه، ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان؛ فالله – عز وجل – لا يحب الظالمين ولا يهديهم، بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا، أو يؤخر لهم العقاب مضاعفا في الآخرة.
وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه، وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة والأولى، وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير المسلمين من أهل العهد والذمة.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة»[9].
ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين، بدفع الظلم عن أهل الذمة، وكف الأذى عنهم، والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبلهم.
فقد كان عمر – رضي الله عنه – يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى، فيقولون له: “ما نعلم إلا وفاء”، أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتضي أن كلا من الطرفين وفي بما عليه.
كما قال عمر – رضي الله عنه – في وصيته للخليفة بعده:«وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم»[10]، وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يقول: “إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا”.
وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية صرحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرح بعضهم بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثما.
حماية الدماء والأبدان:
وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم.. فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»[11].
ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث ولكنهم اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟ والصحيح أنه يقتل به.
وكما حمى الإسلام أنفس أهل الذمة من القتل حمى أبدانهم من الضرب والتعذيب، فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم، ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات المالية المقررة عليهم كالجزية والخراج[12]، هذا مع أن الإسلام تشدد كل التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة.
ولم يجز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن يحبسوا تأديبا لهم، بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال شاقة، وفي ذلك يكتب أبو يوسف: أن حكيم بن هشام أحد الصحابة رضي الله عنهم – رأى رجلا – وهو على حمص، يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية، قال: ما هذا؟ سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «إن الله – عز وجل – يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»[13].
وكتب علي – رضي الله عنه – إلى بعض ولاته على الخراج: “إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاء ولا صيفا، ولا رزقا يأكلونه، ولا دابة يعملون عليها، ولا تضربن أحدا منهم سوطا واحدا في درهم، ولا تقمه على رجله في طلب درهم، ولا تبع لأحد منهم عرضا[14]، في شيء من الخراج، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو، فإن أنت خالفت ما أمرتك به، يأخذك الله به دوني، وإن بلغني عنك خلاف ذلك عزلتك”[15]. قال الوالي: إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك[16]! قال: “وإن رجعت كما خرجت”.
حماية الأموال:
ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال، هذا مما اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب، وفي جميع الأقطار، ومختلف العصور.
روى أبو يوسف في “الخراج” ما جاء في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – لأهل نجران: «ولنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أنفسهم وملتهم وأراضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم… وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير…» [17].
وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح – رضي الله عنهما – أن: “امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم، وأكل أموالهم إلا بحلها”.
وعلى هذا استقر عمل المسلمين طوال العصور، فمن سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عزر، وأعيد المال إلى صاحبه، ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه، فإن مطله وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه.
وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه – حسب دينهم – مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين.
فالخمر والخنزير لا يعتبران عند المسلمين مالا متقوما، ومن أتلف لمسلم خمرا أو خنزيرا لا غرامة عليه ولا تأديب، بل هو مثاب مأجور على ذلك؛ لأنه يغير منكرا في دينه، يجب عليه تغييره أو يستحب، حسب استطاعته، ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعها للغير.
أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم، فهما مالان عنده، بل من أنفس الأموال، كما قال فقهاء الحنفية، فمن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهما على مذهب الحنفية.
حماية الأعراض:
ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته، كما يحمي عرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب أو يغتابه أو يذكره بما يكره في نفسه أو نسبه أو خلقه أو خلقه أو غير ذلك مما يتعلق به.
ويبين الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب “الفروق”: “إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقا علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا[18]، وذمتنا وذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيع ذمة الله، وذمة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وذمة دين الإسلام”.
وجاء في “الدر المختار”: “يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم”، ويعلق ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد.
- التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر:
وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في ظل دولته، كفالة المعيشة الملائمة لهم ولمن يعولونه، لأنهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل رعاياها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»[19].
وهذا ما مضت به سنة الراشدين ومن بعدهم؛ ففي عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة بالعراق، وكانوا من النصارى: “وجعلت لهم، أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله”[20].
وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبحضرة عدد كبير من الصحابة، وقد كتب خالد به إلى الصديق ولم ينكر عليه أحد، ومثل هذا يعد إجماعا.
وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام، باعتباره مبدأ عاما يشمل أبناء المجتمع جميعا – مسلمين وغير مسلمين – ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج، فإن دفع الضرر عنه واجب ديني، مسلما كان أو ذميا.
وذكر الإمام النووي في “المنهاج” أن من فروض الكفاية: دفع ضرر المسلمين ككسوة عار، أو إطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال.
ووضح العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في “نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج” أن أهل الذمة كالمسلمين في ذلك، فدفع الضرر عنهم واجب…
- حرية التدين:
ويحمي الإسلام فيما يحميه من حقوق أهل الذمة حق الحرية. وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يجبر على تركه إلى غيره، ولا يضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام، وأساس هذا الحق قوله عز وجل: )لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم (256)( (البقرة)، قوله عز وجل: )أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (99)( (يونس).
قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه.
وسبب نزول الآية كما ذكر المفسرون يبين جانبا من إعجاز هذا الدين، فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة[21]، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، وكان يفعل ذلك نساء الأنصار في الجاهلية، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا[22]، فأنزل الله – عز وجل – هذه الآية: )لا إكراه في الدين(، فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهم، ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صغار، ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك من موجات التعصب والاضطهاد للمخالفين في المذهب، فضلا عن الدين، كما كان في مذهب الدولة الرومانية التي خيرت رعاياها حينا بين التنصر والقتل، فلما تبنت المذهب “الملكاني” أقامت المذابح لكل من لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم.
رغم كل هذا، رفض القرآن الإكراه، بل من هداه الله وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا.
فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تلفظ باللسان أو طقوس تؤدى بالأبدان، بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه.
ولهذا لم يعرف التاريخ شعبا مسلما حاول إجبار أهل الذمة على الإسلام، كما أقر بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهم.
وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله عز وجل: )أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير (39) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز (40)( (الحج).
وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أهل نجران، أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم.
وفي عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إلى أهل إيلياء – القدس – نص على حريتهم الدينية، وحرمة معابدهم وشعائرهم: “بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتها، لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود”[23].
وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين، وحرمة دينهم، فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامية، ولا يحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل، وذلك لما في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي مما قد يؤدي إلى فتنة واضطراب.
على أن من فقهاء المسلمين من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبيع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة – أي إن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحد السيف – إذا أذن لهم إمام المسلمين بذلك، بناء على مصلحة رآها، ما دام الإسلام يقرهم على عقائدهم.
ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين، وذلك منذ عهد مبكر، أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إظهار شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه، نظرا لتكاثر عددهم.
وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين، وتم لهم به النصر والغلبة، أمر لم يعهد في تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به الغربيون أنفسهم.
يقول العالم الفرنسي جوستاف لوبون: “رأينا من آي القرآن أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية، وأنه لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته” وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أوربا المرتابون أو المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب، والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم تثبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا، قال روبرتسن في كتابه “تاريخ شارلكن”: “إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم، تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية”[24].
- حرية العمل والكسب:
لغير المسلمين حرية العمل والكسب، بالتعاقد مع غيرهم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، ومزاولة ما يختارون من المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الاقتصادي، شأنهم في ذلك شأن المسلمين.
فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين، ولم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا، فإنه محرم عليهم كالمسلمين، وقد روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صالح أهل نجران وكتب إليهم: “ألا يأكلوا الربا، فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة، وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوق عليهم”[25].
كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، وفتح الحانات فيها لشرب الخمر وتسهيل تداولها أو إدخالها إلى أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهور، ولو كان ذلك لاستمتاعهم الخاص، سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الفتنة.
وفيما عدا هذه الأمور المحدودة، يتمتع الذميون بتمام حريتهم، في مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة، وهذا ما جرى عليه الأمر ونطق به تاريخ المسلمين في شتى الأزمان، وكادت بعض المهن أن تكون مقصورة عليهم كالصيرفة والصيدلة وغيرها، واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام، وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن كل ضريبة إلا الجزية، وهي ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح وهي مقدار جد زهيد.
قال آدم ميتز: “ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال، وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة، فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع وأطباء، بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم، بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة في الشام مثلا يهودا. على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى. وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة، وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده[26].
- تولي وظائف الدولة:
ولأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين. إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.
فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز أن يخلف النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
وقيادة الجيش ليست عملا مدنيا صرفا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به، ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.
وما عدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة، بخلاف الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: )يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون (118)( (آل عمران).
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار بجواز تقليد الذمي “وزارة التنفيذ”. ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
وهذا بخلاف “وزارة التفويض” التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.
وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، وكان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني، وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين.
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق
لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق، وكفلت لهم كل تلك الحريات، وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي هي أحسن.
ولكن من الذي يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق، وتحقيق هذه الوصايا، وبخاصة أن المخالفة في الدين كثيرا ما تقف حاجزا دون ذلك؟
وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ثم تظل حبرا على ورق، لغلبة الأهواء والعصبيات، التي لم تستطع القوانين أن تنتصر عليها؛ لأن الشعب لا يشعر بقدسيتها، ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخضوع لها والانقياد لحكمها.
أما ضمانات الوفاء بتلك الحقوق في الشريعة الإسلامية فهي كالآتي:
ضمان العقيدة:
أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله وقانون السماء، الذي لا تبديل لكلماته، ولا جور في أحكامه، ولا يتم الإيمان إلا بطاعته، والرضا به. قال عز وجل: )وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (36)( (الأحزاب).
ولهذا يحرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة ووصاياها، ليرضي ربه وينال ثوابه، لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة والمودة، ولا مشاعر العداوة والشنآن، قال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين( (النساء: 135). وقال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (8)( (المائدة).
ضمان المجتمع المسلم:
إن المجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ الشريعة، وتطبيق أحكامها في كل الأمور، ومنها ما يتعلق بغير المسلمين؛ فإذا قصر بعض الناس أو انحرف أو جار أو تعدى، وجد في المجتمع من يرده إلى الحق، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويقف بجانب المظلوم المعتدى عليه، ولو كان مخالفا له في الدين.
قد يوجد هذا كله دون أن يشكو الذمي إلى أحد، وقد يشكو ما وقع عليه من ظلم، فيجد من يسمع لشكواه، وينصفه من ظالمه، مهما يكن مركزه ومكانه في دنيا الناس.
فله أن يشكو إلى الوالي أو الحاكم المحلي، فيجد عنده النصفة والحماية، فإن لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من هو فوقه؛ إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فيجد عنده الضمان والأمان، حتى لو كانت القضية بينه وبين الخليفة نفسه، فإنه يجد الضمان لدى القضاء المستقل العادل، الذي له حق محاكمة أي مدعى عليه، ولو كان أكبر رأس في الدولة “الخليفة”.
وضمان آخر عند الفقهاء، الذين هم حماة الشريعة، وموجهو الرأي العام، وهو ضمان أعم وأشمل يتمثل في “الضمير الإسلامي العام”، الذي صنعته عقيدة الإسلام وتربية الإسلام، وتقاليد الإسلام.
والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع التي تدل على التزام المجتمع الإسلامي بحماية أهل الذمة من كل ظلم يمس حقوقهم المقررة، أو حرماتهم المصونة، أو حرياتهم المكفولة.
فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين على ذمي، فإن والي الإقليم سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه، بمجرد شكواه أو علمه بقضيته من أي طريق.
وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي أحمد بن طولون أحد قواده، لأنه ظلمه وأخذ منه مبلغا من المال بغير حق، فما كان من ابن طولون إلا أن أحضر هذا القائد وأنبه وعزره وأخذ منه المال، ورده إلى النصراني، وقال له: لو ادعيت عليه أضعاف هذا المبلغ لألزمته به، وفتح بابه لكل متظلم من أهل الذمة، ولو كان المشكو من كبار القواد وموظفي الدولة.
وإن كان الظلم واقعا من الوالي نفسه أو من ذويه وحاشيته؛ فإن إمام المسلمين وخليفتهم هو الذي يتولى ردعه ورد الحق إلى أهله، وأشهر الأمثلة على ذلك قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر.
وإذا لم يصل أمر الذمي إلى الخليفة، أو كان الخليفة نفسه على طريقة واليه، فإن الرأي العام الإسلامي الذي يتمثل في فقهاء المسلمين، وفي المتدينين كافة يقف بجوار المظلوم من أهل الذمة ويسانده.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك: موقف الإمام الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنه، عندما أجلى قوما من أهل الذمة من جبل لبنان، لخروج فريق منهم على عامل الخراج. وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة وعصبته، وهو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. فكتب إليه الأوزاعي رسالة طويلة، كان مما قال فيها: “فكيف تأخذ عامة بذنوب خاصة، حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله عز وجل: )ألا تزر وازرة وزر أخرى (38)( (النجم)، وهو أحق ما وقف عنده واقتدي به. وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي يوحى فيها بعدم ظلم الذمي أو تكليفه فوق طاقته؛ حيث يقول: «من ظلم معاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة»[27]. ويبين – صلى الله عيه وسلم – سبب ذلك في رسالته إلى أهل نجران؛ حيث قال: “فإنهم ليسوا بعبيد، فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ذمة”[28].
ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلما وقع على أهل الذمة واستمر طويلا، فقد كان الرأي العام والفقهاء معه دائما ضد الظلمة والمنحرفين، وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه.
ولقد أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى، وأدخلها في المسجد، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب إلى عامله برد ما زاده في المسجد عليهم، لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن يعوضوا بما يرضيهم.
وأجلى الوليد بن يزيد من كان بقبرص من الذميين، وأرسلهم إلى الشام مخافة حملة الروم، ورغم أنه لم يفعل ذلك إلا حماية للدولة، واحتياطا لها في نظره، فقد غضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين واستعظموا ذلك منه، فلما جاء يزيد وردهم إلى قبرص، استحسنه المسلمون وعدوه من العدل وذكروه في مناقبه.
ومن مفاخر النظام الإسلامي ما منحه من سلطة واستقلال للقضاء، ففي رحاب القضاء الإسلامي الحق، يجد المظلوم والمغبون – أيا كان دينه وجنسه – الضمان والأمان، لينتصف من ظالمه، ويأخذ حقه من غاصبه، ولو كان هو أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه.
وفي تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة ووقائع كثيرة وقف فيها السلطان أو الخليفة أمام القاضي مدعيا أو مدعى عليه، وفي كثير منها كان الحكم على الخليفة أو السلطان لصالح فرد من أفراد الشعب – لا حول له ولا طول – وعلى رأس ذلك، ما ذكرناه من قصة درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – مع الذمي الذي أخذها أو سرقها.. إلخ. وهي واقعة تغني عن كل تعليق[29].
التطبيقات العملية للتسامح في التاريخ الإسلامي
التسامح في فتح مكة:
تحدثنا كتب التاريخ والسير عن الكثير من نماذج تسامح النبي – صلى الله عليه وسلم – التي ليس من أقلها روعة ما قابل به أهل مكة، أولئك النفر الذين عرف منهم الأذى له ولمن آمن به ما لم يعرفه أحد مثله.
لقد بهرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بسماحته، وتجاوزه لهم عن سوء عملهم قديمه وحديثه، وذلك حينما أمنهم جميعا وأطلق سراحهم مع قدرته على البطش بهم، ومعاملتهم المعاملة نفسها التي عاملوه وأصحابه بها؛ فعن أبي بن كعب: أنه أصيب يوم أحد من الأنصار أربعة وستون، وأصيب من المهاجرين ستة، فيهم حمزة بن عبد المطلب؛ فمثلوا – أي الكفار – بقتلاهم – أي بقتلى المسلمين – فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنريبن عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به( (النحل: ١٢٦)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفوا عن القوم»[30]. إنها سماحة النبي – صلى الله عليه وسلم – ورأفته ولين جانبه مع هؤلاء الذين عذبوه وأخرجوه من أحب البلاد إليه، فما كان منه صلى الله عليه وسلم – مع ذلك – إلا أن أطلق سراحهم! ويعضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، والطلقاء من قريش، والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»[31].
ولم تقتصر رحمته – صلى الله عليه وسلم – بهم عند هذا الحد، وإنما تجلت في مواقف أخرى، فهذا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ومعه ابنه جعفر وابن عمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – أيضا عبد الله بن أبي أمية يطلبون مقابلته، فيقول لهم بعدما سمح لهم بالمقابلة:«)قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (92)( (يوسف)» [32] [33].
التسامح عند عمر بن الخطاب:
“عندما طعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهو يتأهب لصلاة الفجر علم – وعلم الناس – أنه ميت لا محالة، فإن الطعنات كانت نافذة، مزقت الأمعاء، فإذا تناول شرابا خرج من البطن، ورأى أمير المؤمنين قبل أن يودع الحياة أن يوصي الخليفة بعدة أمور ذات بال، إنه لا يعرف من سيختار المسلمون، ولكنه يعرف ما يجب أن يفعله الرجل الذي يليه في حكم الأمة، فذكر طوائف من المسلمين لها منزلتها، ثم قال للخليفة المرتقب: “وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله – يعني ما يسمى في عصرنا بالأقليات الدينية – أن يوفي لهم بعهده، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقاتهم”[34].
فهذا هو عمر خليفة النبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – يوصي وهو يموت بمخالفيه في الدين ومعارضيه في المعتقد، فيصفهم أولا بأنهم ذمة الله وذمة رسوله، متناسيا الخلاف القائم في أصل الإيمان، ثم يطلب من الحاكم المقبل ثلاثة أمور:
- الوفاء بعهودهم.
- إقامة سياج يمنع كل عدوان عليهم، كما جاء في النص، يقاتل من ورائهم.
- لا يكلفون إلا بما يطيقون.
هل وعى تاريخ العالم إلى يومنا هذا أشرف من هذه المعاملة؟!
وما قاله عمر – رضي الله عنه – لم يكن مجرد مبادئ نظرية، أو مجرد كلمات تقال، فقد طبقت تطبيقا واقعيا، وسرت في أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملية، وحادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص – فاتح مصر وواليها – فسبقه فضربه ابن عمرو، فشكا أبوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقصه منه في موسم الحج، وعلى ملأ من الناس.
حادثة معروفة للجميع، فهذه الحادثة تدل على ذلك التيار التحرري الذي أطلقه الإسلام في ضمائر الناس وفي حياتهم[35].
التسامح عند علي بن أبي طالب:
وهذا نموذج آخر يضربه علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – يدل على التسامح مع غير المسلمين؛ فقد سرقت من علي بن أبي طالب درع، فوجدها عند يهودي؛ فقاضاه إلى قاضيه “شريح” وعلي يومئذ هو الخليفة، فحكم القاضي لليهودي بالدرع، لعدم وجود بينة لدى علي بن أبي طالب، فرضي أمير المؤمنين بالحكم، فما كان من اليهودي إلا أن اعترف بسرقة الدرع من أمير المؤمنين.
وفي التاريخ الإسلامي كذلك نماذج مشرفة مثل:
صلاح الدين ومعاملة الصليبيين:
فلقد امتاز صلاح الدين، إلى جانب بطولته وحكمته، بقدر كبير من الفضل والأريحية والتسامح، شهد له به خصومه الذين كانت تدور بينه وبينهم حروب قاسية، حتى إن بعضهم أصبحت تربطه به علاقات طيبة مثل: بوهمند – أمير إنطاكية -، كما أن خصمه ريتشارد الأول قد طمحت به أفكاره في وقت من الأوقات إلى تزويج أمته للملك العادل أخي صلاح الدين، وتصف دائرة المعارف الإسلامية الصادرة بالألمانية والإنجليزية، والفرنسية، صلاح الدين بأنه “لم يكن متعصبا ضد الرعايا المسيحيين الذين في دولته” وتقول عنه: “وهو يعد في أوربا مثالا للشهامة والمروءة، والحق أنه لم يكن قاسيا قط في غير ما شاء الله القسوة، بل كثيرا ما دعته شهامته إلى إطلاق سراح الأسرى وإهداء الهدايا”.
عهد محمد الفاتح لأهالي القسطنطينية:
يروى أن محمد الثاني الملقب بالفاتح، عندما أتم فتح القسطنطينية سنة 1453م، دخل المدينة ظهرا، فمنع أعمال السلب والنهب التي كانت قائمة، وسمح للنصارى بإقامة شعائرهم الدينية دون تدخل من قبل المسلمين، ثم منحهم حق اختيار بطريركهم.
وكان بعض أهالي القسطنطينية قد فروا من وجه القوات الإسلامية، إلا أنهم بعدما علموا بما ساد المدينة من عدل وأمان أخذوا يرجعون إلى بلادهم[36].
هذه هي صور التسامح في الإسلام كما نصت عليه النصوص الشرعية من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والتي أقرها وأثبتتها الوقائع التاريخية من عهد محمد – صلى الله عليه وسلم – إلى الآن، ولكن هل تستطيع الأقليات المسلمة المستضعفة أن يجدوا في المؤسسات الدولية القائمة ما يحمي لهم كرامتهم، ويصد عنهم حملات أعدائهم المغرضة التي تريد أن تجعل من دينهم وكرا للعنف والإرهاب ورفض الآخر[37]؟!
حتى اليهود الذين يتصرفون كثيرا تصرفات تثير مواطنيهم عليهم، وتوقد شعلة الكراهية لهم، وخاصة حين يدبرون المكايد خفية أو ينشرون الفساد جهرة، حتى هؤلاء اليهود عاشوا في المجتمع الإسلامي آمن ما يكونون على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم، وأموالهم التي لم يتورعوا عن استخدامها في الربا المحرم عند المسلمين.
ونكتفي هنا بذكر وثيقة تاريخية تبين لنا كيف عامل الحكم الإسلامي الأقليات ولو كانت يهودية.
وهذا هو نص الفرمان الذي نشره السلطان محمد بن عبد الله سلطان المغرب في 5 فبراير سنة 1864م:
“بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نأمر من يقف على كتابنا هذا، من سائر خدامنا وعمالنا والقائمين بوظائف أعمالنا، أن يعاملوا اليهود الذين بسائر ولاياتنا بما أوجبه الله تعالى، من نصب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في الأحكام، حتى لا يلحق أحدا منهم مثقال ذرة من الظلم ولا يضام، ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام، وألا يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم، وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن طيب أنفسهم، وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ونحن لا نوافق عليه، لا في حقهم ولا في حق غيرهم ولا نرضاه؛ لأن الناس كلهم عندنا في الحق سواء، ومن ظلم أحدا منهم أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله، وهذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبيناه كان مقررا ومعروفا محررا، لكن زدنا هذا المسطور تقريرا وتأكيدا ووعيدا في حق من يريد ظلمهم وتشديدا ليزيد اليهود أمنا إلى أمنهم، ومن يريد التعدي عليهم خوفا إلى خوفهم، صدر به أمرنا. المعتز بالله في السادس والعشرين من شعبان المبارك عام 1280 ثمانين ومائتين وألف”.
وكفى بهذه الوثيقة وحدها ردا على الأفاكين، الذين يثيرون العجاج، ويفتعلون الضجيج، بغير مسوغ ولا برهان.
وبعد هذا البيان يتضح لنا أن الدستور الإسلامي وعلاقة المسلمين مع غيرهم يؤكدان على سماحة الإسلام، وإنسانيته، وذلك بشهادة غير المسلمين أنفسهم، مما لا يبقي مجالا لاتهام الإسلام أنه يعامل غير المسلمين بالعنف والغلظة.
ثالثا. السبب في عدم بدء اليهود والنصارى بالسلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه»[38]. وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم، ففهمتها، فقلت: عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله”، فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت: وعليكم»[39]. وفي راوية جابر:«نجاب عليهم ولا يجابون فينا»[40]. وقد قال – صلى الله عليه وسلم – أيضا:«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»[41].
ففي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن يبتدءوا بالسلام، لكن إذا سلموا تقول: وعليكم، وإذا تحققت أنه قال: السلام عليكم، ولم يحصل منه تلبيس؛ فالصحيح أنك ترد عليه، وتقول: وعليكم السلام، وتقول بالواو أيضا على الصحيح، خلافا لابن عيينة وجماعة، والصواب إثبات الواو، وهو الثابت في الروايات الصحيحة.
وأما “فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه”، فليس المعنى هو إيذاؤهم، وليس المعنى اضطروهم إلى أضيقه أن يضطروا إلى حافات الطريق، وأن يضايقوا، هذا لا يجوز؛ لأن الإيذاء محرم، ولا يجوز الإيذاء لكل إنسان إلا إذا بدا منه ما يوجب نقض عهده، فإن هذا يعامل معاملة أمثاله، ليس مجرد مضايقة، بل أمره أعظم وأتم، ما دام لم يحصل منه شيء فلا يجوز إيذاؤه، بل مأمور بالبر والإحسان إليهم، ولهذا قال عز وجل: )لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8)( (الممتحنة).
إنما المعنى: ألا يترك لهم أفضل الطريق، فيعظمه ويرفعه، والمعنى أنه لا يكرمه بمعنى أنه يجعل له وسط الطريق، فيفضي إلى غروره ويفضي إلى تكبره، ويظن أن المسلم معجب بما هو عليه فيكون سببا في بقائه على دينه.
لكن إذا أحسنت إليه وأكرمته بأنواع الإكرام، وعملت المعروف إليه، ولم تجعل له الإظهار والعزة التي تفوت بها المصالح – والمقصود منها أن يرى أهل الإسلام، ويرى دينهم، فيكون سببا لإسلامه وإيمانه – فهذا هو المطلوب وليس المعنى هو مضايقته وإيذاؤه، فإن الإيذاء محرم ولا يجوز كما تقدم.
وليس المراد باضطرارهم إلى أضيق الطريق ما تبادر إلى الذهن من أن يزاحمهم إلى الجدار ويحشرهم دون مبرر سوى الكراهية! كلا بل المقصود ما يسمى بلغة العصر: “أفضلية المرور”.
وأما رد التحية لغير المسلم بـ “السلام عليكم” فممنوعة إذا تحقق أنه قال السام عليكم، أو شك فيما قال، كما أنه يجوز تحيتهم بتحيتهم المعهودة عندهم.
كما أنه لا مانع من مصافحة المسلم للذمي إذا رجع بعد الغيبة، وتشميته إذا عطس بقوله: “يهديك الله”، ويكون السلام بتحيتهم المعهودة مثل: صباح الخير، ومساء الخير، وسعيدة، ويقول: “السلام على من اتبع الهدى”، فقد كتب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى ملوك الكفار: «السلام على من اتبع الهدى»[42].
كما أنه يجوز تهنئة أهل الكتاب بزوجة، أو ولد، أو قدوم غائب، أو عافية، أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، على ألا تستعمل ألفاظ تدل على الرضا بدينهم، مثل: متعك الله بدينك، أو أعزك الله… وغيرها[43].
كما أنه يجوز عيادتهم، إذا علمت من ذلك المصلحة الشرعية، فقد قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود أحدا من المشركين، قال: إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه فليعده، كما عاد النبي – صلى الله عليه وسلم – الغلام اليهودي، فعرض عليه الإسلام.
وعلى ما سبق يتبين أن تشريع الإسلام للرد على اليهود والنصارى بصيغة “وعليكم” بدلا من “وعليكم السلام” ليس من قبيل العنف، إنما هو من قبيل رد الإساءة بالرفق، والاستعاضة عن استخدام العنف إلى استخدام الأدب النبوي الرفيع في تهذيب الطرف الآخر، وصده عن الإساءة، ورده إلى حسن الخلق، وأما عدم بدئهم بالسلام، وعدم تقديمهم في الطريق، وعدم تحيتهم في عيدهم لإشعارهم أن ما أنتم عليه ليس بدين صائب.
رابعا. التسامح الإسلامي شهادة من الواقع:
لو قمنا بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية، وبين أوضاع المسلمين في المجتمعات غير المسلمة لبدا لنا من الوهلة الأولى أن الإسلام مملوء بالسماحة، وأنه حق لغيره أن يوصم بالعنف والغلظة، وأن هذه الفرية على الإسلام هي أبعد ما تكون عنه في شريعته وتطبيقه، وعلى مر الأزمان.
ويحدثنا الشيخ أحمد دويدار – إمام المركز الإسلامي بوسط نيويورك والمدرس بجامعة منهاتن بأمريكا – عن التسامح الإسلامي دراسة مقارنة من الغرب قائلا: بالتأمل في الإسلام وأصوله العامة وبالنظر لكل ما يحويه من عقيدة وشريعة وأخلاق، تترجم في نهاية الأمر إلى غاية ضبط السلوك الإنساني على نحو ملزم تقتضيه وجوبية التعايش وفرضية الحياة على كوكب الأرض.
وهذا الإلزام يعلو ويهبط باطراد بليغ مع الحاجة إليه في ضوء مفاهيم الضرر والضرورة، وإذا كان هذا هو المنهج فلا بد له من موجد وهو الله – عز وجل – الذي أمر بالتوحيد؛ لذا لم تقم دعوة الإسلام على التوحيد فحسب بل قامت على الوحدة في كل أمر وفي كل شيء في الناحية الإلهية، والسياسية، والاجتماعية؛ لأنه بتقرير الوحدة في الإله الذي يستحق العبادة فلا بد من تقرير وحدة الدين والمنهج الذي ارتضاه للبشرية جمعاء، وعلى نحو يكمل بعضه بعضا طبقا لسنة التدرج في التعليم والتربية منذ آدم – عليه السلام – حتى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وغاية هذا المنهج واحدة وإن اختلفت وسائل الوصول.
عمومية التشريع
يقول الحق عز وجل: )شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه( (الشورى: 13)، إذن ما نريد الخلوص إليه بهذا العرض العام: أن الله الواحد هو مصدر الدين.
الوحدة الدينية للبشرية:
وهذا ما جاء في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، أن القرآن – خاصة المكي منه – قرر من الأصول العامة والتشريعات والأمور الكلية ما يخاطب به كل الناس؛ إذ لا يخالف فيها دين دينا ولذا من صالح العالم أن يتبعها في كل زمان ومكان.
نظرة الوحدة والمساواة بين كل الناس:
يقول الله عز وجل: )إن أكرمكم عند الله أتقاكم( (الحجرات: 13)، وقال – عز وجل – أيضا: )يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء( (النساء: 1)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أبائكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»[44]. إذن لا مفاضلة بالأجناس أو الأنساب، فلا يوجد تشريع للعربي وآخر للعجمي كما عند اليونان والرومان، بل لا فرق في هذا كله بين المسلم وغير المسلم المقيم بدار الإسلام.
ففي الهند مثلا نرى البراهيمية كعقيدة تفرق بين متبعيها؛ إذ تقسم الأمة إلى أربعة طوائف: البراهمة والكهنة في القمة، وما يسمونه بـ “السفلة والأنجاس” في الحضيض، بل يشتطون فيدعون أن الأرقى منهم خلق من أعلى الإله ورأسه، والأدنى من الكتف، ثم الأدنى، ثم الأكثر دنوا يكون من القدم، ولذا فالبراهمة يتملكون ما يسمونه السفلة، بل يحرم على هذه الطبقة عندهم الاتصال بالدين أو العلم.
ولننظر بعد ذلك في اليهود والنصارى الذين حجزوا من رحمة الله الواسعة حين زعموا أنهم وحدهم أبناء الله وأحباؤه وحين قالوا كما أخبر القرآن: )وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى( (البقرة: 111)، حرموا الربا بينهم وأحلوه مع الآخرين ذلك بأنهم قالوا: )ليس علينا في الأميين سبيل( (آل عمران: 75).
لذا يجب أن نتعرف على سماحة الإسلام بعد نكبة البشرية في انحرافها عن جادة الصواب، والدين الواحد الموصى به من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى – عليهم السلام – لإقامته وعدم التفرقة فيه.
والمقارنة بين التسامح كمبدإ إسلامي وبين المفاهيم الغربية المقابلة للتسامح تؤكد على شمولية التسامح الإسلامي ونضجه، واستيعابه لكل ما جاء في أفكار المفكرين والمصلحين والساسة في التاريخ الغربي.
والفضل في هذه الشمولية والنضج راجع إلى أن مصدر التشريع واحد، وهو الله عز وجل، وأن ما وصل للعالم وتواصى به الأنبياء من شرع ودين هو ذاته الإسلام في أكمل دين وأتم نعمة وأعظم رضا.
الإسلام لا يحتاج لإعادة صياغة الأفراد، التابعون هم المعنيون بالنصح، والأجدر مواجهة الخطأ بالتصويب وسوء الفهم بالتصحيح، ويجب أن تتوقف الحناجر الزاعقة بالعصبية المثيرة لنعرات التفوق والاستعلاء فلن يدخل المسلم الجنة لكون اسمه محمدا أو أحمد أو عليا، أو لأنه يتحدث العربية سينجح في سؤال القبر، أو لأنه من سكان الجزيرة العربية مهد الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – سيحظى بالشفاعة المحمدية، أما من دونه من سكان الأرض سيدخلون الجحيم. يقول الحق عز وجل: )وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب (199)( (آل عمران).
التسامح في الفكر الغربي
ورد مفهوم التسامح في الفكر الغربي بعد مروره بعدة مراحل تطورية، فقد بدأ غامضا لا يعرف إن كان من مصدر كنسي أو ذا طابع كهنوتي، أم هو أخلاقي أدبي، ولكنه لغويا يقترب من المفهوم الإسلامي، فهو المسامحة والتساهل والملاينة والموافقة على المطلوب، إن التسامح الغربي أظهر ما يكون في مجال السياسة وقبول الآخرين من الأحزاب المختلفة وعدم منعهم من أن يكونوا آخرين، أي: مختلفين.
بعكس المجال القانوني؛ فالمجتمع الأمريكي على سبيل المثال في جزء كبير من نسيجه الاجتماعي قائم على شكوى الناس بعضهم البعض وبصورة لا تخطر على البال، كأن تنزلق قدم أحد الضيوف في منزل مضيفه فيشكوه وتكون قضية تنظرها المحكمة ويشجع على هذا إغراءات النظام التأميني، ناهيك عن القضايا العادية أما هذه فحدث ولا حرج، ومن الواضح أن التوسع في النظم التأمينية بشكل متطرف أضر بمفهوم التسامح في نظام التقاضي؛ حيث تتفتح شهية صاحب الكلب مثلا لشكوى بعض المتاجر التي لا توفر نوعا معينا من الغذاء الحيواني لما قد يجنيه من تعويض تأميني ضخم.
ولقد أوجد هذا السلوك نوعا من التربص المتبادل والخوف الاجتماعي، ولا شك أن هذا يضر بمفهوم التسامح، وأين هذا من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين قال: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»[45].
وهناك تعريف غربي آخر للتسامح، وهو موقف السياسيين الحكوميين نحو الذين هم في مواقع أقل قوة – يعني تسامح الأكثرية السائدة مع الأقلية – ولكن في الواقع ما لم يكن لهذه الأقلية قيادة جذابة قادرة على التعبير وتأليب الجماهير فسيمضي الأقوياء المتحكمون في برامجهم الخادمة لمصالحهم.
وأين هذا من الحبيب محمد – صلى الله عليه وسلم – حين أقر في دستور المدينة “أن جميع أهل المدينة أمة واحدة” والذي استقر منه المبدأ “لهم ما لنا وعليهم ما علينا”.
وهناك نوع آخر من التسامح في تعاليم الفيلسوف جوته ويسميه “عدم التحيز impartiality”، وهو لا يقصر التسامح على تمرير الاختلاف أو غض النظر عما يختلف به أي شعب عن شعبك أنت، ولكن أن يرتقي التسامح لمستوى التقدير المناسب لخصائص هذا الشعب واحترام آخريتهم Alterity، ويكتسب هذا التسامح أهمية خاصة إذا كان للناس ذوي القناعات الدينية والسياسية والأيديولوجية المختلفة أن يعيشوا معا كما هو الحال في أوربا وأمريكا، حيث تنامى ظهور المجتمعات متعددة الثقافات والديانات إلى مدى يتزايد باطراد مما يجعل فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى الحدود.
ولكن يحلو لبعض الغربيين أن يروا التسامح عملة احتكروها، وأما المسلمون فبينهم وبين التسامح أمد بعيد – على حد زعمهم – فيقولون: انظروا كيف خول ملك فرنسا هنري الرابع بمرسوم رعاياه الكالفينيين الحق في الممارسة الحرة لدينهم، والرد على هذا في دراسة نقدية غربية أخرى أن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم تظهر أن الملك قد أخذ في حسبانه الموقف المتعصب لرعاياه من الأقلية الكاثوليك، ومدى ما يمكن أن يحدثه هذا من اضطرابات داخلية – يعني سلوكه التسامحي كان براجماتيا نفعيا مشروطا، أين هذا من مفهوم العفو مع المقدرة في الإسلام؟!
وأين هذا من: «كفوا عن القوم»[46] التي قالها رسول الرحمة في يوم عظيم في مشهد مهيب في وسط رجاله الفاتحين وعسكره، وقد أسقط في يد أعداء الأمس القريب وأغلق الصناديد أبواب البيوت عليهم؟ نعم لقد ضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعظم مثال للتسامح في هذا اليوم.
وهذا ما يحدو بنا إلى تقرير: أن التسامح لا يعد فضيلة إلا مع المقدرة على البطش، كما في النموذج الإسلامي.
وكما اعترف المفكر المعروف إيرفنج فيشر بأن الشعوب النصرانية يجب أن تخجل من تاريخها حين فتح الغرب المسيحي شبه الجزيرة الأيبيرية، وما فعلوه من التعميد الإجباري للمسلمين واليهود وإحراق الهراطقة من “رجال الدين”، وأخيرا محاكم التفتيش الدينية التي وصمت تاريخ التسامح الديني الغربي بالعار، وأين هذا من نص القرآن على التسامح مع مختلف الأديان: )إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (62)( (البقرة)؟!
وعندما كان الأمويون يحكمون الأندلس تسامحوا مع الجماعات اليهودية والمسيحية، وشهد عصرهم باعتراف كتاب الغرب أنفسهم ازدهارا عظيما للثقافات الثلاث، فكان الإنتاج الديني والأدبي، والثقافي للمسلمين والمسيحيين واليهود عظيما في تلك الفترة، وهذا ثابت تاريخيا في موسوعة تاريخ الأندلس بمكتبة نيويورك.
ولا يخفى على الجميع أن النص القرآني الواضح في الآية السابقة لا يدع مجالا للشك أن التسامح من صلب العقيدة الإسلامية، فنحن لا نطرح رأيا سياسياأو فكريا أواجتماعيا، بل هو نص مقدس؛ فالتسامح إسلامي منشأه ديني.
ويجب أن يسلم الجميع أن نشوء التسامح في الفكر الغربي في أول الأمر، كان مرده الحكمة السياسية والخوف من الاضطرابات، وليس الباعث الديني، وهذا ما حدا بفردريك أن يقول: “والتسامح عندي هو قاعدة الحكمة السياسية وإيماني به؛ لأن كل الأديان جيدة بالتساوي ولو أراد الأتراك والوثنيون القدوم إلينا لبنينا لهم المساجد والمعابد، فكل امرئ في مملكتي حر”. ويشهد التاريخ أن فريدريك لم يقصر سياسة التسامح على المسيحيين، ولكنه شمل غيرهم على أن بييربابل هو الذي أوصلها إلى حد الرغبة في إعطاء الحقوق المدنية حتى للملحدين ولكن لا نعرف إذا كانت هذه الرغبة وضعت محل التنفيذ أم لا.
ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حين قالها مدوية أبد الدهر: “يا عمرو متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا”؟! قالها لعمرو بن العاص والي مصر حين ضرب ابنه رجلا مصريا مستضعفا، فأحضر الخليفة المعتدي واقتص منه للمصري.
ومن العجيب أن التسامح مع الملحدين في أوربا المتحررة كان يقابل بعاصفة من النقد والثورة العصبية في حين نجد القرآن الكريم يتوسع بدائرة التسامح إلى أعظم مدى حين يقرر إجارة المشرك وحمايته، مع التسليم بحقه في قبول أو رفض ما تدعوه إليه مع إبلاغه مأمنه، وذلك في قوله عز وجل: )وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه( (التوبة: 6).
ومن الجدير بالذكر أن عدم التسامح كان مرتبطا في كثير من الأحيان بما لدى أصحاب العقائد المختلفة من طموحات سياسية، ويضرب المثل بتعايش الطاوية والبوذية والكونفوشية في الشرق الأقصى، وتفسير ذلك بأنه ليست في ديانة أي منهم خطورة سياسية، وإذا كانت الفيدرالية نظام يجعل من الممكن للأقليات أن تعيش في حرية وتسامح مع الأكثرية، فإنه لا بديل في الإسلام عن ضرورة التعايش مع المختلف من الأقليات؛ احتراما لحتمية الخلاف في الخلق، كما جاء بذلك القرآن في قوله عز وجل: )ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (48)( (المائدة).
لذا فالتسامح في التصور الإسلامي يوفر حل معضلة الأقليات السياسية من الناحية الديمقراطية؛ لأنه إذا كان القانون وقواعد النظام العام هما أساسا احترام الأقلية والتزامها تجاه الأغلبية؛ فإن التسامح هو معيار التزام الأكثرية تجاه الأقلية، وهذا يوضح الفلسفة الإسلامية في التسامح بأن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة القوى أو الأكثرية على كبح الجماح مع الأضعف المختلف.
وأخيرا نعرض ما يهذب مفهوم التسامح، ويبعد به عن الخنوع والتساهل المفضي إلى الفوضى والاضطراب، فهذا أبو بكر – رضي الله عنه – الخليفة الأول يبرز كأشجع ما تكون الرجال لوأد فتنة الردة في مهدها، وقبل أن تنفلت الأمور من عقالها، مخالفا بذلك ما عرف عنه من الحلم ولين الجانب، ومخالفا أيضا مشورة من عرف عنه الغضب للحق وحسم الأمور وحمية الفرسان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – الذي رأى المهادنة، وعلى هذا فحسم الأمر لدرء الفتن لا يقدح في التسامح، التسامح لا يعني الجبن والنكوص عن الدفاع عن النفس، وأصل ذلك في القاعدة الشرعية لدفع الغائل، وفي القرآن يقول عز وجل: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم( (البقرة: 194)، فالتسامح لا يعني التساهل في حدود الله: )ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب( (البقرة: 179).
وعليه فلا بد لأهل الدعوة إلى الله من العلم الصحيح المجرد وقراءة التاريخ المتقدم للأمم السابقة للوقوف على خلفية الآخر واتخاذ العبرة والعظة من الدروس السابقة.
وبعدما تحدثنا عن سماحة الإسلام تجاه الآخر أيام غلبة المسلمين وعزتهم وتعصب الآخرين وغطرستهم حينما تغلبوا على المسلمين وأوضحنا ذلك بالأدلة التاريخية وأقوال القادة والعلماء ورجال الدين، نؤكد هنا على هذا البون الشاسع بين تسامح المسلمين وتعصب غيرهم معهم وذلك من خلال إيراد بعض نماذج من عدم التسامح في خطابات بعض رجال الدين والإدارة الأمريكيين تجاه الإسلام والمسلمين:
اعتذر القس الأمريكي المتطرف جيري فالويل عن تطاوله الشرس وتهجمه على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه لم يقصد عدم احترام أي مسلم صادق ملتزم بقانون، وقال: إن خطأه جاء من الإجابة على سؤال مثير للجدل ومغرض في نهاية المقابلة، وقد صرح القس في إحدى المقابلات التليفزيونية: باعتقاده أن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – كان إرهابيا. وقد أثارت تصريحاته غضب المسلمين في كل أنحاء العالم.
اعتبر مسئول أمريكي كبير في وزارة الدفاع الأمريكية الحرب على الإرهاب بأنها معركة روحية يشنها المسيحيون على الشيطان، وذكر المسئول نفسه – الجنرال وليام بوكين نائب وكيل وزارة الدفاع لشئون المخابرات – أن المسلمين يعبدون وثنا، وأن الإسلاميين المناهضين لنا يسعون لتدمير أمريكا؛ لأننا شعب مسيحي وسنهزمهم، وقد انبرى لهذه الافتراءات العديد من رجال الدين الإسلامي، وقادة المنظمات الإسلامية وأثبتوا أن الإسلام لا يناهض المسيحية، بل المناهضة ضد الظلم والمعايير المزدوجة التي تمارس من بعض الحكام ومن ناصرهم من الإعلام المتعصب.
ومن الملاحظ استعمال الدين في خطاب هذا الجنرال الذي شارك في مهمة للقوات الخاصة لإنقاذ الرهائن الأمريكيين في إيران عام 1980م، والتي فشلت فشلا ذريعا، كما تولى الحملة الأمريكية في الصومال عام 1993م، والتي انتهت بمقتل 18 جنديا أمريكيا، وقد أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قوله في يونيو 2002م، أمام تجمع كنسي في ولاية “أوكلاهوما” وهو يعرض صورة التقطها في الصومال عليها علامة سوداء، قال: أيها السادة هذا عدوكم إنه أمير الظلام إنه حضور شيطاني في تلك المدينة أظهره الله على أنه العدو!
وفي خطاب آخر تحدث بوكين عن ضابط في قوات الزعيم الصومالي محمد فرح عيديد، ظهر في تلفزيون “سي إن إن” قائلا: إن الله سيحميه بعد فشل غارة أمريكية استهدفته، قال بوكين معلقا عليه: كنت أعلم أن إلهي أكبر من إلهه؛ لأن إلهي حقيقي، أما إلهه فمجرد وثن. وقال في الصحيفة نفسها: إن الله اختار جورج بوش ليكون رئيسا للولايات المتحدة. ومما أشهد به أيضا في هذا السياق أن نفس المصادر التي تذيع هذا الافتراء والتعصب قد أذاعت ما أعرب به برلمانيون وجمعيات مختلفة عن دهشتهم واستنكارهم لتصريحات بوكين، وطالب عضو ديمقراطي في مجلس النواب – هو النائب جون كونييرز من ولاية ميتشجان – وزير الدفاع رامسفيلد باتخاذ إجراء تأديبي ضد بوكين، وبعث برسالة مسموعة ومرئية، قال فيها لوزير الدفاع: إنني أحثك على نقله أو توبيخه؛ إذ لا يمكننا أن يكون لدينا متطرف كهذا يتحدث بالنيابة عن أمتنا وعن قواتنا المسلحة.
مظهر آخر تعصبي جاهل قام به القس فايزر التابع للكنيسة المعمدانية الجنوبية، قال فيها: إن الديانة المسيحية أسسها ابن الله المولود من العذراء مريم، وقد دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الرئيس جورج بوش وزعماء الطائفتين المسيحية واليهودية إلى إدانة هذه التصريحات المعادية[47].
والكثير في هذا السياق يستطاع ذكره ولكن نكتفي بهذا مع الإشارة إلى أن بعضهم قد عاد واعتذر عندما وجه بالفكر الحسن والحكمة، وإذا ذكرنا الذين أساءوا فمن الإنصاف ذكر من أحسن وضرب المثل الطيب في النزاهة والموضوعية ومن هؤلاء الأستاذ لامبير الفرنسي، الذي يرى مؤلفات الشريعة الإسلامية كنزا لا غنى عنه، وأن خير ما يلجأ إليه المصريون في العصر الحاضر هو علومهم، خاصة الشرعية منها؛ ليعيدوا – هم وإخوانهم من العرب والمسلمين – مجدهم العلمي، وظل يؤكد على أن الشريعة الإسلامية قد أمدت المدنية المسيحية الحاضرة بقسط وافر من الأصول العامة.
ويقول فارس الخوري – من أعلام الشرق وأحد أعلام سوريا المسيحيين – في حفل أقيم في دمشق لإحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم: إن محمدا أعظم عظماء العالم، جاءنا بأوفي الأديان، وأودع الشريعة المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا إليه الناس بأمر الله، متفقا مع العلم، مطابقا لأرقى النظم في الحياة.
ويقول سانتيلانا: إن في الفقه الإسلامي ما يكفي المسلمين في تشريعهم المدني، إن لم نقل إن فيه ما يكفي الإنسانية كلها.
ويقول الأستاذ سليم باز المسيحي: لا يوجد معنى من معأني الأحكام المنشود فيها العدل، أو حاجات البشر مما حوته خزائن الكتب الأوربية من ليدن في هولندا إلى روما، وبرلين وباريس والمتحف البريطاني، بل المكتبة البابوبية في قصر الفاتيكان إلا تقدم لفقيه مسلم قول فيه.
وهذا جوزيف كوهلر – عالم قانوني ألماني اطلع على رسالة المرحوم د. محمود فتحي التي بعنوان “مذهب التعسف في استعمال الحق عند فقهاء الإسلام” – يقول: إن الألمان كانوا يتيهون عجبا على غيرهم في ابتكار نظرية التعسف، والتشريع لها في القانون المدني الألماني، أما وقد ظهر هذا في فقه الإسلام؛ فإنه يجدر بنا أن نتعلم هذا المبدأ من أهله، وهم حملة الشريعة الإسلامية.
ويقول الأستاذ العميد شيرل: “إن البشرية تفخر بانتساب رجل كمحمد إليها؛ فرغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا الإتيان بتشريع، سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة.
ويقول باستور دير – أسقف كنيسة “بابتيس بمانهاتن نيويورك” والتي تعتبر من أرقى الكنائس وأضخمها وأغلاها في أمريكا – بالحرف الواحد في الاجتماع السنوي لمجلس الأديان بنيويورك: دعوني أعتذر لكم أيها السادة عما صدر من دعاة المسيحية على مر العصور من تعصب ضد الآخرين، وصل إلى حد القتل والحرق والتشريد باسم المسيح، والذي هو منهم براء. قال ذلك والدموع تنسال من عينيه، واستشعرنا جميعا الصدق في قلبه ولسانه، وقد دعا لتدريس الإسلام في كنيسته، واستمر هذا التدريس خمسة فصول متتالية، انتهت هذه الفصول بدخول عدد غير قليل من الحضور إلى الإسلام[48].
الخلاصة:
إن الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلها، ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعا، في جو من الإخاء والتسامح، ولعل مبادئ الإسلام خير شاهد على ذلك.
دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم يؤكدان على سماحة الإسلام وإنسانيته، ويتأكد ذلك من شهادات غير المسلمين على سماحة الإسلام، فأساس هذه العلاقة البر والقسط؛ فالقرآن الكريم ينهى عن جدالهم إلا بالتي هي أحسن، ويبيح مؤاكلتهم ومشاربتهم والأكل من ذبائحهم، ومصاهرتهم إلى غير ذلك. وكذلك اكتظت السنة النبوية بإرشادات النبي – صلى الله عليه وسلم – وتعاليمه لأمته بأمرهم بالتحلي بالتسامح في معاملاتهم سواء أكانت مع المسلمين أم غيرهم. هناك تطبيقات عملية للتسامح في التاريخ الإسلامي:
منها مثلا فتح مكة وتسامح النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أهلها، ومنها عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يحتضر ويوصي بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهي ما نسميها في عصرنا بـ “الأقليات غير المسلمة”، ومنها عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين ويقاضي اليهودي الذي سرق درعه، ومنها عند صلاح الدين الأيوبي ومعاملته السمحة للصليبيين، ومنها عند محمد الفاتح مع أهالي القسطنطينية.
فهي ليست مرة سجلها لنا التاريخ، بل التاريخ بكل عصوره شاهد للإسلام أنه ممتلئ بالتسامح وأن قوته مهما عظمت لم تدعه يوما للظلم والطغيان وممارسة العنف وسفك الدماء، وبقر البطون واغتصاب النساء، كما هو حاصل في معاملة غير المسلمين للمسلمين.
لقد شهد النصارى أنفسهم على سماحة الإسلام، وفي كتبهم حديث عن سماحة عمرو بن العاص، وسموا فتح مصر “تحرير الإسلام لشعوب الشرق”، كما شهدوا للفتوحات الإسلامية أنها كانت إنقاذا لشعوب البلدان المفتوحة، ودينهم من القهر الروماني.
رد التحية لغير المسلم بـ “عليكم السلام” ممنوعة في حالة التحقق من قوله “السام عليكم” بمعنى “الموت عليكم” أو الشك في ذلك، أما إذا قال الذمي يقينا “السلام عليكم”، فإن عدل الإسلام وسماحته وإحسانه لا يمنع من الرد عليه بمثل تحيته وأحسن منها.
المقارنة اليسيرة بين أوضاع المسلمين في المجتمعات غير المسلمة، وأوضاع غير المسلمين في المجتمعات المسلمة تثبت سماحة الإسلام وعدله وطغيان الآخرين؛ فالمسلم في دول الغرب بشهادة شهود العيان معرض لكل أنواع القهر، والتمييز، والعنصرية. أين هذا من سماحة الإسلام ورحمته وحسن معاملته لغير المسلمين في كل مكان، وفي كل عصور الإسلام؟!
——-
[1]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (5789).
[2]. الإسلام وقضايا الحوار، د. محمود حمدي زقزوق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2007م، ص277، 278.
[3]. السماحة الإسلامية: النظرية والتطبيق، د. محمد عمارة، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص113 وما بعدها.
[4]. الملجأ: المكره.
[5]. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، د. ت، ص430.
[6]. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجزية، باب كم الجزية (18456)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1256).
[7]. مبادئ التسامح في الإسلام ونماذجه التاريخية، د. شكور الله باشا زاده، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص220 وما بعدها.
[8]. الكراع: اسم لجميع الخيل وعدة الحرب.
[9]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3054)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم (18511)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (445).
[10]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (2887)، وفي مواضع أخرى.
[11]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم (6516)، وفي موضع آخر.
[12]. الخراج: ما يخرج من غلة الأرض، والجزية التي ضربت على أهل الذمة.
[13]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (6824)، وفي موضع آخر.
[14]. العرض: المتاع.
[15]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص91.
[16]. أرجع إليك كما خرجت من عندك: يعني أن الناس لا يدفعون إلا بالشدة.
[17]. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، جماع أبواب غزوة تبوك، باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا ـ صلى الله عليه وسلم (2126)، وذكره محمد بن يوسف الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، جماع أبواب بعض الوفود إليه صلى الله عليه وسلم ، باب في وفود علماء نجران إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ وشهادتهم له (91).
[18]. الخفارة: الحماية.
[19]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجز والتفليس، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه (2278)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية (4828).
[20]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص93.
[21]. المقلاة: قليلة النسل.
[22]. لا ندع أبناءنا: يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية.
[23]. تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري،دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ، ج2، ص449.
[24]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص98.
[25]. أورده القاسم بن سلام في الأموال، كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها، باب كتب العهود التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم (432)، وابن زنجويه في الأموال، كتاب العهود التي كتبها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه (567).
[26]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص99.
[27]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3054)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئا بغير أمرهم (18511)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (445).
[28]. أورده القاسم بن سلام الهروي في الأموال، كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها، باب أهل الصلح والعهد ينكثون (410)، وابن زنجويه في الأموال، كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها، باب أهل الصلح والعهد ينكثون (538).
[29]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص84: 105.
[30]. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب (21268)، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة النحل (3129)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن (21268).
[31]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث جرير بن عبد الله (19235)، والبزار في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود (1726)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1036).
[32]. حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، باب سورة الإسراء (11298)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب فتح مكة حرسها الله تعالى (18054)، وحسنه الألباني في فقه السيرة (1/ 376).
[33]. التسامح في الحضارة الإسلامية، أحمد ولد محمد الأمين النينى، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص191، 192.
[34]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص109.
[35]. سماحة الإسلام، د. عمر قريشي، مكتبة الأديب، السعودية، ط1، 2003م، ص110، 111 بتصرف.
[36]. التسامح في الحضارة الإسلامية، أحمد ولد محمد الأمين النينى، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص194، 195.
[37]. التسامح في الحضارة الإسلامية، أحمد ولد محمد الأمين النينى، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص195 بتصرف.
[38]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (5789).
[39]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (5901)، وفي موضع آخر، ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (5784)، واللفظ للبخاري.
[40]. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كتاب أهل الذمة، باب إذا قال أهل الكتاب: السام عليكم (1110)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (460).
[41]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق (6867).
[42]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب (5905)، وفي مواضع أخرى.
[43]. قضايا الفقه والفكر المعاصر، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1427هـ/ 2006م، ص41: 43 بتصرف.
[44]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (23536)، والهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب الأدب، باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى (13079) بنحوه، وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (23536).
[45]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف (1970).
[46]. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث أبي العالية الرياحي عن أبي كعب (21268)، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب سورة النحل (3129)، وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن (21268).
[47]. التسامح في الإسلام: دراسة مقارنة من الغرب، أحمد دويدار، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص659: 679.
[48]. التسامح في الإسلام: دراسة مقارنة من الغرب، أحمد دويدار، مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2004م، ص680، 681.
——
المصدر: مجلة “اللواء الإسلامي”.
[ica_orginalurl]