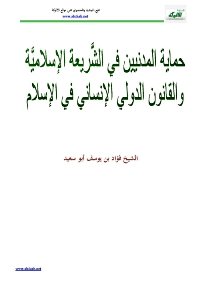محمد يتيم (*)
أزمة كورونا (كوفيد-19) -التي اجتاحت العالم واخترقت الحدود والفئات والطبقات- من الوقائع التي ستسجل إلى جانب وقائع أخرى عرفها القرن العشرون من قبيل الحربين العالميتين، وكذا الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، وانهيار المعسكر الشرقي، وسقوط جدار برلين، وظهور ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الأحادي القطب، وما ترتب على ذلك من حروب قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق.

أفرزت أزمة كورونا تحولا في المنظومة القيمية
ستكون أزمة كورونا موضوع بحوث ودراسات وندوات وتحاليل علمية لمراكز البحوث ولقادة الفكر الإستراتيجي، من الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والجيوسياسية، من أجل بيان التحولات المحتملة على النظام العالمي وعلاقات القوة وتوازناتها وانتقالات مركزها، ومنذ الآن بدأت تتناسل القراءات والتحاليل في المستويات المشار إليها.
لكننا في هذا المقال اخترنا أن نثير باختصار بعض الملاحظات حول التحولات الطارئة أو المحتملة لهذه الأزمة على مستوى منظومة القيم بأبعادها المختلفة، وهذه بعضها:
أولاً: العودة القوية للمعتقد الديني:
من الطبيعي أن يتعمق الشعور الديني باعتباره شعوراً يقوم على الإيمان بوجود قوة إلهية خارقة، يلجأ إليها الإنسان حين يرجع إلى حقيقته ككائن ضعيف، مهما أحس بالتميز والمركزية في الكون، ومع كورونا ينبعث هذا الشعور حتى عند الغافلين أو المنكرين أو المستهترين بالدين، ويتجدد عند المتدينين.
ففي الأزمات -التي تتجاوز قدرة الإنسان وتتحداه- يحس الناس بالحاجة إلى القوة الإلهية المحيطة بكل شيء، ولا يزيد التقدمُ العلمي الإنساني هذه الحقيقةَ إلا تأكيداً، ذلك أن طريقة انتشار كورونا واستخدامه للإنسان، والانتقال عبره متخذاً جسمَ الإنسان حاضناً وناقلاً؛ يجعله أشد على شعور البشر من الكوارث الطبيعية.
إن الأمر هنا مرتبط بعدوّ مستتر أشد فتكاً في هذه الحالة من الكوارث الطبيعية التي طور العلم وسائل تقنية لرصدها وتوقعها، في حين ما زال العلماء -في مختبراتهم العلمية- يبحثون عن أدوية ولقاحات مضادة للفيروس القاتل “كوفيد-19”.
غير أن هذه العودة تحمل في طياتها بعض الانزلاقات والمخاطر، في ظل غياب وعي ديني مستنير بحقيقة الدين والعلم في نفس الوقت؛ فالشعور الديني غير المؤطَّر بفهم روح الدين ومقاصده قد يكون كارثة، وهو ما يفسر حالات جماعية من الوجد “الديني” الجماعي التي تتنافى مع أحكام الدين نفسه، ليس فقط فيما يتعلق بكل ما له صلة بحفظ النفس، بل أيضاً في الأحكام الناظمة لشعائره التعبدية، من قبيل الدعاء الذي من سننه التضرع خيفة ودون الجهر من القول ومناجاة الله وعدم مناداته بصوت مرتفع، لأننا -كما ورد في الحديث النبوي- لا ننادي أصم أبكم، وإنما ندعو من هو أقرب إلينا من حبل الوريد.
ومن قبيل ذلك إصرارُ بعض المسلمين على عدم ترك صلاة الجماعة والجمعة، وهو أمر من جوهر الدين إذا خيف على النفس من حصول الضرر، حيث إن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين في هذه الحالة.
وكذلك تألِّي بعضهم على الله وادّعاؤهم أن هذا الوباء انتشر بسبب المعاصي، وأنه “عقاب” من الله ضد السلطات الصينية بسبب اضطهادها لأقلية مسلمي الأويجور في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانج).
والواقع أن الفيروس قد أصاب دولاً إسلامية كماليزيا، بل إن بعضاً من الجيل الأول من المسلمين ممن كانوا على عهد قريب من النبوة ماتوا بسبب الطاعون، كما أن الهدي النبوي كان سبّاقاً لإقرار قواعد الحجر الصحي، ونفّذه عمر بن الخطاب حين ابتُلي المسلمون بطاعون عمواس.
ثانياً: أزمة كورونا والسؤال القيمي الأخلاقي:
يكشف انتشار فيروس كورونا عن الهاوية التي تقف على سفحها البشرية، كما يقول سيد قطب في مقدمة كتابه “معالم في الطريق”، حيث ورد فيها: “تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية، لا بسبب الفناء المعلق على رأسها.. فهذا عارض من أعراض المرض؛ ولكن بسبب إفلاسها في عالم القيم”.
وهو ما تجلى في مواقف عدد من المسؤولين الغربيين، ومنهم مثلاً الرئيس دونالد ترمب وعدد من الجمهوريين، الذين أكدوا إعطاء الأولوية للشباب في مقاومة كورونا، وللاقتصاد والحفاظ على فرص الشغل على حساب المسنين؛ حيث أطلقوا شعار “العلاج أسوأ من المرض”، وهو ما يفسر تأخر الولايات المتحدة في فرض إجراءات الحجر الصحي لأن الكارتيلات الصناعية والمالية والاقتصادية لا تتحمل طويلاً مثل هذه الإجراءات.
ثالثاً: إفلاس النظام الرأسمالي وعجز النموذج الديمقراطي الاجتماعي عن التصدي للأزمة:
نجحت الصين -على ما يبدو- في مواجهة واحتواء جائحة كورونا، في حين عجزت عن ذلك الرأسمالية في صيغتها الأكثر تطرفاً ممثلة بالولايات المتحدة، والأنظمة الديمقراطية الاجتماعية المبنية على الحرية الفردية، التي يتمرد فيها الفرد -بسبب تكوينه الثقافي- على التحكم السلطوي؛ مما أدى إلى نوع من التهاون في التعامل مع الجائحة؛ فكانت الكارثة، ولم تستعد السلطة المركزية دورها إلا بعد خراب البصرة، كما يقال.
كما تُطرح هنا بشدة إشكالية انهيار منظومات الحماية الصحية والاجتماعية، ونموذج دولة الرفاه الاجتماعي في دول كان يُضرب بها المثل في ذلك؛ حتى إننا لم نعد نميز بين هشاشة تلك المنظومة في هذه الدول ونظائرها في بعض دول الجنوب.
وقد اكتشفت دول غربية -متأخرةً وبعد أن نخرها فيروس كورونا- أهمية التضامن العالمي، فجاء اجتماع قمة دول العشرين الافتراضي وتعهدت فيه بضخ 5 تريليونات دولار، دون أن تصدر قرارات عملية للتعاون أو التضامن مع الدول والشعوب الأكثر فقراً.
رابعاً: انهزام قيم الفردانية وانبعاث قيم التضامن الاجتماعي والإنساني:
لقد قامت فلسفة النهضة على إعادة الاعتبار للإنسان في بعده الفردي، وعلى تمجيد العقلانية المجردة التي ترى الإنسانَ الفردَ مقياساً لكل شيء، أما الجماعة والدولة فليستا إلا فضاء لممارسة الفرد لحريته المطلقة ما لم تمس بالآخرين.
غير أن أزمة كورونا أحيت -حتى في المجتمعات المتخمة بفردانية الحداثة- قيم التضامن والتضحية ونكران الذات لدى بعض الفئات المجتمعية، من قبيل الأطباء والممرضين وغيرهم، وربما يكون ذلك بداية لعودة الشعور بالحاجة إلى الانتماء الاجتماعي والتضامن الإنساني العالمي.
فبالقدر الذي كشفت به هذه الجائحة عن إفلاس عدد من الدول التي تقدم نفسها على أنها مهد لقيم الحرية والديمقراطية، بل وعن إفلاس منظوماتها الصحية والاجتماعية التضامنية؛ فإنها كشفت عن وجه آخر من الصورة، وما صور التضامن مع الشعب الإيطالي وإيفاد عدد من الأطباء والمعدات إلا وجه من هذه الصورة المضيئة، هذا فضلاً عن صور الكفاح والمرابطة التي أظهرتها الأطقم الطبية وغيرها، إلى درجة تعريض أفرادها أنفسَهم لمخاطرة من درجة عالية.
خامساً: تجسير العلاقة بين المجتمع والدولة وعودة الحياة إلى مؤسسات الوساطة:
ينبغي الاعتراف بأنه من السابق لأوانه الجزم النهائي بهذه الخلاصة، غير أن مؤشرات التعامل الشعبي والمجتمعي مع مؤسسات الدولة -بمختلف مستوياتها- تشير على إمكانات واعدة بهذا الخصوص، وهي مرهونة بتعزيز حالة التعبئة الوطنية هذه.
ومن المؤشرات المواقف التي عبرت عنها مكونات سياسية واجتماعية في عدد من الدول بإصدارها خطابات إيجابية، وهي مكونات كانت تصنَّف تقليدياً في خانة الرفض، وكان البعض يتوقع أن تنتهز فرصة هذه الجائحة لكي توجه سهام نقدها للدولة والمؤسسات وتشمت في الجميع، وهناك أمل في أن يكون عهد ما بعد جائحة كورونا مختلفاً عن عهد ما قبلها، وأن نقول ونحن نتحدث بلغة الذكرى المفزعة: رُبَّ ضارة نافعة.
إن هذه الجائحة مناسبة لاستدعاء كل تقاليد ومخزون القيم الدينية والاجتماعية في مجال التضامن الاجتماعي، وخاصة التضامن الأسري والعائلي والقبلي، فضلاً عن تحفيز المواطنين لإخراج الزكاة، ولِمَ لا يتم تفعيل الأشكال الرسمية لجمع وتنظيم توزيع هذه الزكاة، هذا فضلاً عن تثمين مبادرات المجتمع الأهلي والسياسي في مجالات التضامن دون هواجس أو حساسيات، وأن يتم كل ذلك في نطاق القانون وبتنسيق وإشراف من السلطات المعنية.
——–
(*) مفكر وقيادي إسلامي مغربي. والمقال منقول بتصرف يسير من “الجزيرة نت“.
[opic_orginalurl]